-
Vijay Prashad- Huit contradictions de l’« ordre fondé sur des règles » impérialiste


Boris Mikhaïlov (RSS d’Ukraine), Rouge , 1968-1975.
Huit contradictions de l’« ordre fondé sur des règles » impérialiste par Vidjay Prashad
Chers amis,
Salutations du bureau de Tricontinental : Institut de recherche sociale .
Le Bulletin of the Atomic Scientists vient d’avancer l’horloge du Jugement dernier à 90 secondes de minuit, soit le plus court intervalle de temps avant l’heure symbolique de l’anéantissement de l’humanité et de la Terre depuis 1947. Cette situation est alarmante et c’est la raison pour laquelle les dirigeants des pays du Sud ont plaidé en faveur de l’arrêt du conflit en Ukraine et des menés bellicistes contre la Chine. Comme l’a déclaré la Première ministre namibienne Saara Kuugongelwa-Amadhila, « nous encourageons une résolution pacifique de ce conflit afin que tous les pays du monde et toutes ses ressources puissent être employés à l’amélioration des conditions de vie des populations au lieu d’être dépensés pour acquérir des armes, tuer des gens et créer des affrontements ».
Conformément à l’alarme de l’Horloge du Jugement dernier et aux affirmations de personnes telles que Kuugongelwa-Amadhila, le reste de cette lettre d’information présente un nouveau texte intitulé
Huit contradictions dans l’ordre impérialiste fondé sur les règles. Ce texte a été rédigé par Kyeretwie Opoku (président du Mouvement socialiste du Ghana), Manuel Bertoldi (Patria Grande /Federación Rural para la producción y el arraigo), Deby Veneziale (chargé de recherche, Tricontinental : Institut de recherche sociale) et moi-même, avec la contribution de hauts responsables politiques et d’intellectuels du monde entier. Nous proposons ce texte comme une invitation au dialogue. Nous espérons que vous le lirez, le ferez circuler et en discuterez.Nous entrons actuellement dans une phase qualitativement nouvelle de l’histoire mondiale. Des changements mondiaux significatifs sont apparus au cours des années qui ont suivi la grande crise financière de 2008. Cela se traduit aujourd’hui par une nouvelle phase de l’impérialisme contemporain et une évolution des huit contradictions politiques majeures qui caractérisent cet impérialisme.
1) La contradiction entre un impérialisme moribond et l’émergence d’un socialisme efficace dirigé par la Chine.
Cette contradiction s’est intensifiée en raison de l’émergence pacifique du socialisme aux caractéristiques chinoises. Pour la première fois depuis 500 ans, les puissances impérialistes atlantiques sont confrontées à une grande puissance économique non blanche capable de les concurrencer. Cette situation est apparue clairement en 2013 lorsque le PIB de la Chine en parité de pouvoir d’achat (PPA) a dépassé celui des États-Unis. La Chine est parvenue à ce niveau de développement dans un laps de temps beaucoup plus court que l’Occident, avec une population nettement plus importante et sans colonies, ni asservissement, ni conquête militaire. Alors que la Chine prône des relations pacifiques, les États-Unis sont devenus de plus en plus belliqueux.
Les États-Unis dirigent le camp impérialiste depuis la Seconde Guerre mondiale. Après qu’Angela Merkel a achevé son mandat de chancelière et avec l’avènement de l’opération militaire en Ukraine, ils ont stratégiquement subordonné des sections dominantes de la bourgeoisie européenne et japonaise. Cela a eu pour effet d’affaiblir les contradictions intra-impérialistes. Les États-Unis ont d’abord autorisé, puis exigé que le Japon (troisième économie mondiale) et l’Allemagne (quatrième économie mondiale) — deux puissances fascistes pendant la Seconde Guerre mondiale — augmentent considérablement leurs dépenses militaires. Ce tournant s’est aussi traduit par la fin des relations économiques de l’Europe avec la Russie, un affaiblissement de l’économie européenne et des avantages économiques et politiques pour les États-Unis. Malgré la capitulation de la majeure partie de l’élite politique européenne face à la subordination totale aux États-Unis, certaines grandes parties du capital allemand dépendent fortement du commerce avec la Chine, bien plus que leurs homologues états-uniens. Toutefois, les États-Unis font actuellement pression sur l’Europe pour qu’elle réduise ses liens avec la Chine.
Plus important encore, la Chine et le camp socialiste sont désormais confrontés à une entité encore plus dangereuse : la structure consolidée de la Triade (États-Unis, Europe et Japon). La décomposition sociale interne croissante des États-Unis ne doit pas masquer l’unité quasi absolue de son élite politique en matière de politique étrangère. Nous voyons la bourgeoisie états-unienne faire passer ses intérêts politiques et militaires avant ses intérêts économiques à court terme.
Le centre de l’économie mondiale se déplace, la Russie et les pays du Sud (y compris la Chine) représentant désormais 65 % du PIB mondial (mesuré en PPA). Entre 1950 et aujourd’hui, la part des États-Unis dans le PIB mondial (en PPA) est passée de 27 % à 15 %. La croissance du PIB des États-Unis est également en baisse depuis plus de cinq décennies et n’est plus que d’environ 2 % par an. Les États-Unis n’ont pas de nouveaux marchés importants sur lesquels s’étendre. L’Occident souffre d’une crise générale du capitalisme et des conséquences de la baisse tendancielle du taux de profit sur le long terme.
2) La contradiction entre les classes dirigeantes du petit groupe de pays impérialistes du G7 et l’élite politique et économique des pays capitalistes du Sud.
Cette relation a connu un changement majeur depuis les années 1990, période faste où le pouvoir unilatéral et l’arrogance des États-Unis étaient à leur apogée. Aujourd’hui, l’alliance entre le G7 et les élites du Sud se fissure de plus en plus. Mukesh Ambani et Gautam Adani, les plus grands milliardaires indiens, ont besoin du pétrole et du charbon de la Russie. Le gouvernement d’extrême droite dirigé par Modi représente la bourgeoisie monopoliste indienne. Ainsi, le ministre indien des Affaires étrangères fait désormais des déclarations occasionnelles hostiles à l’hégémonie américaine en matière de finances, de sanctions et d’autres domaines. L’Occident n’a pas la capacité économique et politique de toujours fournir ce dont les élites au pouvoir en Inde, en Arabie saoudite et en Turquie ont besoin. Cette contradiction ne s’est toutefois pas aiguisée au point de devenir le point de convergence d’autres contradictions, contrairement à la contradiction entre la Chine socialiste et le bloc du G7 dirigé par les États-Unis.

3) La contradiction entre la classe ouvrière urbaine et rurale ainsi que des sections de la petite bourgeoisie inférieure (deux groupes rassemblés sous la catégorie de classes populaires) du Sud global et l’élite du pouvoir impérial dirigé par les États-Unis.
Cette contradiction s’accentue lentement. L’Occident dispose d’un grand avantage en termes de pouvoir d’attraction dans le Sud, toutes classes confondues. Pourtant, pour la première fois depuis des décennies, les jeunes Africains ont soutenu l’expulsion des troupes françaises au Mali et au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest. Pour la première fois, les classes populaires de Colombie ont pu élire un nouveau gouvernement qui refuse que leur pays demeure un avant-poste des forces militaires et de renseignement américaines. Les femmes de la classe ouvrière sont à l’avant-garde de nombreuses batailles cruciales à travers le monde, tant pour la classe ouvrière que pour la société dans son ensemble. Les jeunes s’élèvent contre les crimes environnementaux du capitalisme. Un nombre croissant de membres de la classe ouvrière identifient leurs luttes pour la paix, le développement et la justice comme étant explicitement anti-impérialistes. Ils sont désormais capables de voir clair dans les mensonges de l’idéologie américaine des « droits de l’homme », dans la destruction de l’environnement par les entreprises énergétiques et minières occidentales, et dans la violence des guerres hybrides et des sanctions américaines.

4) La contradiction entre d’une part le capital financier avancé à la recherche de rentes et d’autre part les besoins des classes populaires et certaines sections du capital dans les pays non socialistes, en ce qui concerne l’investissement dans l’industrie, l’agriculture écologiquement durable, l’emploi et le développement.Cette contradiction résulte de la baisse du taux de profit et de la difficulté pour le capital d’augmenter le taux d’exploitation de la classe ouvrière à un niveau suffisant pour financer les besoins croissants d’investissement et rester compétitif. En dehors du camp socialiste, la quasi-totalité des pays capitalistes avancés et la plupart des pays du Sud — à quelques exceptions près, notamment en Asie — connaissent une crise de l’investissement. De nouveaux types d’entreprises ont vu le jour, notamment des fonds spéculatifs tels que Bridgewater Associates et des sociétés de capital-investissement telles que BlackRock. Les « marchés privés » contrôlaient 9 800 milliards de dollars d’actifs en 2022. Les produits dérivés, une forme de capital fictif et spéculatif, représentent aujourd’hui 18 300 milliards de dollars en valeur « marchande », mais leur valeur notionnelle s’élève à 632 000 milliards de dollars, soit une valeur plus de cinq fois supérieure au PIB réel total du monde.
Une nouvelle classe de monopoles basés sur les technologies de l’information et les effets de réseau, dont Google, Facebook/Meta et Amazon — tous sous le contrôle total des États-Unis — a émergé pour attirer les rentes de monopole. Les monopoles numériques américains, sous la supervision directe des agences de renseignement américaines, contrôlent l’architecture de l’information du monde entier, à l’exception de quelques pays socialistes et nationalistes. Ces monopoles sont à la base de l’expansion rapide du soft power américain au cours des 20 dernières années. Le complexe militaro-industriel, les marchands de mort, attire également des investissements croissants.
Cette intensification de la phase d’accumulation spéculative et monopolistique du capital renforce la grève du capital en matière d’investissements sociaux nécessaires. L’Afrique du Sud et le Brésil ont connu des niveaux dramatiques de désindustrialisation sous le néolibéralisme. Même les pays impérialistes avancés ont ignoré leurs propres infrastructures, telles que le réseau électrique, les ponts et les chemins de fer. L’élite mondiale a organisé une grève des impôts en offrant d’énormes réductions des taux d’imposition et des taxes, ainsi que des paradis fiscaux légaux aux capitalistes individuels et à leurs entreprises, afin d’accroître leur part de la plus-value.
L’évasion fiscale du capital et la privatisation de larges pans du secteur public ont réduit la disponibilité des biens publics de base tels que l’éducation, les soins de santé et les transports pour des milliards de personnes. Elles ont contribué à accroître la capacité du capital occidental à manipuler et à tirer des intérêts élevés de la crise de la dette « fabriquée » à laquelle sont confrontés les pays du Sud. Au plus haut niveau, les profiteurs des fonds spéculatifs comme George Soros spéculent et détruisent les finances de pays entiers.
L’impact sur la classe ouvrière est grave, car le travail de cette dernière est devenu de plus en plus précaire et le chômage permanent détruit de larges pans de la jeunesse mondiale. Sous le capitalisme, une partie croissante de la population est superflue. Les inégalités sociales, la misère et le désespoir sont omniprésents.
5) La contradiction entre les classes populaires du Sud et leurs élites politiques et économiques nationales.
Cette contradiction se manifeste de manière très différente selon les pays et les régions. Dans les pays socialistes et progressistes, les contradictions entre les peuples sont résolues de manière pacifique et variée. Toutefois, dans plusieurs pays du Sud où l’élite capitaliste s’est entièrement ralliée au capital occidental, la richesse est détenue par un petit pourcentage de la population. La misère est généralisée parmi les plus pauvres et le modèle de développement capitaliste ne parvient pas à servir les intérêts de la majorité. En raison de l’histoire du néocolonialisme et du soft power de l’Occident, il existe un consensus de la classe moyenne résolument pro-occidental dans la plupart des grands pays du Sud. Cette hégémonie de classe de la bourgeoisie locale et de la couche supérieure de la petite bourgeoisie est utilisée pour empêcher les classes populaires (qui constituent la majeure partie de la population) d’accéder au pouvoir et d’accroître leur poids politique.
6) La contradiction entre l’impérialisme dirigé par les États-Unis et les nations qui défendent fermement leur souveraineté nationale.
Les nations qui défendent leur souveraineté se répartissent en quatre catégories principales : les pays socialistes, les pays progressistes, les autres pays rejetant le contrôle des États-Unis et le cas particulier de la Russie. Les États-Unis ont créé cette contradiction antagoniste par des méthodes de guerre hybrides telles que les assassinats, les invasions, les agressions militaires menées par l’OTAN, les sanctions, la guerre juridique, la guerre commerciale et une guerre de propagande désormais incessante basée sur des mensonges purs et simples. La Russie fait partie d’une catégorie à part, puisqu’elle a subi plus de 25 millions de morts contre les envahisseurs fascistes européens durant la Seconde Guerre mondiale alors qu’elle était un pays socialiste. Aujourd’hui, la Russie, qui dispose notamment d’immenses ressources naturelles, est à nouveau la cible de l’OTAN, qui souhaite l’anéantir en tant qu’État. Certains éléments de son passé socialiste sont encore présents dans le pays, et le degré de patriotisme reste élevé. L’objectif des États-Unis est d’achever ce qu’ils ont commencé en 1992 : au minimum, détruire définitivement la capacité militaire nucléaire de la Russie et installer un régime fantoche à Moscou afin de démembrer la Russie à long terme et de la remplacer par une multitude d’États vassaux de l’Occident, plus petits et perpétuellement faibles.
7) La contradiction entre les millions de travailleurs pauvres mis au rebut dans les pays du Nord et la bourgeoisie qui domine ces pays.
Ces travailleurs montrent quelques signes de rébellion contre leurs conditions économiques et sociales. Cependant, la bourgeoisie impérialiste joue la carte de la suprématie de la race blanche pour empêcher une plus grande unité des travailleurs de ces pays. À l’heure actuelle, les travailleurs ne sont pas toujours en mesure d’éviter d’être la proie de la propagande de guerre raciste. Le nombre de personnes présentes aux manifestations publiques contre l’impérialisme a fortement diminué au cours des trente dernières années.

8) La contradiction entre le capitalisme occidental d’une part, et la planète ainsi que la vie humaine d’autre part.
Le chemin inexorable de ce système est de détruire la planète et la vie humaine, de les menacer d’anéantissement nucléaire et de travailler contre les besoins pour l’humanité de récupérer collectivement l’air, l’eau et la terre et d’arrêter la folie militaire nucléaire des États-Unis. Le capitalisme rejette la planification et la paix. Le Sud global (y compris la Chine) peut aider le monde à construire et à étendre une « zone de paix » et s’engager à vivre en harmonie avec la nature.
Avec ces changements dans le paysage politique, nous assistons à la montée d’un front informel contre le système impérialiste dominé par les États-Unis. Ce front est constitué par la convergence des éléments suivants :
– Le sentiment populaire que ce système violent est le principal ennemi des peuples du monde.
– Le désir populaire d’un monde plus juste, plus pacifique et plus égalitaire.
– La lutte des gouvernements et des forces politiques socialistes ou nationalistes pour leur souveraineté.
– Le désir des autres pays du Sud de réduire leur dépendance à l’égard de ce système.
– Les principales forces contre le système impérialiste dominé par les États-Unis sont les peuples du monde et les gouvernements socialistes et nationalistes. Toutefois, il faut prévoir un espace pour l’intégration des gouvernements qui souhaitent réduire leur dépendance à l’égard du système impérialiste.
Le monde se trouve actuellement au début d’une nouvelle ère dans laquelle nous assisterons à la fin de l’empire mondial des États-Unis. Le système néolibéral se détériore sous le poids de nombreuses contradictions internes, d’injustices historiques et d’une non-viabilité économique. Sans une meilleure alternative, le monde sombrera dans un chaos encore plus grand. Nos mouvements ont ravivé l’espoir que quelque chose d’autre que ce tourment social est possible.
Nous espérons que ce texte stimulera le débat et la discussion et nous aidera dans notre bataille d’idées plus large contre les philosophies sociales toxiques qui cherchent à étouffer la pensée rationnelle sur notre monde.
Source originale: Tricontinental: Institute for Social Research
-
الطاهر المعز-مُتابعات : العدد الخامس والعشرون بعد المائة بتاريخ الرّابع والعشرين من أيار/مايو 2025الطاهر المعز-

مُتابعات – العدد الخامس والعشرون بعد المائة بتاريخ الرّابع والعشرين من أيار/مايو 2025 : الطاهر المعز
يتضمن العدد الخامس والعشرون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية فقرة بعنوان "في جبهة الأصدقاء" وفقرة عن "جائزة البيئة" وتصدير النفايات مكن "الشمال" إلى "الجنوب" وفقرة بعض مظاهر الحرب التجارية وفقرة عن بعض مظاهر الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال القذرة بغطاء قانوني وفقرة بعنوان " شركات التكنولوجيا الكبرى وكالات لوزارة الحرب الأمريكية؟" وتتعلق بالدّعم الحكومي المباشر – بواسطة وزارة الحرب – لشركات الإتصالات والتكنولوجيا الأمريكية منذ إنشائها وفقرة عن تدنّي شعبية دونالد ترامب بعد مائة يوم من الرئاسة ...
مقاطعة:
أكبر نقابة عمالية في النرويج تصوت لصالح مقاطعة إسرائيل وتطالب بفرض عقوبات اقتصادية عليهاصوّت مندوبو اتحاد النقابات العمالية النرويجي، وهو أكبر اتحاد نقابي في البلاد، بأغلبية ساحقة بلغت 88% خلال مؤتمر الإتحاد النقابي الذي عقد في أوسلو يَومَيْ الثامن والتّاسع من أيار/مايو 2025، لصالح المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني، وحَظْر التجارة والاستثمار مع الشركات الصهيونية، ومقاطعة المؤسسات الثقافية والرياضية والأكاديمية الصهيونية والمؤسسات المتعاملة معها، كما طالب المؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدةبإقرار المقاطعة الإقتصادية العالمية للكيان الصّهيوني…
استنكَرَ وزير الخارجية النرويجي « هذه المبادرة أحادية الجانب… ليس للنرويج تقليدٌ في التصرف منفردةً، فقد تكون أضْرار هذه المبادرةٌ أكبر من نفعها » وفق الوزير الذي اعترف بأن قرار الاتحاد العمالي يعكس الدعم المتزايد للعقوبات الدولية، وقال إن « هذه الإجراءات يجب أن تتخذ من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي »، وأكد أن الحكومة لن تتدخل في المؤسسات المستقلة، وقال « ليس من حق الحكومة أن تقرر ما الذي يجب أن تؤمن به المؤسسات الأكاديمية أو الثقافية الحرة ».
أما رئيس اتحاد العمال الجديد كيني أسبر فيستنس فقد صرح « إن الاتحاد سيبدأ الآن في التخطيط لكيفية تنفيذ قرار المقاطعة… سنجتمع لمناقشة كيفية تنفيذ كافة قرارات المؤتمر ووضع خطة مفصلة، لِنُنَفِّذَها ».
وصفت زعيمة الحزب الاشتراكي اليساري كيرستي بيرجستو التصويت بأنه « تفويض تاريخي » للحكومة، وأعلنت » أن الاتحاد العمالي أدرك خطورة هذه اللحظة… لقد قاومت القواعد الشعبية الضغوط وأظهرت تضامنًا حقيقيًا مع الشعب الفلسطيني »، وحث الحكومة على « سحب جميع الاستثمارات المرتبطة بالكيان الصهيوني ومن صندوق النفط ومنع التجارة مع الشركات التي تدعم جرائمه. ».. تجدر الإشارة إلى إن حزب اليسار الاشتراكي نشأ سنة 1975 نتيجة انقسام في حزب العمال.
كما أشاد حزب (رودت) بالتصويت ووصفه بأنه تاريخي وحث الحكومة على التحرك بسرعة، وقال زعيم حزب رودت بيورنار موكسنيس إن حزبه سيقدم مقترحات جديدة لسحب استثمارات صندوق النفط من الكيان الصهيوني وحظر الأنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات، وفرض حظر شامل على الأسلحة، وسبق أن قدّم حزب « رودت » اقتراحًا لإنهاء مبيعات الأسلحة النرويجية للكيان الصهيوني، ولكن الحزب يكتفي بعبارة « المستوطنات غير الشرعية » ( وكان المستوطنات الأخرى « شرعية » أو الكيان الصهيوني نفسه شرعي ».
تأسس حزب رودت، واسمه الكامل حزب رودت الشيوعي اليساري، سنة 2007 نتيجة اندماج حزبين أصغر حجماً هما حزب العمال الشيوعي (AKP) وحزب رودت فالغاليانس ( (RVA، أو التحالف الانتخابي الأحمر، والذي كان بدوره ائتلافاً من مجموعات شيوعية، مثل المجموعة الماركسية اللينينية (MLG) وغيرها من الحركات السياسية والاجتماعية.
تستخدم النرويج الصندوق الإستثماري الحكومي ( تموله عائدات النفط) لدعم الاحتلال والاستيطان الصهيوني وتدرك نقابة عمال النفط ذلك وطالبت منذ سنوات بحَظْر تمويل الإستعمار الإستيطاني، وقرر حزب « رودت » صياغة قرار اتحاد العمل في صورة قانون يُقدّمه للبرلمان يوم الرابع من شهر حزيران/يونيو 2025، خلال حصة تصويت البرلمان النرويجي على تفويض صندوق النفط، وسبق أن قدم حزب SV اقتراحًا مماثلاً إلى البرلمان وتعمل أحزاب اليسار على حث نواب حزب العمال على دعم مبادرات الإتحاد النقابي بدل التحالف مع الأحزاب الرجعية.
تونس – بيئة
تقاسمت الباحثة التونسية « سامية العبيدي الغربي » جائزة غولدمان الدّولية للبيئة (Goldman Environmental Prize ) لسنة 2025 مع خمس باحثين آخرين من مختلف مناطق العالم، ويعود فوزها بالجائزة إلى دورها في كشف فضيحة تهريب نفايات بين إيطاليا وتونس، كنموذج لتحويل الدّول الفقيرة إلى مكب لمختلف أنواع النفايات القادمة من الدّول الغنية، ومعظمها نفايات سامة أو غير قابلة للإنحلال…
ساهمت سامية العبيدي الغربي في الحملة التي فضحت التهريب غير القانوني لحوالي 280 حاوية لنفايات بين إيطاليا وتونس، وأثمرت الحملة، خلال شهر شباط/فبراير 2022، بعد سنتَيْن من النّشاط، إلى إعادة ستة آلاف طن، وهو جزء من النفايات، إلى بلد المنشأ إيطاليا، وتم تصدير هذه النّفايات سنة 2020 بشكل غير قانوني” إلى تونس، بتواطؤ من شركة تونسية ادعت أنها نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، ولكن تم تسريب حقيقة هذه النفايات وعدم قانونية وجودها في تونس، وانتشر الخبر والتعليقات عبر وسائل الاعلام المحلية والدولية، ونظم المواطنون ومنظمات غير حكومية مهتمة بمجال سلامة البيئة والمحيط تظاهرات وأعربوا عن رفضهم تحويل البلاد إلى “مزبلة” لإيطاليا التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن عشرين ألف من الفُقراء المهاجرين غير النّظاميين، وطالب المحتجون بالحق في بيئة سليمة، فالبُنْيَة التّحتية والامكانات اللوجستية في تونس لا تسمح حتى بمعالجة النفايات المحلية، ولا تحتمل توريد نفايات من دول أخرى، وخصوصًا النفايات السّامة والضّارة بالبيئة وبالبشر، وسلطت القضية الضوء أيضا على التجارة العالمية غير القانونية للنفايات التي تطورت رغم القوانين التي تمنع الدول الغنية أساسا من نقل نفاياتها الخطرة إلى أراضي الدول الفقيرة.
أسفرت تلك الفضيحة عن إقالة وزير البيئة التونسي آنذاك من منصبه، وأوقِف، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، كما تمت مقاضاة 26 شخصا من المُتَّهَمين في هذه الفضيحة التي عرّضت صحة المواطنين والمياه والهواء ومحيط التونسيين للخطر
الولايات المتحدة بعد مائة يوم من الرئاسة الثانية لدونالد ترامب
وعَد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه « بالعَجَب العُجاب » خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة للمرة الثانية وعند حلول هذا الموعد، بنهاية شهر نيسان/ابريل 2025، خطب في تجمع من ثلاثة آلاف من أنصاره، تجمّعوا في ضاحية ديترويت بولاية ميشيغان، وادّعى إن رئاسته تمثل العصر الذّهبي للولايات المتحدة، أما الوقائع فتقول إن دونالد ترامب وَقَّعَ بحلول 28 نيسان/ابريل 2025 ( أي خلال مائة يوم) 140 أمراً رئاسياً تنفيذيًا وهو رقم قياسي يُشير إلى تركيز السّلطة بين أيدي الرئيس، وتهميش الهيئات المنتخَبَة، وشملت هذه المراسيم ترحيل المهاجرين وخفض الإنفاق الحكومي وعدد الموظفين الحكوميين وإنهاء برامج المساعدات الدولية وخفض التمويل لبعض البرامج المحلية وللعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدّولية، وإلغاء « التمييز الإيجابي » الذي يُخصّص حصصا ( في التعليم والعمل ) للأقليات المحرومة والتي تتعرض للإقصاء والتمييز، كما قرّر زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات كافة الدّول…
حطّم الرئيس دونالد ترامب الرقم القياسي في سرعة تعبير المواطنين عن الغضب وعن عدم الرّضا، وبحلول منتصف شهر آذار/مارس 2025، فاق عددُ الأشخاص غير الراضين عن حكمه عددَ مؤيديه، وبحلول نهاية نيسان/ابريل انخفضت نسبة تأييد دونالد ترامب إلى 43% وهذه أدنى نسبة منذ خمس وأربعين سنة، ويعتقد 61% من الأمريكِيِّين المشاركين في استجواب إن للرسوم الجمركية التي أقرّها الرئيس الأمريكي تأثير سلبي على التضخم وتكاليف المعيشة، ويُعارض 59% الرسوم الجمركية على الواردات، وهم غير مُقتنعين بأن هذه الإجراءات سوف تعيد التصنيع والوظائف إلى أميركا وتطلق « العصر الذهبي لأميركا » كما ادّعى الرّئيس الذي يتهمه قسمٌ كبير من الرّأي العام (وفق وسائل الإعلام، بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة، القريبة من الحزب الجمهوري) بتقويض الإقتصاد، بفعل التخفيضات الضريبية الكبيرة على الثروات الفاحشة، وارتفاع أسعار السّلع المستوردة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن، ويواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا حادًا قد يؤدّي إلى الرّكود، وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن العجز في الميزان التجاري للسلع ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 162 مليار دولار بنهاية شهر آذار/مارس 2025، كما تباطأ إنفاق المستهلكين، الذي يُغذي حوالي 70% من الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الأول من العام 2025 من 4% خلال الربع الأخير من سنة 2024 إلى 1,8%، سبب انخفاض إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع، وتوقعت المؤسسة المالية « غولدمان ساكس » والاحتياطي الفيدرالي انكماشًا بنسبة تتراوح بين 0,8% و 1,5% بفعل « تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع المخاوف من التضخم ومن تباطؤ التّوْظيف ومن وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي… »، وحَذَّرَ صندوقُ النقد الدولي من « استمرار التوترات التجارية التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي »، وخفض الصندوق توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي لسنة 2025، من 3,3% خلال شهر كانون الثاني يناير إلى 2,8% خلال شهر نيسان/ابريل 2025
أمّا الإقتصاد الأمريكي فإنه على حافة الركود، أي انكماش واسع النطاق في الاقتصاد، يشمل تراجع النشاط الصناعي والتجاري والتوظيف والإنفاق لفترة لا تقل عن ستة أشهر متتالية من النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي
أدّت السياسات الحمائية لتقييد الواردات إلى زيادة التوترات التجارية مع شركاء أمريكا الرئيسيين، مثل الصين وكندا، وإلى زيادة نسبة البطالة في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير، وارتفع معدل البطالة في بعض المناطق الأمريكية نتيجة لتوقف الشركات عن التوسع أو خفض إنتاجها بسبب التكاليف المرتفعة، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بنهاية شهر نيسان/ابريل 2025 – عن وكالتَيْ رويترز و بلومبرغ 30/04/2025
مُسَلْسَل الحرب التجارية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثاني من نيسان/ابريل 2025 أنه قرر فَرْضَ رُسوم جمركية على السلع من شركاء الولايات المتحدة التجاريين الأجانب (وشملت القائمة ما مجموعه 185 دولة)، وسيكون الحد الأدنى لمعدل التعريفة الجمركية الأساسية 10%، ولكن بالنسبة لعدد من البلدان يتم حساب التعريفات بشكل فردي اعتمادًا على العجز التجاري للولايات المتحدة مع هذه البلدان، وبالنسبة للصين، كان من المفترض في البداية أن تبلغ الرسوم الجمركية 34%، وَرَدّت الصّين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على السلع الواردة من الولايات المتحدة اعتبارًا من العاشر من نيسان/ابريل 2025، وكتب دونالد ترامب على موقع « تروث سوشيال »، يوم التّاسع من نيسان/ابريل 2025: « في ضوء عدم احترام الصين للأسواق العالمية، قررت زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على الصين إلى 125%، اعتبارا من الآن »، وردّت الصين بقرار رَفْع الرّسُوم الجمركية على المنتجات الأميركية من 34% إلى 84% اعتبارا من يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025، وذكرت القناة التلفزيونية الأمريكية ( CNBC )يوم العاشر من نيسان/ابريل 2025: إن الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع القادمة من الصين تبلغ حاليا 145% ( 125% الحالية + 20% كان الرئيس الأمريكي قد فَرَضَها سابقًا) نقلا عن ممثل للبيت الأبيض، وأشارت وكالة بلومبرغ ( المملوكة للملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ، رئيس بلدية نيويورك الأسْبَق) إن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة للتنمر والإكراه، ولكن الصين مُصِرّة على الرّد السريع والمُعاملة بالمثل، وإن الصين تعتبر ما أقدم عليه دونالد ترامب من إجْراءات اقتصادية حربا سوف تردّ عليها فورًا وتواصلها للنهاية، وفق عبارات المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصّينِيّة، وحذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من مقرها في جنيف من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تَضُرُّ بتجارة السلع والبضائع بين اكبر اقتصادَيْنِ في العالم.
الولايات المتحدة، ملاذ ضريبي وملجأ للأموال القَذِرة
كشفت « وثائق باندورا » – Pandora Papers – ( تشرين الأول/اكتوبر 2021 ) وجود العديد من الصناديق الائتمانية في الولايات المتحدة التي استخدمت « كملاذات ضريبية سرية »، فضلا عن وجود أصول بمليارات الدولارات في ولاية ساوث داكوتا وحدها والتي تُعدّ من الملاذات الضريبية القانونية في الولايات المتحدة إلى جانب ولايات وايومنغ و ألاباما و كولورادو و لويزيانا و تينيسي و ألاسكا وفلوريدا و نيوهامشاير وتكساس ونيفادا و واشنطن وغيرها، ومن بينها تسع ولايات لا تفرض ضريبة على الدّخل، واختصت كل منها في نوع من التخفيضات الضريبية ( ضريبة الدّخل أو الضريبة العقارية أو ضريبة المبيعات أو الطّاقة…) فضلا عن خفض الضريبة على أرباح الشركات وسِرِّيّة الخدمات المالية، وقُدِّرت قيمة التّهرّب الضّريبي لأغنى 1% من الأمريكيين بأكثر من 163 مليار دولارا سنة 2021 وقُدِّرت ودائع الشركات الأمريكية في الملاذات الضريبة سنة 2015 بأكثر من 1,4 تريليون دولارا، وفق تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، وتُعدّ أربع ولايات أمريكية من أفضل عشرين ملاذ ضريبي لتهريب الثروات في العالم، واعتبر الاتحاد الاتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين الذي نَشَرَ « وثائق باندورا » مع عدد من المؤسسات الإعلامية الدّولية إن ولاية ساوث داكوتا الأميركية تنافس المناطق « غير الشفافة في أوروبا ومنطقة الكاريبي التي توفر السرية المالية »، حيث بلغ أصول الزّبائن في صناديق ائتمانية خاصة في هذه الولاية حوالي 360 مليار دولار، في بلد يُركّز في دعايته السياسية الخارجية على « تعزيز الشفافية المالية » ونبذ « النشاطات غير الشرعية والتهرب من العقوبات » بينما تَحْمِي الصناديق الائتمانية الأمريكية أصول أصحاب المليارات المَحَلِّيّين والدوليين وتوفر لها السرية التي تنافس أو تتجاوز الملاذات الضريبية في الخارج »، وبرّرت ولاية ساوث داكوتا وجود هذا القطاع المالي الذي يشمل المصارف والشركات الائتمانية التي تضمن حماية الثروات وضمان السرية بأنه « نشاط يُوَفِّرُ العديد من المزايا كالوظائف والإيرادات الضريبية العامة ورسوم الإشراف والتبرعات للعمل الخيري… »، وفق صحيفة « واشنطن بوست » ( التي شاركت في التّحقيق الصّحفي الدّولي) بتاريخ الرابع من تشرين الأول/اكتوبر 2021
رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيق قانون شفافية الشركات، أي إن السلطات الأمريكية تُوفِّرُ حمايةً أساسيةً للشركات الوهمية والأفراد من اللُّصُوص المتورطين في غسل الأموال والجرائم المالية، ولا يُشكل قرار دونالد ترامب وحكومته « بِدْعَةً » وإنما يُشكل استمرارًا لممارسات قديمة جعلت من النظام المالي الأمريكي وِجْهَةً مُفضّلة للأموال القذرة وللشركات الوهمية مجهولة الهوية، وفق ائتلاف « فاكت – FACT » التي أشارت إلى « عرقلة مكافحة الفساد من قِبَل إدارة دونالد ترامب التي تخدم مصلحة المُهربين والفاسدين واللّصوص… » ( شباط/فبراير 2025)، وأشار تحقيق مُوثّق نشره موقع صحيفة واشنطن بوست ( 27 آذار/مارس 2025) « إن دونالد ترامب يدعم الفساد والإحتيال الضريبي وغسيل الأموال عبر شركات وهْمية ساعدته في تمويل حملته الإنتخابية، فضلا عن استخدامه شركات وهمية لإنجاز صفقاته العقارية المشبوهة… »
في نفس السياق، تتمتع شركات الصناعات العسكرية بحصانة قانونية، منذ سنة 2005 – خلال رئاسة جورج بوش الإبن- بعدما أقرّ الكونغرس القانون الفيدرالي لحماية التجارة المشروعة للأسلحة (PLCAA).وحَصَّنَ هذا القانون مُصَنّعِي وبائعي الأسلحة النارية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالإصابات « الناجمة عن سوء الاستخدام الإجرامي أو غير القانوني » للسلاح الناري، وتضغط صناعة الوقود الأحفوري على الكونغرس للحصول على حصانة مماثلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ والتي قد تجبر الصناعة على دفع مليارات الدولارات، جراء « تضليل الجمهور بشأن مخاطر الوقود الأحفوري » في محاولة للحصول على نفس الدرع القانوني الذي يحمي مُصَنِّعِي الأسلحة، بعد ارتفاع عدد الدعاوى القضائية بشأن مخاطر الوقود الأحفوري… كما « تحاول شركات تصنيع التبغ والمواد المُخدّرة والسيارات والأدوية والعديد من الصناعات الأخرى الحصول على حصانة مماثلة وعلى إعفاءٍ من المسؤولية، والتخلي عن نظام المسؤولية التقصيرية عن إهمالها – بقدر ما هي مُهملة – ولا ترغب حتى في الدفاع عن نفسها في المحكمة » وفق تقرير نشره موقع صحيفة « وول ستريت جورنال »، وسبق أن حصلت عدة قطاعات أخرى على حماية جزئية من المسؤولية القانونية فقد مُنحت شركات تصنيع اللقاحات حماية من الدعاوى القضائية الناشئة عن ردود فعل نادرة للقاحات، وحصلت شركات الطيران على حصانة محدودة في أعقاب انفجارات 11 أيلول/سبتمبر 2001. ولكن في كلتا الحالتين، ظلت الأموال متاحة للأفراد لتقديم مطالبات بالتعويض، وعمومًا فإن الحصانة التي تتمتع بها شركات تصنيع الأسلحة والتي تُطالب بها قطاعات صناعية أخرى، لا توفر أي مسار للحصول على تعويضات بديلة، وتحرم المُتضرّرين من حقهم في رفع دعوى قضائية…
شركات التكنولوجيا الكبرى وكالات لوزارة الحرب الأمريكية ؟
تَلُوم الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي الصّين على الدّعم الذي تُقدّمه للبحث والإبتكار وللشركات المحلية، ولكن الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي التي تدّعي إنها تترك أمر الإقتصاد والصناعة والتكنولوجيا للسوق التي لها « يد خفية » تُعدّل الأسواق والمنافسة دون الحاجة لتدخل الدّولة، تتدخّل وتضخّ مبالغ ضخمة لدعم وحماية شركات الطيران والتكنولوجيا ولدعم الصادرات وإعفاء الشركات من الضرائب على الأرباح وما إلى ذلك، وفيما يلي نموذج لما يحدث في مجال التكنولوجيا بالولايات المتحدة:
أكدت نيكول شاناهان، الزوجة السابقة لسيرجي برين، أحد مؤسسي شركة غوغل، أن شركات التكنولوجيا الكبرى (غوغل، فيسبوك، أبل، مايكروسوفت، أوراكل وغيرها) نشأت بتشجيع وتمويل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتطورة (داربا)، وهي وكالة تابعة للبنتاغون (وزارة الحرب) وجاءت الأموال من تمويل حكومي سري تم توجيهه عبر شبكة غير رسمية من النفوذ والاتصالات والموارد التي تربط جامعة ستانفورد بشركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، ونشأت هذه الشّبكة حول الجامعة خلال منتصف القرن العشرين، تحت قيادة شخصيات مثل فريدريك تيرمان، وجمعت بين الحكومة وشركات رأس المال الاستثماري لدفع الإبتكار والتّطوّر التكنولوجي، وأنشأ فريدريك تيرمان، سنة 1951، حديقة ستانفورد الصناعية، والتي تسمى الآن حديقة ستانفورد للأبحاث، وهي واحدة من أوائل الحدائق التكنولوجية في العالم، حيث قام بتأجير الأراضي المملوكة للجامعة لشركات مثل هيوليت باكارد، ولوكهيد، وفاريان أسوشيتس.
تلقت جامعة ستانفورد – خلال فترة الحرب العالمية الثانية وبعدها – تمويلاً عاماً، بما في ذلك أموال من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (داربا)، التي أنشئت سنة 1958، لإجراء البحوث في مجال الإلكترونيات والرادار ثم شبكات مثل أربانت، في وقت لاحق، قبل أن تتطور فيما بعد إلى الإنترنت، وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ابتكار وتطوير تقنيات استفادت منها شركات مثل غوغل وسيسكو بعد عقود من الزمن، فقام مؤسسا غوغل لاري بيغ وسيرجي برين بتطوير محرك البحث الخاص بهما كمشروع في جامعة ستانفورد.
إن العديد من مؤسسي شركات التكنولوجيا الجديدة هم من خريجي جامعة ستانفورد، التي كانت بمثابة نقطة جذب لشركات رأس المال الاستثماري منذ سبعينيات القرن العشرين.
الحرب التجارية – خسائر شركات التكنولوجيا الأمريكية انفيديا وأيه إم دي
تأثّرت شركات التكنولوجيا الأمريكية باحتداد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فقد أعلن متحدث باسم شركة “إنفيديا”، يوم الثلاثاء 15 نيسان/ابريل 2025، إن قرارات الحرب التجارية وحظر التعامل مع الصين تؤدّي إلى خسارة الشركة نحو 5,5 مليار دولارا من التّكاليف الإضافية بعد أن حَدَّت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي، وفرضت قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها، ويندرج هذا القرار ضمن محاولة مسؤولي الحكومة الأمريكية الحفاظ على صدارة سباق الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى سيطرة شركة إنفيديا على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة بشكل أساسي في مراكز البيانات، وفقًا لشركة أبحاث السوق آي.دي.سي ( نهاية آذار/مارس 2025)، وانخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 6% لأن رقائق “إتش 20 ” مطلوبة في السوق الصينية ومن قِبَل شركات صينية عديدة مثل “علي بابا” و “تينسنت” و “بايت دانس” ( الشركة الأم لتطبيقات تيك توك ) وهي أكثر تطوّرًا من الرقائق الأخرى المعروضة في أسواق الصّين، وعلّلت الحكومة الأمريكية تقييد مبيعات (إتش20) للصين بسبب “خطر استخدامها في حواسيب عملاقة” وسبق أن أعلنت شركة إنفيديا ( يوم الاثنين 14 نيسان/ابريل 2025) أنها تخطط لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة بمساعدة شركاء مثل تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج (تي.إس.إم.سي)، تماشيا مع سعي إدارة ترامب للتصنيع المحلي.
بالإضافة إلى إنفيديا، أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية أدفانسد ميكرو ديفايسز ( AMD – أيه.إم.دي) إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 800 مليون دولار من إيراداتها نتيجة القيود التي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وإنها ستسعى للحصول على تراخيص لتصدير منتجاتها إلى الزبائن في الصين، لكنها لا تستطيع التأكد من حصولها عليها، وفق وكالة بلومبرغ بتاريخ 15 نيسان/ابريل 2025، وتجدر الإشارة إن إدارة الرئيس “الدّيمقراطي” جوزيف بايدن أصدرت قرارات عديدة تزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بذريعة احتمال ” تهديدات للأمن القومي” من منافس جيوسياسي.
انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع الرقائق، يوم الإربعاء 16 نيسان/ابريل 2025، بعد إعلان شركة إنفيديا أن الضوابط الأميركية الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ستُكلفها 5,5 مليار دولار إضافية، وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج حواسيبها الفائقة للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة لأول مرة، وانخفضت أسهم منافِستها «إيه إم دي» بنسبة 6,5%، كما انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى، فتراجعت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات الاختبار، بنسبة 6,7% في طوكيو، وخسرت شركة ديسكو 7,6% ، بينما انخفضت أسهم شركة تي إس إم سي التايوانية بنسبة 2,4%…
الطاهر المعز
-
VIJAY PRASHAD- Est-ce que les pays du Sud peuvent mener à terme un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication ?


Vijay Prashad, directeur de l’Institut Tricontinental de recherche sociale, prononce le discours d’ouverture, intitulé « L’histoire n’est pas terminée : les trois batailles de notre temps », le 4 mai 2023. Crédit : Institut international de recherche en communication de l’Université normale de Chine orientale
Si le savoir est une arme, l’information peut se révéler un outil de domination sur lequel l’Occident exerce depuis longtemps un jaloux monopole, très longtemps. Depuis les années 1950, les pays du Sud contestent l’hégémonie des pays impérialistes sur le réseau des médias internationaux et tentent de faire entendre leur voix. Les dernières tentatives au sein de l’UNESCO avaient été douchées par l’offensive néolibérale et la privatisation des médias aux mains des multinationales occidentales. Mais le Sud n’a pas dit son dernier mot, comme en témoigne ce forum récent (2023) au cours duquel des centaines de journalistes l’établissement d’un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication au XXIe siècle.
Il est surprenant de constater à quel point les médias de seulement quelques pays peuvent établir les normes sur des problèmes qui nous concernent tous. L’Europe et l’Amérique du Nord bénéficient d’un monopole quasi mondial sur l’information. En effet, leurs médias jouissent d’une crédibilité et d’une autorité survenues de leur statut à l’époque coloniale (comme la BBC) ainsi que de leur maîtrise de la structure néocoloniale de notre époque (comme CNN). Dans les années 1950, les nations postcoloniales ont cerné le monopole de l’Occident sur les médias et l’information et ont cherché à « promouvoir la libre circulation des idées par le mot et par l’image », dixit la Constitution de 1945 de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).
Au nom du mouvement des non-alignés, les pays et les régions d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont développé leurs propres institutions d’information nationales et régionales. En 1958, un séminaire de l’UNESCO organisé à Quito (Équateur) mène à la création d’une école régionale pour former des journalistes et des professionnels de la communication en 1960 connue sous le nom de Centre international d’études avancées en communication pour l’Amérique latine (CIESPAL). Par la suite, en 1961, une réunion tenue à Bangkok crée l’Organisation des agences de presse d’Asie-Pacifique (OANA) et en 1963, une conférence tenue à Tunis crée l’Union des agences de presse africaines (UANA). Ces agences ont essayé de faire valoir les voix du tiers monde à travers leurs propres médias, mais aussi, bien que sans succès, au sein des maisons de presse de l’Occident. En plus de ces efforts, lors de la Conférence générale de l’UNESCO de 1972, des experts de l’Union soviétique et de l’UNESCO ainsi qu’une douzaine de pays ont présenté une résolution intitulée « Déclaration de principes directeurs pour l’utilisation de la radiodiffusion par satellite pour la libre circulation de l’information, la diffusion de l’éducation, et l’ouverture d’échange culturelle », qui appelait les nations et les peuples à avoir le droit de déterminer quelles informations sont diffusées dans leurs pays. Beaucoup d’efforts de ce genre se sont heurtés aux États occidentaux, avec les États-Unis à leur tête. Les conférences se sont enchainées, de Bangkok à Santiago, et bien que la question de la démocratisation de la presse fût prise au sérieux, peu d’avancées furent possibles à cause de l’opposition de l’Occident.
Durant les années 1970 et 1980, il y a eu des efforts communs pour établir un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication et de remédier aux déséquilibres mondiaux dans ce domaine entre les pays développés et ceux en développement. Cette idée a influencé la Commission internationale de l’UNESCO sur l’étude des problèmes de communication, ou Commission MacBride, créée en 1977 et présidée par l’homme politique irlandais et lauréat du prix Nobel Seán MacBride. Seán MacBride qui a d’ailleurs produit un rapport important, mais peu lu sur le sujet (Many Voix, Un Monde, 1980). En 1984, les États-Unis se sont retirés de l’UNESCO suite à ces initiatives. Par la suite, la privatisation des médias dans les années 1980 a finalement éteint tout espoir chez les pays du tiers monde de créer des réseaux de médias souverains, y compris là où les réseaux étaient anticommunistes (comme avec l’Asia-Pacific News Network, établi à Kuala Lumpur, Malaisie en 1981).
Cependant, au cours des dernières années, le rêve d’avoir une circulation libre de l’information a revu le jour à travers les mouvements du Sud. En effet, les mouvements du Sud étaient frustrés par l’absence quasi totale de leurs points de vue dans les débats internationaux et par l’imposition d’une vision du monde étroite et déconnectée des problèmes auxquels ils font face (comme la guerre et la faim). À cette occasion, des centaines de rédacteurs et journalistes du Sud se sont réunis début mai à Shanghai (Chine) pour le Global South International Communication Forum. Au cours de ces deux jours de débats animés, les participants ont rédigé et voté un Consensus de Shanghai, qui peut être lu dans son intégralité ci-dessous.

Le professeur Lu Xinyu, doyen de l’Institut de recherche en communication internationale de l’Université normale de Chine orientale, prononce le discours de clôture du Forum international de la communication Global South, le 5 mai 2023. Crédit : Institut international de recherche en communication de l’Université normale de Chine orientale
Promouvoir l’établissement d’un nouvel ordre mondial de l’information et de la communication au XXIe siècle
Dans les années 1970, dans le cadre du processus d’établissement du nouvel ordre économique international par le mouvement des non-alignés, les États du Sud et l’UNESCO ont tenté d’établir le nouvel ordre mondial de l’information et de la communication. Cette tentative n’a pas vu le jour à cause de la montée de l’hégémonie néolibérale dans les années 1980. L’ascension de la mondialisation néolibérale s’est accélérée à cause de la crise de la dette du tiers monde et de la disparition de l’Union soviétique. L’Occident a établi un « ordre international fondé sur des règles » pour masquer ses structures néocoloniales et ses actions impérialistes. Samir Amin a déterminé que la structure néocoloniale repose sur « 5 facteurs » : la finance, les ressources naturelles, la science et la technologie, les armes de destruction massive et l’information.
Aujourd’hui, bien que le monopole de l’information ne soit pas omniprésent, la structure inégale de celle-ci et de la communication reste discutable et en aggravation. Le cadre de référence dominant sur la production et la communication de l’information dans le monde est toujours tourné vers l’Occident, et les universités et les médias du Sud manquent de mécanismes pour générer des idées et un cadre qui dépasserait la perspective centrée sur l’Occident.
L’Occident domine les médias par des structures néocoloniales. Ces médias sont incapables de mettre en œuvre les défis auxquels sont confrontés les pays du tiers monde ou d’apporter des solutions concrètes à leurs problèmes et plus particulièrement aux pays du Sud.

Les impérialistes étasuniens et leurs alliés arment les médias et engagent des guerres de l’information contre des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Si les pays du Sud essayent d’instaurer la paix et le développement sociétal, l’Occident répond par la guerre et les endette. Aux mains des monopoles médiatiques occidentaux, l’ordre des communications n’est pas utilisé pour promouvoir la paix mondiale, mais pour accentuer le clivage au sein des peuples et encourager la guerre.
Les impérialistes étasuniens et leurs alliés utilisent l’hégémonie des médias pour détourner les nouvelles idées de démocratie, de liberté et de droits de l’homme. Ils attaquent d’autres pays sous prétexte de démocratie, de liberté et de droits de l’homme tout en gardant le silence sur leur pauvre bilan de la démocratie, la privation de liberté et les droits de l’homme.
Les technologies numériques telles qu’Internet, les mégadonnées et l’intelligence artificielle, qui devraient servir le bien-être de la population, sont utilisées par quelques géants des médias occidentaux et plates-formes monopolistiques pour dominer la production et la diffusion d’informations et pour censurer les voix qui diffèrent de leurs revendications. Dans ce contexte, nous pensons qu’il est essentiel que les intellectuels et les professionnels de la communication des pays du Sud et sympathisants de ceux-ci ravivent l’esprit de la Conférence de Bandung de 1955 et du mouvement des pays non alignés (créé en 1961), répondent à l’Initiative de civilisation mondiale (2023), et établissent la solidarité internationale par la théorie et la pratique des communications.
Nous pensons que les intellectuels et sympathisants de Global South doivent promouvoir ses idées et ses productions médiatiques (en particulier dans les domaines de l’histoire et du développement), de s’engager activement dans les échanges et la collaboration académiques et de former un réseau de communication en gardant cette perspective en tête.
Il est essentiel que les médias progressistes et sympathisants de Global South forment un réseau de production et de diffusion de contenu distribué et diversifié, de partager du contenu et des expériences médiatiques et d’établir un front de communication international uni contre l’impérialisme et le néocolonialisme et d’ainsi lutter pour la paix et le développement.
Il est essentiel que le Global South International Communication Forum se tienne chaque année afin de construire un réseau diversifié et multilatéral et une plate-forme de dialogue et d’échange entre intellectuels et professionnels de la communication. Ce réseau et cette plate-forme serviront de base à diverses formes de collaboration avec les gouvernements, les universités, les groupes de réflexion, les médias et d’autres institutions.
La mission historique du Nouvel Ordre Mondial de l’Information et de la Communication n’a pas été atteinte, mais sa mission est toujours en vie. L’anti-impérialisme et l’anticolonialisme sont toujours la bataille du nouveau mouvement des non-alignés.

À la Tricontinentale (Institut de recherche sociale), nous sommes en grande partie d’accord avec la nécessité de faire avancer le nouvel ordre mondial de l’information et de la communication et de raviver le rêve de la libre circulation des idées. Cette entreprise repose sur les efforts du passé, comme l’organisation des agences de presse non alignées, formée par l’agence de presse yougoslave Tanjug le 20 janvier 1975, qui regroupait 11 agences de presse. Au cours de sa première année de fonctionnement, 3 500 histoires ont vu le jour et une décennie plus tard, il y avait 68 agences de presse dans le réseau. Bien que l’organisation des agences de presse non alignées ait maintenant disparu, l’idée de départ est toujours présente. Dernièrement, lors de la conférence de Shanghai, de nouvelles idées émergent sur la création de nouvelles organisations, de nouveaux réseaux et de nouveaux médias, des organisations ancrées telles que Peoples Dispatch et des projets médiatiques partageant les mêmes idées. -
الطاهر المعز-الإمبريالية وحقوق الإنسان

الإمبريالية وحقوق الإنسان : الطاهر المعز
نماذج من الإنتهاك المُتعمّد للحقوق الأساسية
تشن سلطات ووسائل إعلام ومنظمات الدّول الرأسمالية المتقدّمة ( أمريكا الشمالية وأوروبا) حملات متكررة تستهدف روسيا والصين وإيران والعديد من حكومات الأطراف ( البلدان الواقعة تحت الهيمنة) بذريعة « انتهاك حقوق الإنسان »، وشنّت حروبا عدوانية ضد بلدان بذريعة عدم احترام سلطاتها لحقوق الإنسان غير إن أصوات هذه الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية تخفت عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني وبانتهاك حرية التعبير وعدم احترام الحريات الفردية والعامة في البلدان الرأسمالية المتطورة نفسها، أو عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، وفيما يلي بعض النّماذج:
تقدم شركة غوغل خدمات الحوسبة التي تمكن الجيش الصهيوني من ارتكاب المجازر وعمليات التّدمير، مما يجعلها مسؤولة عن جرائم الحرب، بنفس درجة تُجّار الأسلحة، غير إن « القانون الدولي » يُحمّل الحكومات بعض المسؤولية التي لا تُلْزِم الشركات فيما يتعلق بجرائم الحرب، ومع ذلك ارتبط مشروع « نيمبوس » بشكل مباشر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مما قد يؤدِّي إلى مواجهة قادة شركة « غوغل » تهمة جنائية بموجب « القانون الدولي »، من خلال هيئة مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي لديها سلطة قضائية في كل من الضفة الغربية وغزة.
سبق أن أصْدَرت محكمة العدل الدّولية، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2024، حكما حثت فيه الدول على « اتخاذ جميع التدابير المعقولة » لمنع الشركات من « القيام بأي عمل قد يساهم في الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية »، وللتذكير فإن قرارات محكمة العدل الدولية، التي تحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هي « آراء استشارية غير ملزمة، لكنها تتمتع بسلطة قانونية هائلة » وفق فِقْه القانون الدّولي…
إن تحديد المسؤولية الجنائية لشركة غوغل فيما يتصل باحتلال الضفة الغربية أو عمليات القتل المستمرة في غزة يتطلب إجراءات قانونية مُعقّدة، اعتمادًا على مستوى معرفة قادة الشركة بكيفية استخدام خدماتها، وإمكانية التنبؤ بالجرائم التي تسهلها تلك الخدمات، والطريقة التي تساهم بها في ارتكاب تلك الجرائم وما إلى ذلك.
قبل توقيع عقد « نيمبوس » المُربح مع الكيان الصّهيوني، كانت شركة غوغل على علم بأن زبائنها (مثل الجيش الصهيوني) يستخدمون تكنولوجية الحَوْسَبَة السّحابية كما يحلو لهم، ويدرك قادتها جيدًا المخاطر المترتبة على توفير أدوات الحوسبة السحابية والتعلم الآلي المتطورة لدولة متهمة منذ فترة طويلة بارتكاب جرائم حرب، ولا تستطيع غوغل مراقبة أو منع الجيش الصهيوني من استخدام تطبيقاتها لقتل الفلسطينيين فحسب، بل يتطلب العقد منها منع التحقيقات الجنائية التي تجريها دول أخرى في استخدام تكنولوجيتها، وتتطلب هذه التكنولوجيا تعاونًا وثيقًا مع أجهزة الأمن الصّهيونية (بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية)، وهو أمر غير مسبوق في تعاملات غوغل مع المؤسسات والدّول الأخرى، وأثار بعض مالكي أسْهُم شركة غوغل مَخَاطِرَ هذه الصّفقة التي تجعل الشركة مسؤولة جنائيا عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب…
واجه المسؤولون التنفيذيون في مجال الحوسبة السحابية بالشركة معضلة (كانون الثاني/يناير 2021)، قبل ثلاثة أشهر من فوز غوغل و أمازون بعقد نيمبوس الذي كان يسمى « Selenite » وهو من أهم المشاريع المربحة وتوقعت شركة غوغل أن ترتفع إيراداتها من العقد الذي وقّعته مع الكيان الصهيوني إلى 3,3 مليارات دولارا بين سنتي 2023 و 2027، ، ويتمثل في إنشاء مركز بيانات سحابي مخصص للجيش الصهيوني ولشركة الأدوية « تيفا » وبعض الشركات التي تقع تحت سيطرة الإستخبارات العسكرية الصهيونية، وتؤكد الوثائق الدّاخلية التي أشار إليها موقع نيويورك تايمز ( شباط/فبراير 2021) إن مسؤولي « غوغل » كانوا على دراية تامة باستخدام تطبيقاتها للخدمات السحابية لانتهاكات حقوق الإنسان من قِبَلِ أجهزة الأمن ووزارة الحرب والإستخبارات الصهيونية، كما ساعدت شركة غوغل شركات الصناعات العسكرية الصهيونية من خلال تقديم خدمات سحابية ( ضمن مشروع نيمبوس) لشركة الصناعات الجوية الصهيونية المملوكة للدولة والتي دَمَّرَتْ ذخائرُها غزة، كما تم استخدام مشروع نيمبوس في مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوزيعها على المُستوطنين الصهاينة، وتؤكد العديد من الوقائع تورُّط شركة غوغل ( وغيرها من الشركات « الغربية » ) في مساعدة الإحتلال الصهيوني على ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، مما أثار احتجاجات العاملين في شركَتَيْ « غوغل » و « أمازون »، وسبق أن أشار محامي « غوغل » ( إدوارد دو بولاي ) قبل توقيع العقد، في مُذكّرة مكتوبة بتاريخ العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2020، مُوجّهة إلى مسؤولي الشركة « إذا فازت غوغل فسوف تضطر إلى قبول عقد غير قابل للتفاوض بشروط مواتية للحكومة الإسرائيلية… ونظراً لقيمة هذا المشروع وطبيعته الاستراتيجية، فإنه يحمل مخاطر محتملة كبيرة حيث يتضمن العقد حق الحكومة الإسرائيلية الأحادي الجانب في فرض تغييرات على العقد ولن تحتفظ غوغل بأي قدرة على مقاضاة [إسرائيل] للمطالبة بالتعويضات الناشئة عن الاستخدامات غير المسموح بها والانتهاكات ».
اعتبرت المحامية صدف دوست، من مركز القانون المناهض للعبودية « إن توفير خدمات التكنولوجيا المتقدمة من جانب غوغل وأمازون ويب سيرفيسز للحكومة الإسرائيلية من خلال مشروع نيمبوس، ينتهك بطبيعته التزامات كل شركة بواجبات العناية الواجبة بحقوق الإنسان… ( إذْ ) يتضمن المشروع بندًا يمنح المسؤولين الإسرائيليين سلطة تعديل شروط الاستخدام القياسية للشركات بطرق لم يتم توضيحها للجمهور. »
اشترت شركة غوغل شركة ( Wiz ) التي أسّسها أربعة ضُبّاط من وحدة الإستخبارات العسكرية النّخْبَوِيّة الصهيونية قبل خمس سنوات فقط، أي إنها امتداد للمخابرات الصهيونية وتُشغل أكثر من خمسين ضابط من هذه الوِحْدَة العسكرية، وسدّدت غوغل 32 مليار دولار وسوف تُمكّن الجيش الصهيوني من تملك واستخدام بيانات دولية حسّاسة، ولا تنفرد شركة غوغل بالعلاقات الوثيقة مع الإستخبارات العسكرية الصهيونية، بل سبق أن وظّفت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وأمازون وكذلك أبرز وسائل الإعلام الأمريكية، مثل سي إن إن و أكسيوس، العديد من ضباط الجيش والإستخبارات الصهيونية وجواسيس لكتابة وإنتاج أخبار أمريكا عن الشرق الأوسط، غير إن خصوصية « غوغل » تتمثل في استثماراتها المُكثّفة في فلسطين المُحْتلّة…
الولايات المتحدة وأوروبا – انتهاك حرية التعبير
تحوّل اليمين الأمريكي والأوروبي خلال فترات الحرب على أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وغيرها، كما بشأن العدوان الصهيوني ضدّ الشعوب العربية، من « مَعْقل حرية التعبير » إلى حَظْر التعبير والتّظاهر والإحتجاج وتجريم العمل النقابي والإجتماعي والسياسي، وأنشأ آليات قمع لبعض أنواع المعارضين للسياسات الرسمية، وظهرت الممارسات القَمْعية بجلاء، خلال العدوان الصهيوني المستمر منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023، وهي آليات تحظى بدعم من أجهزة الدّولة وتقودها مؤسسات دعائية ( إيديولوجية ) ومالية تُشرف عليها المنظمات الأكثرَ تأييدًا للحروب العدوانية وللكيان الصّهيوني، وتُشكّل هذه الروابط شبكةً مترامية الأطراف من جماعات الضغط، ومليارديرات التكنولوجيا، ومؤسسات أكاديمية وبحْثية ومنظمات « غير حكومية » وشخصيات إعلامية تُعلي باستمرار من شأن المصالح الصهيونية على حساب مصالح الأمريكيين والأوروبيين « العاديين »، الكادحين والأُجَراء والفُقراء…
تُقَدّم الفقرات الموالية نموذجًا للدّعايات الخبيثة التي تُشرف عليها مؤسسات وشبكات من « المانحين » ( المال قوام الأعمال) والتي تدعم بشكل علني ومفضوح الرّقابة وقمع حرية التعبير التي تقودها الدولة، ومَسْؤُولية الشركات العابرة للقارات (خصوصًا شركات التكنولوجيا والإتصالات ) في عمليات الإبادة الجماعية والمجازر الصهيونية ضدّ الشعوب العربية، وكذلك مسؤوليتها في القمع الدّاخلي لمُعارضي السياسات الرسمية في أمريكا الشمالية وأوروبا.
الدّور التخريبي لبعض أنواع المنظمات « غير الحكومية »
كان الكاتب والباحث ديفيد هورويتز – منذ أوائل القرن الحادي والعشرين – محور حركة إسمها « مركز ديفيد هورويتز للحُرّيّة » ( DHFC ) تأسست سنة 1998 وزعمت الدفاع عن حرية التعبير، بينما صوّرت المسلمين واليساريين بمثابة « التهديدات الوجودية للحضارة الغربية » في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، ودعا ديفيد هورويتز إلى تصنيف « الفلسطينيين » و »الإسلاميين » بشكل عنصري، وصرح بشكل سيء السمعة بأن « الفلسطينيين نازيون ».
كان مركز ديفيد هورويتز للحرية (DHFC) مَطِيّةً لجَمْع التبرعات من صناديق وشخصيات مشبوهة ولإنشاء شبكة إعلامية وسياسية ساهمت في تلميع سمعة معظم الشخصيات اليمينية المحافظة البارزة المؤيدة لدونالد ترامب، وموّل المركز حملات تشويه لبعض المنظمات الإنسانية الدّاعمة لحقوق الفقراء، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج، وموّل حملات إعلامية عنصرية تُمجّد التّفَوُّق العرقي الأبيض…
ركّز ديفيد هورويتز ( توفي يوم 29 نيسان/ابريل 2025) جزءًا كبيرًا من نشاطه على الحرم الجامعي من خلال خطاباتٍ تحريضية معادية للإسلام ومؤيدة للكيان الصهيوني، ومُعارضة بشكل استفزازي للطلبة والباحثين الأجانب ولليسار وللمسلمين، وتمكّن من تأسيس شبكة تضم شخصيات يمينية مثل « بن شابيرو » الذي اشتهر بترويج خطاب الكراهية من خلال الموقع الإلكتروني « ثورة الحقيقة » الذي يترأسه، والذي يُموّله مركز ديفيد هورويتز للحرية، كما أسس بن شابيرو مع جيريمي بورينغ « ذا ديلي واير »، كما عمل كلاهما مع منظمات مرتبطة بدوائر استخباراتية صهيونية، قبل أن يوظفا جوردان بيترسون الذي يتبنّى موقفًا مؤيدا للكيان الصهيوني والتقى لاحقًا برئيس وزراء العدو بنيامين نتن ياهو… كما موّل مركز الحرية (DHFC ) نشاط العديد من الشخصيات اليمينية البارزة أو تحالف معها، بمن فيهم كبير استراتيجيي ترامب السابق ستيف بانون، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وباميلا جيلر، والسياسي الهولندي خيرت فيلدرز ( زعيم اليمين المتطرف )، وتلقى وزير الحرب الحالي في إدارة ترامب، بيت هيجسيث، 30 ألف دولار أمريكي كرسوم محاضرات ومكافآت من مركز الحرية بين سَنَتَيْ 2023 و2024…
ساعد مركز هورويتز ( بالمال والدّعاية ) العديد من منظمات ومؤسسات اليمين المتطرف لتوسيع شبكة العداء للطبقة العاملة وللفقراء وللشعوب الواقعة تحت الإستعمار والإضطهاد، ومن بينها منظمة « نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية »، ولعب المركز دور حلقة الوصل بين « المانحين » ووسائل الإعلام والبنية التحتية السياسية اليمينية المؤيدة للكيان الصهيوني…
توسّعت هذه الشّبكة اليمينية المتطرفة والدّاعمة للكيان الصّهيوني، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، وضمّ مركز ديفيد هورويتز للحرية (DHFC) إيلون ماسك الذي تدرّب – مع أَهْلِهِ – على العنصرية في جنوب إفريقيا وأصبح من كبار الدّاعمين للكيان الصهيوني ولدونالد ترامب، كما ضَمّ المركز قادة شركة « سبيس إكس » التي ساعدتها شركة رأس المال الاستثماري أندريسن هورويتز، التي شارك في تأسيسها بن هورويتز ــ نجل ديفيد هورويتز، في جَمْع 750 مليون دولار ( كانون الثاني/يناير 2023 ) وتمتلك شركة أندريسن هورويتز استثمارات في عدة شركات مرتبطة بالاستخبارات والمراقبة الصهيونية، بما في ذلك شركة توكا، التي أسسها رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك، وتعاونت شركة سبيس إكس نفسها مع شركات الأسلحة الصهيونية والشركات المرتبطة بالدولة مثل شركة إلبيت سيستمز، وشركة « الصناعات الجوية الإسرائيلية » (IAI)، وشركة إيماج سات إنترناشونال (ISI)، للمساعدة في إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية، وضم « مركز ديفيد هورويتز للحرية » كذلك روبرت شيلمان، مؤسس شركة كوغنيكس، وهو أحد الممولين الرئيسيين لمركز الحرية، ودعم شيلمان ومؤسسته العائلية شخصيات يمينية متطرفة مثل لورا لومروبريدجيت غابرييل ومشروع فيريتاس، كما يتبرع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) وهي مؤسسة فكرية للمحافظين الجدد لعبت دورًا محوريًا في الدفع نحو حروب تغيير الأنظمة في « الشرق الأوسط »، وتبرّعَ روبرت شيلمان بين سنتَيْ 2002 و 2013، بأكثر من 2,4 مليون دولار للجيش الصهيوني عبر « أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية » (FIDF)، وهي « منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة تساعد أفراد الجيش الإسرائيلي »، وفق تعريفها الرّسمي، وكتبت صحيفة « غارديان »، سنة 2018، إن شيلمان قام بتمويل وظيفة تم إنشاؤها خصيصًا لدعم المحرض اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي حصل على راتب يبلغ حوالي 5000 جنيه إسترليني شهريًا للعمل في المنفذ الكندي Rebel Media، كما ضمّت الشّبكة معهد جيتستون المُختص في تمويل الدّعاية المناهضة للعرب وللمسلمين والمؤيدة للكيان الصهيوني، ودعمت مؤسسة جيتستون شخصيات يمينية متطرفة داعمة للكيان الصهيوني مثل دوغلاس موراي و روبرت سبنسر وبيل أكمان مُدير صندوق التحوط والعديد من ممن اشتهروا بالتشهير بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس المؤيدين لفلسطين، وبالتّحريض ضدّهم بالعنف الجسدي وأدوات مراقبة الذكاء الاصطناعي لقمع كافة أشكال معارضة الرأسمالية والصهيونية.
يوجد العديد من هؤلاء في دوائر القرار بإدارة دونالد ترامب، مثل بيل أكمان ومارك أندريسن اللَّذَيْن تم تعيينهما كمستشارين لإدارة ترامب في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التي يرأسها إيلون ماسك، وكشفت العديد من التقارير الأمريكية، خلال حملة دونالد ترامب (ومنذ 2023) علاقات هذه الشبكة مع المجموعة الإرهابية الصهيونية « بيتار » التي تأسّست قبل قرن من قِبَل الزعيم الصهيوني زئيف جابوتنسكي، وكذلك رابطة الدفاع اليهودية (JDL)، التي كانت السلطات الأمريكية قد صنّفتها سابقًا منظمة إرهابية، ولكنها تمارس نشاطها الإرهابي والمُعادي للحُرّيّات بشكل « طبيعي »، والمتمثل في الترهيب وتهديد العلماء والأكاديميين البارزين والباحثين وومسؤولي الأمم المتحدة والشخصيات المؤيدة للفلسطينيين، ونشرت قوائم لأشخاص يتم تهديدهم بالترحيل والملاحقة القضائية في الولايات المتحدة، وأشادت علنًا باستهداف الجيش الصهيوني للمستشفيالت والطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والصحافيين والنساء والأطفال والخيام التي يلجأ لها فلسطينيو غزة، وترتبط جميع هذه المنظمات والشخصيات بمركز ديفيد هورويتز للحرية الذي يَضُمّ كذلك رون توروسيان المسؤول التنفيذي للعلاقات العامة الإسرائيلي الأميركي ( أيباك) وهو كذلك من المُساهمين في مجلة FrontPage اليمينية المتطرفة…
من حرية التعبير إلى الاستبداد
هناك أشكال أخرى من الإستبداد وقمع الحُرّيّات، يُمارسها مُستثمرو شركات التكنولوجيا بوادي السيليكون وشبكة مُترابطة من مُقاولات الصناعات العسكرية والأمنية ومن « المانحين » وجميعهم من تشكيلات اليمين الأمريكي المُؤيّد للكيان الصهيوني الذي يحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم ويُصوّر مُعارضة الصّهيونية « كتهديد للأمن القومي الأمريكي والغربي »، ويُبَرّر الرقابة والقوائم السوداء والمراقبة الحكومية، ما دامت تستهدف الخصوم الأيديولوجيين، وتمكّنت هذه الشبكة من تحويل انتقاد العقيدة الصّهيونية أو حتى بعض ممارسات الكيان الصهيوني إلى جريمة إسمها « مُعاداة السامية »، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، حيث تسارعت وتيرة القوانين التي تُهدد حرية التعبير، وافتخر رئيس وزراء العدو الصهيوني – خلال شهر شباط/فبراير 2020 – « إن إسرائيل تمكّنت من تمرير قوانين لمعاقبة أولئك الذين يقاطعون إسرائيل في معظم دول الإتحاد الأوروبي ومعظم الولايات الأمريكية »، وتعدّدت القوانين التي تُلزم المتعاقدين مع الدولة – سواءً كانوا أفرادًا أو منظمات – بإثبات معارضتهم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) من خلال توقيع تعهدات تعاقدية بعدم دعمها، وهو ما يعتبره النقاد بمثابة « قَسَم ولاء لإسرائيل »، وفَقَدَ موظفو الدولة، بمن فيهم المعلمون، وظائفهم لرفضهم ذلك، ومنذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، تكثفت بشكل ملحوظ الجهود المبذولة لتجريم الآراء والأنشطة المُؤيّدة للفلسطينيين الذين يتعرّضون للإبادة الجماعية في غزة، بذريعة « التّوْعِية بمخاطر معاداة السّامية » في مؤسسات التعليم ووسائل الإعلام وأماكن الترفيه وممارسة الرياضة وغيرها من الأماكن العامة ، واعتَبَر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية إن مثل هذه القوانين والإجراءات تُشكل خطرًا واضحًا وتَقْيِيدًا لحرية الطّلاّب وهيئات التّدريس خوفًا من فقدان التمويل الحكومي، ومع ذلك صوت 311 عضو في الكونغرس (مقابل 14 عضو) لصالح قانون يعتبر « معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية »، وهو ما فعله الكونغرس على نحوٍ مُفرط . صوّت 311 مُشرّعًا لصالح القرار، مقابل 14 مُشرّعًا فقط ضده.
لا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة، بل اجتاحت هذه الموجة اليمينية المتطرفة والصهيونية العديد من الدّول الأخرى (خصوصًا أعضاء حلف شمال الأطلسي) وفي ألمانيا بشكل خاص، حيث أصبح تقديس الكيان الصهيوني شرطًا للحصول على الجنسية وربما الإقامة في ألمانيا في وقت لاحق، وفي بريطانيا أصبحت تُهمة « تمجيد الأعمال الإرهابية » سيْفًا مُسلّطا على أي مُعارض لعمليات الإبادة الصهيونية، وأثارت موجة قمع الحريات حفيظة الأمم المتحدة التي دقّت ناقوس الخطر خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024، واعتبرت هذه القوانين والممارسات « انتهاكًا للحريات الأساسية وللإتفاقيات الدّولية » وتقويضًا لحق التعبير السلمي عن الرأي، خصوصًا بعد الأحكام الثقيلة التي صدرت في بريطانيا وألمانيا بحق مواطنين أو مُقيمين وإبعاد البعض منهم والحكم بالسجن على آخرين، لمجرّد المُشاركة في احتجاجات قانونية داعمة لحقوق الفلسطينيين، بالتوازي مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري والأمني وارتفاع شعبية أحزاب اليمين المتطرف في بريطانيا وألمانيا ومعظم الدّول الأوروبية…
دَوْر « الذّكاء الإصطناعي » في رَصْد وقَصْف الأهداف المدنية
لم يبتكر الكيان الصّهيوني قصف دور العبادة (المساجد والكنائس) والمدارس والمُستشفيات ومواكب الأعراس أو الجنائز، لأن الكيان الصهيوني ابن الإمبريالية، وسبقته الإمبريالية الفرنسية والبريطانية في الإجرام، قبل أن تُبْدِع الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم الحرب حدّ إلقاء القنابل النووية في اليابان والقنابل الحارقة في فيتنام واليورانيوم المُنضّب والفوسفور الأبيض في العراق، وللولايات المتحدة تاريخ طويل من القصف المتعمد للمستشفيات في جميع أنحاء العالم، وآخرها استهداف وتدمير مركز للسرطان وعلاج الأَوْرام في اليمن يومَيْ السادس عشر والرابع والعشرين من آذار/مارس 2025، وهي جريمة حرب واضحة ومقصودة في ظل الحصار وحَظْر دخول الدّواء والضروريات الأساسية، ولم يُثِر الخبر اهتمام وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وأوروبا فضلا عن وسائل الإعلام التي يُموّلها شيوخ نفط الخليج…
يُمثل هذا الهجوم استمرارًا لتقليد عريق وموثق جيدًا في استهداف الولايات المتحدة للمستشفيات، فففي آب/أغسطس 2017 قصفت الطائرات الأمريكية مستشفى الرّقّة في سوريا واستخدمت الفوسفور الأبيض ودمّرت – خلال أكثر من عشرين غارة – مولدات الكهرباء والمركبات والأقسام، مما أدى إلى تدمير المستشفى بالكامل، وقُتل ما لا يقل عن 30 مريض، وتجدر الإشارة إلى إن الفوسفور الأبيض سلاحٌ محظورٌ على نطاقٍ واسع، يشتعل فورًا عند ملامسته للأكسجين، ويلتصق بالملابس والجلد، ويحترق بدرجة حرارةٍ عاليةٍ للغاية، ولا يُمكن إخماده بالماء، مما يُسبب إصاباتٍ مبرحةً وقاتلةً للمصابين، وقبل ذلك بسنَتَيْن، خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر سنة 2015، شنّت الطائرات الأمريكية حملة قصف على مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود في قندوز بأفغانستان. استُهدف مركز الصدمات، وهو أحد أحدث وأكبر وأشهر مباني المدينة، عمدًا؛ وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد زوّدت الجيش بإحداثياته الدقيقة، وأدّت الغارات إلى قتل 42 على الأقل بين المرضى والعاملين بالمستشفى.
في ليبيا، خلال رئاسة باراك أوباما، قصفت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) مدينة زليتن خلال شهر تموز/يلويو 2011، مما أدى إلى تدمير مستشفى المدينة، وقُتل خمسة وثمانون شخصًا، أما في العراق. فقد كانت الضربات الأمريكية على البنية التحتية المدنية أمرًا متكررًا، ولم تكن المستشفيات استثناءً، ولعل أبرز مثال على ذلك هو قصف مستشفى الهلال الأحمر للولادة في بغداد خلال شهر نيسان/ابريل 2003، كما أصابت صواريخ أميركية مجمعا في وسط المدينة يضم المستشفى، ما أدى إلى مقتل العديد وإصابة 25 شخصا على الأقل، بينهم أطباء، ويُوَفِّرُ المستشفى رعاية صحية بأسعار معقولة للطبقة العاملة العراقية، تَقِلُّ عشر مرات عن العيادات الخاصة في المدينة. وقد اكتسب سمعة طيبة كمستشفى ولادة من الطراز الأول، حيث كان يُولد 35 طفلًا في المتوسط يوميًا قبل الغزو، ولاحظت اليونيسف ارتفاعًا حادًا في وفيات الأمهات بعد القصف، ويعزى ذلك جزئيًا إلى نقص خدمات رعاية التوليد في بغداد.
قبل أربع سنوات، خلال شهر أيار/مايو 1999 ( خلال رئاسة ويليام أو بيل كلينتون )، ألقت طائرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيادة الولايات المتحدة ذخائر عنقودية على سوق ومستشفى في مدينة نيش اليوغوسلافية، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإصابة 60 آخرين، وفقًا لمدير المستشفى، وكما الفوسفور الأبيض فإن الذخائر العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي، ومع ذلك نقلت الولايات المتحدة كميات كبيرة منها، بين سنتَيْ 2023 و 2024، إلى أوكرانيا لاستخدامها ضد القوات الروسية، كما شنت الطائرات الأمريكية سنة 1998 – خلال رئاسة كلينتون – هجومًا على مصنع الشفاء للأدوية في السودان، وكان المصنع، قبل تدميره، يُنتج أكثر من نصف الأدوية السودانية، بما في ذلك المضادات الحيوية الأساسية وأدوية الملاريا والإسهال، وادّعت البروباغندا الأمريكية إن المصنع كان ينتج السّلاح، وقبل ذلك شنت القوات الأمريكية خلال شهر حزيران/يونيو 1993 ( رئاسة كلينتون) هجومًا على مستشفى ديغفر في مقديشو، عاصمة الصومال وقصفت الطائرات الأمريكية المراسلين والمصورين الذين حاولوا تغطية الهجوم…
قصف الجيش الأمريكي العديد من المستشفيات في أمريكا الجنوبية، في غرينادا سنة 1983 وسلفادور بين سنتيْ 1981 و 1984 ثم سنة 1989
في آسيا خلال الحروب الأمريكية في فيتنام وكمبوديا ولاوس (الهند الصينية)، كان قصف المستشفيات بمثابة سياسة رسمية للولايات المتحدة…
الطاهر المعز
-
Huit ans après : la « printanisation » de l’Algérie. Une étude de Ahmed bensaada.

Nous sommes encore dans la bataille autour du leadership du « Hirak » en ce début d’avril 2019. Bien qu’ayant échoué, le plan de nommer de nommer Bouchachi n’est pas abandonné. Un rassemblement dit « dynamique de la société civile pour une sortie de crise pacifique » se constitue pour pallier à cet échec. C’est à ce moment que Ahmed Bensaada me transmet son étude achevée sur l’analyse comparative des printemps arabes et alerte l’opinion publique sur la nécessité d’en prendre conscience tout en l’appelant à préserver le mouvement et à lui insuffler une orientation patriotique et démocratique. Cette étude fournit une somme considérable d’informations sur le financement stupéfiant d’organisations algériennes « au-dessus de tout soupçon » implantées dans tous les milieux sociaux. Elle a joué un rôle capital dans la mise en échec du plan des ONG et des révolutionnaires colorées
Toute sa volonté d’éclairer les algériens se résume dans cette exhortation : » L’analyse des « révolutions » non-violentes dans les autres pays indique que la phase qui suit celle de la chute du pouvoir est beaucoup plus cruciale que la précédente. C’est d’elle que dépend la réussite ou l’échec d’une révolte. L’arrogance, l’entêtement et l’obstination sont de très mauvais conseillers dans cette période.
Faisons en sorte que ce soulèvement populaire soit un vif succès, pour qu’une Algérie nouvelle apparaisse. Une Algérie pleine de promesses pour un peuple qui a tant espéré. »
Huit ans après : la « printanisation » de l’Algérie. Une étude de Ahmed bensaada.
5 Avril 2019
Par Ahmed Bensaada
Une foule dense, une ambiance festive, des jeunes dans la fleur de l’âge, des slogans incisifs, de l’humoursubtil et corrosif, le « retiré » d’une charmante ballerine posant pour la postérité[1], des jeunes qui balaient les rues après les marches, d’autres embrassant des policiers ou leur offrant des fleurs, des bouteilles d’eau distribuées aux manifestants, un couple qui esquisse un pas de danse dans une rue d’Alger[2] …
Comment ne pas être fier de cette jeunesse algérienne débordante de vitalité, montrant aux yeux du monde sa maturité politique, sa discipline et son pacifisme?
Comment ne pas s’enorgueillir de ce réveil populaire susceptible de mettre fin à des décennies d’immobilisme politique qui a engendré la déliquescence de nombreux secteurs socioéconomiques, provoqué la fuite des cerveaux et jeté à la mer des cohortes de « harragas »?
Mais au-delà de ces images idylliques de la contestation, plusieurs questions viennent à l’esprit au sujet de ces manifestations populaires.
Sont-elles spontanées? Comment se fait-il qu’elles soient aussi bien organisées? Est-ce naturel d’offrir des fleurs aux forces de l’ordre dans un pays où cette tradition n’est pas usitée même au sein des familles? Comment se fait-il que les jeunes nettoient les rues après les marches alors que les autres jours ces mêmes rues sont jonchées de détritus?Comment sont conçus les slogans et qui achemine, via les médias sociaux, les avis de manifestations ou de grève estudiantines à travers tout le territoire national et même à l’étranger? Pourquoi l’humour et le sarcasme sont largement surutilisé comme arme de revendication?
Pour répondre à ces questions et à bien d’autres, il est nécessaire de revenir aux mouvements de contestation non-violente similaires qui ont secoué différents pays depuis le début du siècle.
Les révolutions colorées
Les révoltes qui ont bouleversé le paysage politique des pays de l’Est ou des ex-Républiques soviétiques ont été qualifiées de « révolutions colorées ». La Serbie (2000), la Géorgie (2003), l’Ukraine (2004) et le Kirghizstan (2005) en sont quelques exemples.
Toutes ces révolutions, qui se sont soldées par des succès retentissants, sont basées sur la mobilisation de jeunes activistes locaux pro-Occidentaux, étudiants fougueux, blogueurs engagés et insatisfaits du système.
De nombreuses études et livres ont été consacrés à ces bouleversements politiques. À titre d’exemple, citons l’article exhaustif et très détaillé sur le rôle des États-Unis dans les « révolutions colorées », de G. Sussman et S. Krader de la Portland State University qui mentionnent dans leur résumé :
« Entre 2000 et 2005, les gouvernements alliés de la Russie en Serbie, en Géorgie, en Ukraine et au Kirghizistan ont été renversés par des révoltes sans effusion de sang. Bien que les médias occidentaux en général prétendent que ces soulèvements sont spontanés, indigènes et populaires (pouvoir du peuple), les « révolutions colorées » sont en fait le résultat d’une vaste planification. Les États-Unis, en particulier, et leurs alliés ont exercé sur les États postcommunistes un impressionnant assortiment de pressions et ont utilisé des financements et des technologies au service de l’“aide à la démocratie[3]” ».
L’implication de nombreuses organisations américaines a été établie de manière non équivoque. Il s’agit de laUnited States Agency for International Development (USAID), la National Endowment for Democracy (NED), l’International Republican Institute (IRI), le National Democratic Institute for International Affairs (NDI), la Freedom House (FH), l’Albert Einstein Institution (AEI) et l’Open Society Institute (OSI)[4],[5],6.
Ces organismes et agences sont tous américains et sont financés par le budget américain ou par des capitaux privés américains[6]. À titre d’exemple, la NED est financée par un budget voté par le Congrès et les fonds sont gérés par un conseil d’administration où sont représentés le Parti républicain, le Parti démocrate, la Chambre de commerce des États-Unis et le syndicat American Federation of Labor-Congress of IndustrialOrganization (AFL-CIO), alors que l’OSI fait partie de la Fondation Soros, du nom de son fondateur George Soros, le milliardaire américain, illustre spéculateur financier.
Concernant le rôle réel de la NED, il est intéressant de reprendre la déclaration (en 1991) de Allen Weinstein, directeur du groupe d’étude qui a mené à la fondation de cet organisme : « Beaucoup de ce que nous [NED] faisons aujourd’hui se faisait secrètement il y a 25 ans par la CIA »[7].De son côté, le président de la NED, Carl Gershman, a déclaré en 1999 que la « promotion de la démocratie est devenue un champ établi de l’activité internationale et un pilier de la politique étrangère américaine »[8].En résumé, tous ces organismes américains sont spécialisés dans l’«exportation de la démocratie » pour autant que cela serve la politique étrangère des États-Unis.
La NED travaille par l’intermédiaire de quatre organismes distincts et complémentaires qui lui sont affiliés. En plus de l’IRI et du NDI, elle englobe aussi le Center for International Private Enterprise (CIPE — Chambre de commerce des États-Unis) et l’American Center for International Labor Solidarity (ACILS — Centrale syndicale AFL-CIO), mieux connu comme le Solidarity Center[9].
Plusieurs mouvements ont été mis en place pour conduire les révoltes colorées : Otpor (« Résistance ») en Serbie, Kmara (« C’est assez ! ») en Géorgie, PORA (« C’est l’heure ») en Ukraine et KelKel (« Renaissance ») au Kirghizistan.
Le premier d’entre eux, Otpor, est celui qui a causé la chute du gouvernement yougoslave de Slobodan Milosevic.Dirigé par SrdjaPopovic, Otpor prône l’application de l’idéologie de résistance individuelle non-violente, théorisée par le philosophe et politologue américain Gene Sharp. Professeur émérite en sciences politiques à l’Université du Massachusetts, ce dernier a aussi été chercheur à Harvard et aurait été, dit-on, un candidat potentiel pour l’obtention du prix Nobel de la paix en 2009[10], 2012[11] et 2013[12].
[1]ChamseddineBouzghala, « « Poeticprotest », histoire d’une photo qui a marqué la mobilisation algérienne », France 24, le 9 mars 2019, https://www.france24.com/fr/20190309-poetic-protest-photo-danseuse-mobilisation-algerienne
[2]Khalid Mesfioui, « Manif anti-système à Alger: ce beau couple qui a dansé sous la pluie », Le 360, le 23 mars 2019, http://fr.le360.ma/monde/video-manif-anti-systeme-a-alger-ce-beau-couple-qui-a-danse-sous-la-pluie-186597
[3]G. Sussman et S. Krader, « Template Revolutions : Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe », Westminster Papers in Communication and Culture, University of Westminster, London, vol. 5, n° 3, 2008, p. 91-112, http://www.westminster.ac.uk/data/assets/pdf_file/0011/20009/WPCC-Vol5-No3-Gerald_Sussman_Sascha_Krader.pdf
[4]Lire, par exemple, Ian Traynor, « US campaign behind the turmoil in Kiev », The Guardian, 26 novembre 2004, http://www.guardian. co.uk/world/2004/nov/26/ ukraine.usa
[5] Voir l’excellent documentaire de Manon Loizeau, « États-Unis à la conquête de l’Est », 2005. Il peut être visionné à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=4NOdoOQsouE
[6] Pour plus de détails, lire Ahmed Bensaada, « Arabesque$ – Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », Ed. Investig’Action, Bruxelles (Belgique), 2015 – Ed. ANEP, Alger (Algérie), 2016, Chapitre 2 : Les révolutions colorées.
[7]F. William Engdahl, « Géopolitique et “révolutions des couleurs” contre la tyrannie », Horizons et débats, n° 33, octobre 2005, http://www.horizons-et-debats.ch/33/33_16.htm
[8]Michael Barker, « Activist Education at the Albert Einstein Institution: A Critical Examination of Elite Cooption of Civil Disobedience », Indymedia, 21 juillet 2012, http://www.indymedia.ie/article/102162
[9] National Endowment for Democracy (NED), «Idea to Reality: NED at 25 », http://www.ned.org/about/history
[10]Ruaridh Arrow, « Gene Sharp : Author of the nonviolent revolution rulebook », BBC, 21 février 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12522848
[11]Mikael Holter, « Peace Institute Says Nobel Rankings Favor Sharp, Echo of Moscow», Bloomberg, 2 octobre 2012, http://www.bloom berg.com/news/2012-10-02/peace-institute-says-nobel-rankings-favor-sharp-echo-of-moscow.html
[12]TVC, « Academic Gene Sharp nominated for Nobel Peace Prize », 9 octobre 2013, http://www.tvcnews.tv/?q=article/academic-gene-sharp-nominated-nobel-peace-prize

SrdjaPopovic
Son ouvrage « FromDictatorship to Democracy » (De la dictature à la démocratie) a été à la base de toutes les révolutions colorées. Disponible en 25 langues (dont l’arabe), ce livre est téléchargeable gratuitement sur Internet.Gene Sharp est le fondateur de l’Albert Einstein Institution qui, officiellement, est une association à but non lucratif spécialisée dans l’étude des méthodes de résistance non-violente dans les conflits. Cet organisme est financé, entre autres, par la NED, l’IRI et l’OSI[1].
Les contacts entre l’AEI et Otpor ont commencé dès le début de l’année 2000. L’application scrupuleuse des principesde la résistance individuelle non-violente édictés par Gene Sharp a permis la chute rapide du gouvernement serbe. Cet évènement représente la première réussite de la théorie « sharpienne » sur le terrain, le passage de la théorie à la pratique.
Forts de leur expérience dans la déstabilisation des régimes autoritaires, les activistes d’Otpor, ont fondé un centre pour la formation de révolutionnaires à travers le monde. Cette institution, le Center for Applied Non Violent Action and Strategies (CANVAS), se trouve dans la capitale serbe et son directeur exécutif n’est autre que SrdjaPopovic. CANVAS est financé, entre autres, par l’IRI, Freedom House ainsi que George Soros en personne[2].
Un des documents qui circulent dans la Toile et qui illustre la formation dispensée par ce centre est « La lutte non-violente en 50 points »[3], qui s’inspire largement des thèses de Gene Sharp. Cet ouvrage mentionne 199 « méthodes d’action non-violente ». Il est possible d’en citer quelques-unes en utilisant la numérotation adoptée dans le manuel de CANVAS :
- N°6. Pétitions de groupe ou de masse
- N°7 : Slogans, caricatures et symboles
- N°8 : Banderoles, affiches et panneaux d’affichage
- N°12a : Messageries électroniques de masse
- N°25 : Afficher des portraits
- N°28 : Protestations bruyantes
- N°32 : Railler les officiels
- N°33 :Fraterniser avec l’ennemi
- N°35 : Sketchs et canulars
- N°36 : Théâtre et concerts
- N° 37 : Chants
- N° 44 : Simulacre de funérailles
- N° 62 : Grèves d’étudiants
- N° 63 : Désobéissance sociale
- N° 147 : Non-coopération judiciaire
- N° 199 : Gouvernement parallèle
Les experts serbes de CANVAS ont aidé efficacement les activistes en Géorgie (2003) et en Ukraine[4] (2004), mais aussi au Liban[5] (2005) et aux Maldives (2008)[6]. Ils se sont également impliqués, mais avec moins de succès, en Albanie, en Biélorussie, en Ouzbékistan[7], en Iran[8] et au Venezuela[9].
Le logo adopté par Otpor (et ensuite par CANVAS) a été très utilisé dans les révoltes subséquentes. Il s’agit d’un poing stylisé qui est devenu, avec le temps, l’empreinte des formations de CANVAS. Il a été largement utilisé par les activistes des pays cités auparavant.
[1]Michael Barker, Op. Cit.
[2]Maidhc Ó. Cathail, « The Junk Bond “Teflon Guy” Behind Egypt’s Nonviolent Revolution », Dissident Voice, 16 février 2011, http://dissidentvoice.org/2011/02/the-junk-bond-%E2%80%9Cteflon-guy%E2% 80%9D-behind-egypt%E2%80%99s-nonviolent-revolution/
[3] Disponible en plusieurs langues (dont l’arabe et le farsi), ce manuel est téléchargeable gratuitement à partir du site officiel de CANVAS
[4]Slovodan Naumovic, « Otpor ! Et « La révolution électorale » en Serbie », Socio-anthropologie, 2009, N°23-24, p. 41-73, https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/1248
[5] Ahmed Bensaada, « Liban 2005-2015 : d’une « révolution » colorée à l’autre », 14 septembre 2015, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323:liban-2005-2015-dune-l-revolution-r-coloree-a-une-autre&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
[6]Bryan Farrell et Eric Stoner, « How We Brought Down a Dictator », Yes! Magazine, 7 octobre 2010, https://www.yesmagazine.org/peace-justice/how-we-brought-down-a-dictator
[7]Slovodan Naumovic, Op. Cit.
[8]William J. Dobson, « The Dictator’s Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy », Random House Canada Limited, Toronto, 2012
[9] Eva Golinger, « La grève de la faim à la mode de Washington », Mondialisation.ca, 2 mars 2011, http://www.mondialisation.ca/index.php? context=va&aid=23482

Le « printemps » arabe
Les soulèvements populaires qui ont touché les pays arabes vers la fin de l’année 2010 ne sont qu’un prolongement des révolutions colorées.
Fallacieusement baptisés « printemps » par les médias occidentaux, elles ont bénéficié des mêmes soutiens, des mêmes financements et des mêmes formations[1] tout en tirant avantage du développement exponentiel des nouvelles technologies de communication et des réseaux sociaux.
Ainsi, d’activistes, les manifestants impliqués dans les révoltes sont devenus des cyberactivistes car la révolte s’est déroulée plus dans le cyberspace que dans l’espaceréel. L’organisation, la mobilisation, les appels à manifester, la synchronisation et la diversité des actions à mener sur le terrain n’auraient jamais été possiblede manière aussi efficace sans les nouvelles technologies. Wael Ghonim, un des activistes les plus célébres du « printemps » égyptien, a même écrit un livre intitulé « Revolution 2.0 »[2].
Les organismes d’« exportation de la démocratie » ont aidé à la création de ce que Pierre Boisselet[3], un journaliste français, a appelé « la ligue arabe du Net ». Ainsi, de nombreux activistes-blogueurs provenant de différents pays arabesont été formés aux nouvelles technologies et réseautés entre eux et avec des experts[4].
Plusieurs rencontres ont réuni cette « ligue arabe» bien avant le début du « printemps » arabe (et se sont poursuivies par la suite). Citons, par exemple, le second « Arab Bloggers Meeting » qui a eu lieu à Beyrouth du 8 au 12 décembre 2009 et qui a rassemblé plus de 60 cyberactivistes provenant de 10 pays arabes[5]. S’y sont rencontrés les « vedettes » arabes du Net : les Tunisiens Sami Ben Gharbia, Slim Ammamou et Lina Ben Mhenni, les Égyptiens Alaa Abdelfattah et Wael Abbas, le Mauritanien Nasser Weddady, le Bahreïni Ali Abdulemam, le Marocain HishamAlMiraat, le soudanais Amir Ahmad Nasr, la syrienne RazanGhazzaoui, etc. [6]
[1] Pour plus de détails, lire un des livres de Ahmed Bensaada : « Arabesque américaine – le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe », Éd. Michel Brulé, Montréal (Canada), 2011, « Arabesque$ – Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », Ed. Investig’Action, Bruxelles (Belgique), 2015 – Ed. ANEP, Alger (Algérie), 2016.
[2]« Wael Ghonim: Creating A ‘Revolution 2.0’ In Egypt », NPR, 9 février 2012, https://www.npr.org/2012/02/09/146636605/wael-ghonim-creating-a-revolution-2-0-in-egypt
[3] Pierre Boisselet, « La “ligue arabe” du Net », Jeune Afrique, 15 mars 2011, http://www.jeuneafrique.com/192403/politique/la-ligue-arabe-du-net/
[4] Pour de plus amples informations, lire Ahmed Bensaada, « Arabesque$ – Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », Ed. Investig’Action, Bruxelles (Belgique), 2015 – Ed. ANEP, Alger (Algérie), 2016, Chapitre 3 : Les nouvelles technologies.
[5] Heinrich-Böll-Stiftung, « Second Arab Bloggers Meeting 2009 », 8-12 décembre 2009, http://lb.boell.org/en/2014/03/03/second-arab-bloggers-meeting-statehood-participation
À noter que cette formation a été cofinancée par l’OSI de G. Soros
[6]Pour voir les photos du « Second Arab Bloggers Meeting 2009 », https://www.flickr.com/groups/1272165@N24/pool/with/4193262712/
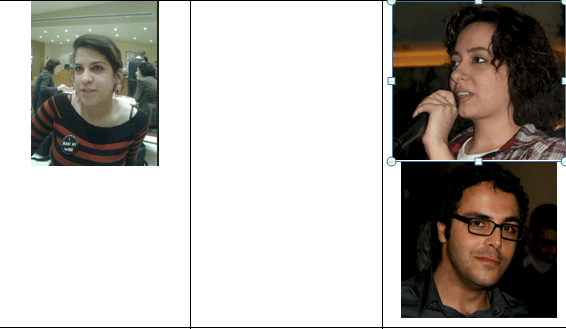
Et ce n’est pas tout. Les géants du Net (Twitter, YouTube, Google, Facebook,etc.) ont collaboré avec le Département d’État américain et les organismes d’ « exportation de la démocratie » pour réunir les cyberactivistes en 2008, 2009 et 2010[1]. Cela s’est fait sous l’égide de l’Alliance de Mouvements de Jeunesse (AYM — Alliance of YouthMovements) dont le la mission est clairement affichée sur leur site : i) identifier des cyberactivistes dans des régions d’intérêt ; ii) les mettre en contact entre eux, avec des experts et des membres de la société civile ; et iii) les soutenir en les formant, en les conseillant et en leur procurant une plateforme pour initier les contacts et les développer dans le temps[2].
La secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, est intervenu en personne dans le sommet AYM de 2009. Cette dernière n’a d’ailleurs pas cessé de couvrir les nouvelles technologies d’éloges durant tout le « printemps » arabe. «Internet est devenu l’espace public du XXIe siècle » ; « les manifestations en Égypte et en Iran, alimentées par Facebook, Twitter et YouTube, reflète la puissance des technologies de connexion en tant qu’accélérateurs du changement politique, social et économique » déclara-t-elle le 15 février 2011[3].
En plus des formations relatives au cyberespace, des activistes arabes ont été initiésaux techniques de CANVAS afin de maîtriser des manifestations dans l’espace réel. Un cas d’école est celui de l’Égyptien Mohamed Adel, le porte-parole du « Mouvement du 6 avril »[4]. En effet, il a affirmé, dans une entrevue accordée à la chaîne Al Jazeera (diffusée le 9 février 2011), qu’il avait effectué un stage chez CANVAS durant l’été2009, bien avant les émeutes de la place Tahrir[5]. Il se familiarisa avec les techniques d’organisation des foules et les comportements à avoir face à la violence policière : « J’étais en Serbie et je me suis formé à l’organisation de manifestations pacifiques et aux meilleurs moyens de s’opposer à la brutalité des services de sécurité », a-t-il confié dans cette interview. Par la suite, il forma à son tour des formateurs[6].Cette information a été confirmée par SrdjaPopovic: « Oui, c’est vrai. On a notamment formé des jeunes du Mouvement du 6 avril », a-t-il avoué à un journaliste suédois[7].
[1]Ahmed Bensaada, « Les États-Unis et le « printemps » arabe », Politis (n°2, pp. 59-61, Octobre-Novembre 2011), http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=147:les-etats-unis-et-le-l-printemps-arabe-r&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
[2] Movements.org, « About » http://www.movements.org/movements/pages/about/
[3] « Hillary Clinton milite pour la liberté sur Internet », Le Monde, 16 février 2011, http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/02/16/hillary-clinton-militepour-la-liberte-sur-internet_1480855_651865.html
[4] Fondé par Ahmed Maher et Israa Abdel Fattah, le « Mouvement du 6 Avril », a été le fer de lance de la contestation populaire en Égypte et le principal artisan de la chute de Hosni Moubarak.
[5] Al Jazeera, « People & Power — Egypt : Seeds of change », 9 février 2011, http://www.youtube.com/watch?v=QrNz0dZgqN8&feature=player_ embedded
[6]Ibid.
[7]Tomas Lundin, « La révolution qui venait de Serbie », Svenska Dagbladet, 2 mars 2011, http://www.presseurop.eu/fr/content/article/522941-la-revolution-qui-venait-de-serbie
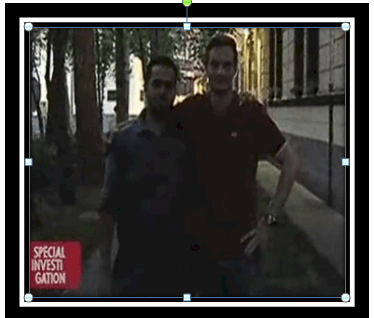
Mohamed Adel et Srdja Popovic (Serbie, 2009) Photo extraite du documentaire intitulé : « Monde arabe : l’onde de choc »
C’est pour cette raison que des « méthodes d’action non-violente » recommandées par CANVAS ont été largement observées lors des manifestations qui ont ébranlées les rues arabes. En particulier, le poing d’Otpor, signature de CANVAS, a été très abondamment utilisé par les cyberactivistes arabes, de l’Atlantique au Golfe.


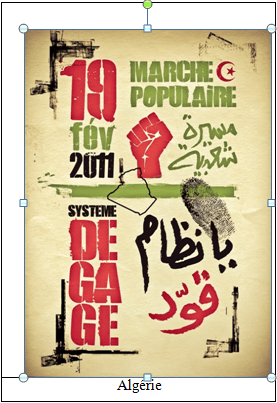
Algérie 2011 : la « printanisation » avortée
Tout comme les pays arabes de la zone MENA « Middle East and North Africa » (littéralement, « Moyen-Orient et Afrique du Nord ») selon la classification de la NED, l’Algérie n’a pas été épargnée par la vague « printanisante » de 2011 car, il faut se le dire, ce pays est un des (si ce n’est le) plus convoités de la région. Les mêmes réseaux ont été activés et les officines citées auparavant s’attendaient à ce qu’elle tombe dans l’escarcelle de l’« exportation de la démocratie ».
Néanmoins, le « printemps » n’a pas eu prise sur la population algérienne à cause, probablement, de la mémoire douloureuse d’une certaine décennie noire et sanglante qui a endeuillé toute la nation. Pourtant, les acteurs de la révolte ont été à l’œuvre.
La contestation du gouvernement en place a été organisée par la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD), regroupant divers partis politiques, ONG et syndicats. Parmi les signataires de la première mouture du CNCD (elle s’est divisée par la suite), on trouve la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), le Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP), le parti « Rassemblement pour la culture et la démocratie » (RCD), le parti « Front des forces socialistes »(FFS), Fodil Boumala, l’association « SOS Disparus » et le Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ) [1].
La consultation des rapports annuels de la NED montre que la LADDH a reçu des subventions américaines en 2002[2], 2004[3], 2005[4], 2006[5] et 2010[6] (voir le tableau suivant).
Ligue Algérienne de Défensedes Droits de l’Homme (LADDH) Année Montant ($) 2002 20 000 2004 — 2005 20 000 2006 40 000 2010 37 000 Le SNAPAP, quant à lui, est en étroite relation avec le Solidarity Center (une des quatre composantes de la NED) comme cela est expliqué dans la page « Algérie » du site de cet organisme[7].
Le 4 mars 2011, en plein embryon de « printemps » algérien, la directrice du Département international du Solidarity Center, Cathy Feingold, a écrit une lettre au Président Abdelaziz Bouteflika. Elle lui a fait part de son inquiétude concernant la violence policière contre les « manifestants pacifiques » en Algérie en précisant que « nous [leSolidarity Center] notons avec une vive préoccupation que, parmi les personnes blessées récemment, figurait le dirigeant syndical M. Rachid Malaoui président du secteur public de l’union syndicale nationale autonome du personnel d’administration publique (SNAPAP) »[8].
Cathy Feingold envoya une seconde lettre au Président Bouteflika en date du 14 octobre 2011. Le nom « du militant CNCD de premier plan », M. Malaoui, y est cité trois fois[9]. Et madame Feingold semblait bien renseignée sur l’activisme politique algérien (probablement en temps réel).
De son côté, le RCD est un parti dont le président était Saïd Sadi lorsque les manifestations antigouvernementales occupaient les rues algéroises. Le nom de ce politicien a été cité dans le câble WikiLeaks 07ALGIERS1806[10], daté du 19 décembre 2007. Ce document montre que Saïd Sadi a eu des discussions politiques assez « poussées » avec l’ambassadeur américain à Alger.
Le rédacteur du câble y nota que Saïd Sadi comparait le gouvernement du président Bouteflika à « une bande de Tikrit », allusion faite à Saddam Hussein et sa région d’origine en Irak. L’ex-chef du RCD alla jusqu’à demander un « soutien extérieur » :« Sadi a averti les États-Unis des dangers à long terme de garder le silence sur ce qu’il percevait comme la détérioration de la démocratie algérienne, comme en témoignent les élections locales. De l’avis de Sadi, un soutien extérieur est essentiel à la survie de la démocratie et l’engagement productif de la jeunesse algérienne – 70 pour cent de la population – dans la vie politique et économique ».
Sur son compte Twitter, Fodil Boumala, cofondateur de la CNCD, se présente comme « écrivain-journaliste, cyberactiviste, militant des droits de l’Homme, opposant politique indépendant, Fondateur de Res Publica II (ONG) sur Facebook &YouTube »[11].Ajoutons à cela que Boumala s’est fait connaître du public algérien en animant des émissions politiques à la télévision nationale algérienne.
Le 20 janvier 2012, une conférence intitulée « Le printemps arabe, un an après : révolte, ingérence et islamisme » a été organisée à Montréal[12]. En plus de ma personne, Fodil Boumala et Mezri Haddad (à partir de Paris, via Skype) étaient les conférenciers invités.
Le débat a été très animé et les échanges très vifs. C’est pendant un de ces échanges que Fodil Boumala déclara que, lors d’un de ses voyages aux États-Unis, il a été reçu par le président Obama en personne.Il est vrai que l’administration américaine a facilement ouvert les portes de ses plus prestigieux bureaux aux cyberactivistes arabes qui ont été reçus par des responsables de premier plan. Si l’aveu de Fodil Boumala s’avère véridique, il doit être un des rares à avoir obtenu une rencontre à ce niveau d’importance.
[1]Algeria Watch, « Pour une Coordination nationale pour le changement et la démocratie : Communiqué », 23 janvier 2011,https://algeria-watch.org/?p=34161
[2]Sourcewatch, « Algerian League for the Defense of Human Rights », http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Algerian_League_for_the_Defense_of_Human_Rights
[3]Ibid.
[4]NED, « Algeria », 2005 Annual Report, http://www.ned.org/publications/annual-reports/2005-annual-report/middle-east-and-north-africa/description-of-2005-gra-1
[5]NED, « Algeria », 2006 Annual Report, http://www.ned.org/publications/annual-reports/2006-annual-report/middle-east-and-northern-africa/description-of-2006–1
[6]NED, « Algeria », 2010 Annual Report, http://www.ned.org/publications/annual-reports/2010-annual-report/middle-east-and-north-africa/algeria
[7]Solidarity Center, « Algeria », http://www.solidaritycenter.org/content.asp?pl=863&sl=407&contentid=861
[8]Cathy Feingold, « Letter from AFL-CIO International Director Cathy Feingold to Algerian President Abdelaziz Bouteflika, », 4 mars 2011, http://www.solidaritycenter.org/files/algeria_cflettertobouteflika030411.pdf
[9]Cathy Feingold, « Letter from AFL-CIO International Director Cathy Feingold to Algerian President Abdelaziz Bouteflika », 14 octobre 2011, http://www.solidaritycenter.org/files/algeria_cfletter101411.pdf
[10]WikiLeaks, « Câble 07ALGIERS1806 », http://wikileaks.mediapart.fr/cable/2007/12/07ALGIERS1806.html
[11]Twitter, « Fodil Boumala », https://twitter.com/FodilBoumala1
[12]Conférence « Le printemps arabe, un an après: révolte, ingérence et islamisme », Université du Québec à Montréal, 20 janvier 2012, http://www.ahmedbensaada.com/index.php?option=com_content&view=article&id=152:conference-q-le-printemps-arabe-un-an-apres-revolte-ingerence-et-islamismeq&catid=46:qprintemps-arabeq&Itemid=119
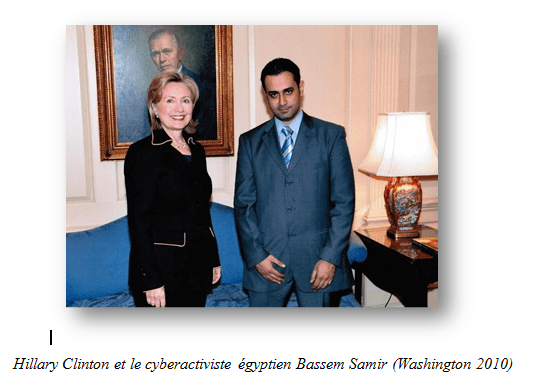
Selon le site e-Joussour, « SOS Disparus », cet organisme dont le nom apparaît dans la liste des fondateurs du CNCD, est « une association algérienne de soutienet de conseil juridique et administratif aux milliers de familles de victimes de disparition forcée en Algérie […]. « SOS disparus » a vu le jour en 2001, suite à la création, en 1998, en France, du Collectif des familles de disparus en Algérie (CFDA) à l’initiative d’un petit groupe de familles de disparus. Notre association travaille en collaboration constante avec le CFDA qui est l’interface entre les familles algériennes et les instances internationales de protection des droits de l’Homme, telles que l’ONU ou la Commission africaine des droits de l’Homme »[1].
Ainsi, « SOS disparus » travaillerait en étroite collaboration avec le CFDA qui est une association de droit français enregistrée à Paris (France).
D’autre part, sur le propre site du CFDA, on peut lire qu’« en septembre 2001, le CFDA a pu ouvrir son premier bureau en Algérie, sous le nom de SOS Disparu(e)s, structurer le mouvement des mères de disparu(e)s et offrir à toutes les victimes une assistance dans leurs démarches administratives et judiciaires ainsi qu’une assistance psychologique. Depuis, un autre bureau de SOS Disparu(e)s a été ouvert à Oran et plusieurs comités de familles ont été créés dans le reste du pays »[2].
Force est donc de constater que « SOS disparus » n’est finalement qu’une « succursale » algérienne du CFDA, sa maison-mère française.
Il faut se rendre à l’évidence que le CFDA n’est pas inconnu de la NED, bien au contraire. De tous les organismes figurant dans la liste « Algérie » de la NED, c’est celui qui a reçu le plus régulièrement des subventions américaines. Le tableau suivant les résume.
Collectif des Famillesde Disparus en Algérie (CFDA) Année Montant ($) 2005 40 000 2006 43 500 2007 46 200 2009 38 200 2010 40 000 2011 40 000 À préciser que le CDFA et « SOS Disparus » mènent souvent leurs actions ensemble, dans des coalitions qui regroupent d’autres associations au profil similaires comme « Soumoud » et « Djazaïrouna »[3],[4].
Finalement, notons que le RAJ a bénéficié d’un financement de 25 000$ de la NED en 2011[5].
Algérie 2019 : la « printanisation » en marche
Depuis le 22 février 2019, les rues algériennes connaissent une effervescence sans précédent. Certaines personnes prétendent même qu’ils n’ont pas été témoins de telles manifestations populaires depuis l’indépendance du pays. La presse nationale et internationale ne tarit pas d’éloge sur la maturité politique de la jeunesse algérienne, son haut sens de l’humour et son organisation exemplaire.
Les médias et de nombreux « analystes » frayant dans les plateaux de télévision ont aussi mis de l’avant la « spontanéité » de la révolte. Une telle assertion relève d’une incompétence abyssale, d’une mémoire courte ou d’un parti pris pour un agenda précis.
- De la spontanéité des révoltes non-violentes
« Ces manifestations ont un air spontané. De là vient leur force. Pourtant, presque chaque détail en est pensé […]. Quelques ingrédients savamment agencés et à peine un an de préparation se révèlent plus efficaces que les bombes ».
Contrairement à ce que l’on peut penser, ces phrases n’ont aucune relation avec l’Algérie ou les révoltes de la rue arabe. Elles sont tirées d’un article qui a été écrit en janvier 2005 par Régis Genté et Laurent Rouy et qui traitait des révolutions colorées[6] et dont les conclusions corroborent celles de G. Sussman et S. Krader citée au début de travail[7].
Toujours à ce sujet, voici le commentaire d’Ivan Marovic, ancien activiste serbe d’Otpor et formateur à CANVAS : « Les révolutions sont souvent considérées comme spontanées. Il semble que des gens sont simplement allés dans la rue. Mais c’est le résultat de plusieurs mois ou années de préparation. C’est très ennuyeux jusqu’à ce que vous atteigniez un certain point où vous pouvez organiser des manifestations ou des grèves de masse. Si cela est soigneusement planifié, au moment où elles commencent, tout est fini dans quelques semaines »[8].
Dans une de ses nombreuses conférences publiques, SjrdaPopovic explique que : « On vous a menti concernant le succès et la spontanéité des révolutions non-violentes. Lorsque vous voyez un jeune dans la rue en train de fraterniser avec la police ou les militaires, quelqu’un y a pensé avant »[9].
À propos des manifestations actuelles en Algérie, Michaël Béchir Ayari, chercheur et analyste politique ne croit pas à la spontanéité du mouvement : « A Alger, rares sont les manifestants qui affirment que ce mouvement est entièrement spontané. La plupart d’entre eux disent ne se faire aucune illusion quant à la présence d’acteurs de l’ombre issus de différents secteurs de la société algérienne, qui alimentent ce mouvement à défaut de l’avoir suscité.Nombre de ces acteurs participent en effet à ces protestations ou les soutiennent discrètement. »[10]
En fait, l’apparente spontanéité de ces mouvements populaires est non seulement « séduisante », mais elle s’accompagne toujours d’un effet de surprise et l’incrédulité de bon nombre de personnes est humainement compréhensible.En effet, rien ne vaut une belle révolte spontanée et populaire pour l’imaginaire collectif et le romantisme révolutionnaire. La révolte de David contre Goliath, la revanche du faible contre le puissant, du petit peuple armé de sa foi contre le tyran omnipotent…
Pourtant, l’ancien président américain Franklin D. Roosevelt (1882-1945) nous avait bien averti : « En politique, rien n’arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié ainsi ».
Et le cas algérien, ne fait certainement pas exception comme il sera expliqué ci-après.
De la participation des cyberactivistes algériens à la « ligue arabe du Net » et aux formations de CANVAS
Il n’y a aucune raison pour que des Algériens n’aient pas été associés au programme d’« exportation de la démocratie ». L’Algérie est un pays jeune, riche et géostratégiquement très important. Elle est gouvernée par une classe politique qui ne diffère pas de ses voisins« printanisés » en plus d’être le dernier bastion du « front du refus » arabe.
La consultation de la liste des participants du second « Arab Bloggers Meeting » qui a eu lieu à Beyrouth et qui a été cité précédemment montre que des cyberactivistes algériens y ont participé[11]. Cela a été corroboré par l’illustre cyberactiviste tunisien Slim Amamou à qui on a demandé s’il avait eu des contacts ou des échanges d’expériences avec d’autres cyberdissidents dans le monde arabe dont l’Algérie : « D’abord, les liens étaient tissés bien avant la révolution [tunisienne]. C’est-à-dire que la révolution n’a pas commencé en décembre 2010. […] Et on se supporte mutuellement […] le réseau existe déjà. Les cyberdissidents et les activistes égyptiens sont nos amis. Et on a des amis au Bahreïn, en Syrie, au Yémen…En Algérie, moi personnellement, j’en ai pas beaucoup, mais je suis sûr qu’il y a des connexions déjà préétablies […]. Ça, c’est avant la révolution. Ils nous ont supportés et on les a supportés […]. Et c’est mutuel : quand on a besoin d’eux, on les trouve ; quand ils ont besoin de nous, ils nous trouvent. Et c’est tout un réseau, il n’y a pas de frontière. Après la révolution, les liens sont toujours là et ils augmentent encore »[12].
Dans un article publié dans le New York Times du 13 février 2011, David D. Kirkpatrick et David E. Sanger rapportent les propos de Walid Rachid, un des membres du « Mouvement du 6 avril » égyptien : « Tunis est la force qui a poussé l’Égypte, mais ce que l’Égypte a fait sera la force qui poussera le monde ».
Walid Rachid mentionne aussi que des membres de son mouvement ont échangé leurs expériences avec des mouvements de jeunesse similaires en Libye, en Algérie, au Maroc et en Iran[13].
En ce qui concerne les formations de CANVAS, Mohamed Adel a reconnu s’être rendu en Serbie avec quatorze autres militants Algériens et Égyptiens[14].
En résumé, on peut donc affirmer que des activistes algériens ont été formés à la maîtrise du cyberespace dans le cadre de l’« exportation de la démocratie » vers le monde arabe, mais aussi aux techniques d’action non-violentes, tout en maintenant de solides contacts avec leurs homologues dans les pays arabes « printanisés ».
De la dualité de la communication dans les révoltes non-violentes
Dans un article fouillé sur le mouvement Otpor, Slovodan Naumovic explique que l’action politique de ce mouvement consiste à élaborer des campagnes de communications dites positives et négatives : « La première consiste à construire un capital de sympathie et de confiance [du mouvement] auprès de la population.[…] La seconde campagne, dite négative, s’appuie sur des techniques pleines d’imagination, d’humour et de bonne humeur, qui utilisent souvent des procédés satiriques pour souligner l’absurdité du régime. L’action négative consiste à définitivement discréditer le régime auprès de l’opinion. »[15]
Cette dualité a été largement utilisée dans les manifestations des rues arabes, mais aussi récemment en Algérie.
[1]e-Joussour, « SOS disparus », http://www.e-joussour.net/node/1104
[2] Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (CFDA), « Historique et présentation », http://www.algerie-disparus.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=131
[3]Appel de la « Coalition d’associations de victimes des années 1990 », 8 octobre 2011, https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/cp-marche-declaration.pdf
[4]Adlène Meddi, « Algérie : les victimes des violences des années 1990 élaborent une contre-charte », El Watan, 24 septembre 2010, https://histoirecoloniale.net/Algerie-les-victimes-des-violences.html
[5]NED, « Algeria », 2011 Annual Report
[6] Régis Genté et Laurent Rouy, « Dans l’ombre des “révolutions spontanées” », Le Monde diplomatique, janvier 2005, http://www.monde-diplomatique.fr/2005/01/GENTE/11838
[7]G. Sussman et S. Krader, Op. Cit.
[8] Tina Rosenberg, « Revolution U », Foreign Policy, 16 février 2011, http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/16/revolution_u
[9]TEDxKrakow, « Srdja Popovic – How to topple a dictator », YouTube, 22 novembre 2011, https://www.youtube.com/watch?v=Z3Cd-oEvEog
[10] Michaël Béchir Ayari , « En Algérie, la rue met le pouvoir face à ses contradictions », ICG, 7 mars 2019, https://www.crisisgroup.org/fr/middle-east-north-africa/north-africa/algeria/en-algerie-la-rue-met-le-pouvoir-face-ses-contradictions
[11] Heinrich-Böll-Stiftung, « Second Arab Bloggers Meeting 2009 », Op, Cit.
[12]Algérie-Focus, « Interview de Slim404, le blogueur tunisien devenu ministre », 28 juin 2011, http://www.youtube.com/watch?v=t9nr-TMKx1c&feature=player_embedded
[13]David D. Kirkpatrick et David E. Sanger, « A Tunisian-Egyptian Link That Shook Arab History », New York Times, 13 février 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/14/world/middleeast/14egypt-tunisia-protests.html?pagewanted=1&_r=2
[14]Sofia Amara, « Monde arabe : onde de choc », Op. Cit.
[15]Slovodan Naumovic, « Otpor ! Et « La révolution électorale » en Serbie », Op. Cit.


Plusieurs actions ont été réalisées sur le terrain afin dede donner une image attrayante et sympathique du mouvement et, ainsi, élaborer unecampagne de communication positive. Citons par exemple l’enthousiasme, la bonne humeur, l’insistance sur le caractère non-violent et bon enfant des manifestations, la distribution de bouteilles d’eau, le balayage des rues, etc.


À noter que ces procédés sont conformes aux « méthodes d’action non-violente » préconisées par le manuel de CANVAS, en particulier, les numéros 7, 8, 28, 32 et 37.
À propos du point concernant le nettoyage des rues qui a été plébiscité par la presse nationale et internationale, il est à noter qu’il s’agit d’une pratique très usitée dans les manifestations non-violentes.
Déjà, en 2003, le mouvement géorgien Kmara avait fait du nettoyage des rues son cheval de bataille à travers des campagnes baptisées « Clean UpYour Street » et « Clean Up Your Country » (« Nettoyer vos rues » et « Nettoyez votre pays »). Ces actions simples et pratiques ont toutes contribué à la vulgarisation des objectifs du mouvement KMARA et en ont fait un nom de marque en très peu de temps[1].
Plus près de nous, les activistes égyptiens ont aussi utilisé cette méthode pour s’attirer la sympathie du peuple et donner une image positive de leur mouvement.
Ceux qui connaissent l’Égypte (et Le Caire en particulier) savent que le maintien de la propreté des rues est le pire échec des gouvernements successifs de ce pays. Une jeunesse qui nettoie les rues est non seulement le symbole d’un gouvernement incompétent mais surtout le rêve d’un avenir propre, sain et rayonnant de bonheur.
C’est un peu le cas de l’Algérie où la propreté des villes laisse à désirer, c’est le moins qu’on puisse dire.
[1]Kandelaki, G. and G. Meladze, « Enough! Kmara and the Rose Revolution in Georgia ». In Joerg Forbrig and PavolDemeš (Eds.), Reclaiming Democracy. Civil society and Electoral Change in Central and Eastern Europe. Pp. 101- 125. Washington DC (2007), http://georgica.tsu.edu.ge/files/01-Politics/Rose%20revolution/Kandelaki&Meladze-d.u.pdf

De la fraternisation avec l’« ennemi » dans les révoltes non-violentes
Dans le vocabulaire de CANVAS, la non-violence a pour ennemi les institutions qui sont censées utiliser la violence dans les régimes autocratiques, en l’occurrence la police et l’armée. Pour SjrdaPopovic, il est crucial pour les manifestants de ne pas apparaître menaçants et agressifs envers les piliers de la force que sont la police et les militaires : « Dès le début, nous avons agi avec beaucoup de fraternisation envers la police et l’armée, en leur apportant des fleurs et des gâteaux, plutôt que de crier ou de jeter des pierres. Ce modèle a fonctionné efficacement dans le monde entier, notamment en Géorgie et en Ukraine. Une fois que vous comprenez que²les policiers ne sont que des hommes en uniforme de police², votre perception change et la persuasion opère. »[1]
Comme précisé par Popovic, cette façon de sympathiser avec les détenteurs de la force est très efficace et conforme aux principes de la lutte non-violente. Voici quelques exemples en relation avec la distribution de fleurs.
Les révolutions colorées
[1]Bryan Farrell et Eric Stoner, « How We Brought Down a Dictator », Op. Cit.
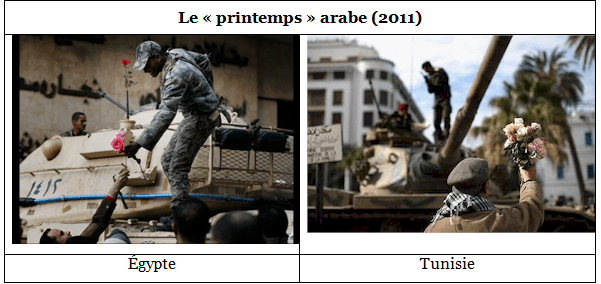


De l’humour dans les révoltes non-violentes
Une des caractéristiques les plus remarquées lors des manifestations algériennes est certainement celle de l’humour. Les pancartes, les slogans et les accoutrementstémoignent d’une créativité sans bornes et d’un sens aiguisé de l’humour.
Cependant ce trait de caractère n’est pas propre à l’Algérie : il fait partie intégrante des méthodes de revendication utilisées dans la lutte non-violente.
SjrdaPopovic considère que l’humour est outil très puissant : « L’humour fait vraiment mal parce que ces gars-là se prennent au sérieux. Quand vous commencez à vous moquer d’eux, ça fait mal. »[1]
Selon le directeur de CANVAS, « [La créativité et l’humour sont]absolument cruciaux. L’humour et la satire, marques de fabrique d’Otpor, ont réussi à faire passer un message positif, à attirer le plus large public possible et à donner à nos adversaires – ces bureaucrates à la tête grise et carrée – un air bête et ridicule. Plus important encore, il a brisé la peur et inspiré la société serbe épuisée, déçue et apathique de la fin des années 90. »[2]
[1]TEDxKrakow, « Srdja Popovic – How to topple a dictator », Op. Cit.
[2]Bryan Farrell et Eric Stoner, « How We Brought Down a Dictator », Op. Cit.



Cet humour a été aussi visibles dans les pays arabes qui ont connu des mouvements de contestation. Voici quelques exemples d’Égypte.
Un autre humour, plus noir celui-ci, porte le numéro 44 et est intitulé « Simulacre de funérailles » dans le manuel de CANVAS. Il a été utilisé en Algérie le 1er mars 2019 pour simuler les funérailles du président Bouteflika drapé dans un drapeau marocain :
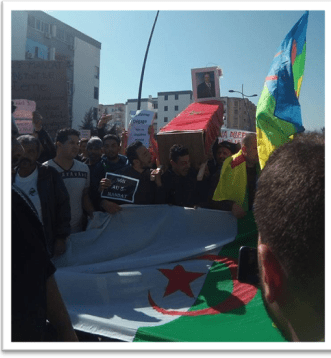
L’analyse des différentes actions menées lors des manifestations de la rue algérienne montre que d’autres points de la liste des « 199 méthodes d’action non-violente » de CANVAS ont été utilisés sur le terrain. Il serait cependant fastidieux de les énumérer tous dans ce travail.
Du financement récent de la NED
Après les retentissantes révélations des financements octroyés aux activistes arabes par la NED et les autres organismes d’« exportation » de la démocratie lors du « printemps » arabe, on aurait pensé que ces « banquiers de la révolte » cessent leurs activités ou, du moins, deviennent plus discrets. Il n’en est rien.
Le dernier rapport annuel de la NED, relatif à l’année 2018 et concernant l’Algérie, montre que 3 organismes algériens ont été financés (voir le tableau suivant).
Financement NED 2018 (Algérie) Organisme Montant ($) Center for International Private Enterprise (CIPE) 234 669 Fédération Euro-Méditerranéenne Contre les Disparitions Forcées 30 000 Association Djazairouna 26 000 Sur le site officiel du CIPE[1], on peut lire :
« Le CIPE est l’un des quatre instituts principaux du National Endowment for Democracy et une filiale de la US Chamber of Commerce.[…]Au CIPE, nous pensons que la démocratie est à son apogée lorsque le secteur privé est en plein essor. En collaborant avec nos partenaires locaux, dont des associations professionnelles, des chambres de commerce, des groupes de réflexion, des universités et des organisations de défense des droits, le CIPE contribue à créer un environnement favorable à la prospérité des entreprises. Cela ne peut se produire que lorsque les institutions fondamentales de la démocratie sont fortes et transparentes. Nous sommes là pour aider à construire ces institutions. C’est notre mission. C’est notre force. »
Ainsi, on voit bien que le CIPE est aussi un organisme dont la mission est d’« exporter la démocratie ».
En Algérie, le CIPE est en relation avec le think tank CARE (Cercle d’Action et de Réflexion autour de l’Entreprise) :
« En Algérie, cette organisation locale est le partenaire de longue date de CIPE, CARE (le cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise), une association d’entreprises et think tank algériens. Ces consultations ont révélé que, contrairement à de nombreux pays où CIPE travaille, le consensus sur les problèmes en Algérie était proche de 100%. »[2]
La « Fédération Euro-Méditerranéenne Contre les Disparitions Forcées » (FEMED) est une organisation internationale domiciliées en France. Elle regroupe 26 associations issues de 12 pays différents. En Algérie, les associations affiliées sont le CFDA, « SOS Disparus », Djazaïrouna et Somoud[3].
La présidente de la FEMED est NasseraDutour, la fondatrice et (actuellement) porte-parole du CFDA.
Il est inutile de rappeler que le CFDA et « SOS Disparus » ont été des membres actifs du CNCD en 2011.
Tout récemment, en marge de la révolte populaire algérienne, un collectif d’organisations a vu le jour sous le nom de « Collectif de la société civile algérienne pour une sortie de crise pacifique ». Parmi les membres de ce regroupement, on trouve : la LADDH, le RAJ, Djazaïrouna, Somoud, « SOS Disparus » et le SNAPAP[4].
Toutes ces organisations ont (ou ont eu) un lien avec la NED.
Du rôle du cyberespace dans les révoltes non-violentes
Il va sans dire que c’est l’espace réel qui est le théâtre des manifestations et que c’est dans cet espace que se gagnent les batailles contre le pouvoir en place. Voici ce que dit SjrdaPopovic à ce sujet : « La lutte non-violente se gagne dans le monde réel, dans les rues. Vous ne changerez jamais votre société vers la démocratie si vous vous asseyez et cliquez »[5].
Néanmoins, l’utilisation du cyberespace, cet espace éthéré et libéré, a permis de coordonner les efforts, d’organiser les actions à mener sur le terrain, de partager les informations et de transmettre les instructions pour que les manifestations soient conformes aux principes de base de la lutte non-violente comme expliqué précédemment.
En outre, les campagnes positive et négatives décrites auparavant ont eu lieu sur Internet, via les réseaux sociaux. À vrai dire, les actions de ce type lancées dans le cyberespace ont été plus virulentes et plus nombreuses que celles dans l’espace réel. En effet, le cyberespace ne dort pas et fait abstraction des notions de temps et de géographie. Les vidéos, les chansons, les parodies de chansons, les sketchs et les clips détournés ont été (et sont toujours) très efficaces.
À cet effet, il est important de préciser que certaines vidéos n’avaient rien d’un travail amateur. Bien au contraire, elles ont été réalisées par des professionnels et ont certainement demandé un support matériel et financier.
En ce concerne les instructions données aux manifestants pour se conformer aux exigences de la lutte non-violente sur le terrain, des vidéos ont été distribuées sur Internet. Par exemple, celle qui a circulé pour la préparation de la manifestation du 1er mars 2019et intitulée« Quelques recommandations pour la marche de demain 01/03/2019…partagez mes frères »[6], donne 16 instructions. Parmi elles :
- Il est interdit d’insulter ou d’injurier
- Il faut éviter les slogans religieux / racistes / régionaux
- Toutes les formes de violence ou de vandalisme sont interdites
- Il est totalement interdit de porter des cagoules
- Toute personne doit avoir le drapeau national
- Utilisez le téléphone dans le sens de la largeur pour réaliser des vidéos de 1 à 2 minutes de la marche et envoyez-les aux pages
- Apportez des bouteilles d’eau potable + du vinaigre[7] en cas d’utilisation des gaz lacrymogènes
- Nettoyez les rues après la fin des marches
- N’oubliez pas de télécharger l’application VPN pour éviter les coupures d’Internet
Il est intéressant de noter que le début et la fin de la vidéo sont ponctués de termes qui attestent de l’appartenance à un groupe : « nos buts », « notre cause », etc.
Finalement, la vidéo se termine par une signature : le poing d’Otpor « algérianisé ».
[1]Center for International Private Enterprise (CIPE), https://www.cipe.org/
[2] CIPE, « Algeria », https://www.cipe.org/projects/algeria/
[3]FEMED, « Associations algériennes membres de la FEMED », https://www.disparitions-euromed.org/fr/content/les-associations-alg%C3%A9riennes-membres-de-la-femed
[4]El Watan, « Collectif de la société civile algérienne pour une sortie de crise pacifique : Feuille de route pour l’instauration de la nouvelle République », 20 mars 2019, https://www.elwatan.com/edition/actualite/collectif-de-la-societe-civile-algerienne-pour-une-sortie-de-crise-pacifique-feuille-de-route-pour-linstauration-de-la-nouvelle-republique-20-03-2019
[5]TEDxKrakow, « Srdja Popovic – How to topple a dictator », Op. Cit.
[6]YouTube, « Quelques recommandations pour la marche de demain 01/03/2019…partagez mes frères », mise en ligne le 28 février 2019, https://www.youtube.com/watch?v=csqyMPGIOKs
[7]Remarque : la 7e directive concernant le vinaigre pour se protéger des gaz lacrymogènes avait été une recommandation des cyberactivistes tunisiens aux cyberactivistes égyptiens comme le rapportent Kirkpatrick et Sanger, Op. Cit.

D’ailleurs, ce poing a été utilisé dans les appels aux manifestations (tout comme en 2011) et dans les affiches et banderoles :
Cette vidéo n’est pas sans rappeler les directives similaires du « Mouvement du 6 avril »transmises via Internet ou distribuées aux manifestants sur la place Tahrir dont voici quelques exemples :
Quelques directives mises à la disposition des manifestants égyptiens (2011) 

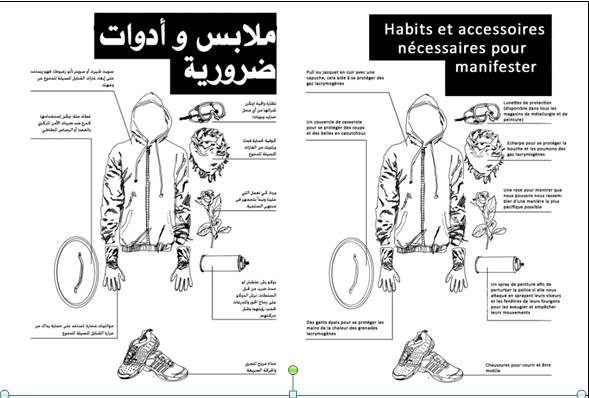
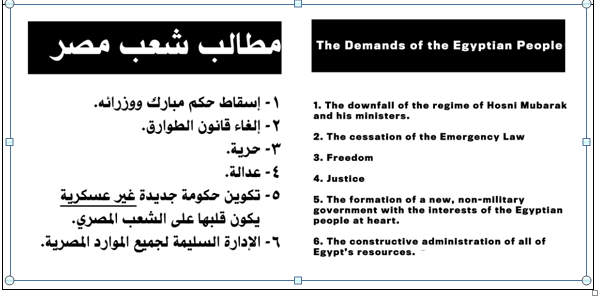
De la pérennité politique des cyberactivistes après la « révolution »
Autant la méthode de la lutte non-violente est d’une efficacité redoutable dans la destitution des autocrates, autant elle n’a aucune incidence sur la période qui s’en suit.
Dans un article sur les révolutions colorées écrit en 2007 par le journaliste Hernando Calvo Ospina dans les colonnes du Monde diplomatique, on peut lire : « Dans ces pays du « socialisme réel », la distance entre gouvernants et gouvernés facilite la tâche de la NED et de son réseau d’organisations, qui fabriquent des milliers de « dissidents » grâce aux dollars et à la publicité. Une fois le changement obtenu, la plupart d’entre eux, ainsi que leurs organisations en tout genre, disparaissent sans gloire de la circulation »[1].
Tout comme leurs « confrères » qui ont mené les révolutions colorées, les cyberactivistes arabes ont disparu de la scène politique. Leur rapide évanescence est due au fait que ces dissidents n’ont aucune « compétence » (et donc aucune utilité) dans les événements qui suivent la chute des régimes en place. Il faut comprendre que la formation des dissidents par les organismes américains d’« exportation » de la démocratie est exclusivement centrée sur l’étêtement des régimes et non sur l’action politique qui en résulte.
En Tunisie, le cyberactiviste Slim Amamou a été nommé secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports trois jours après la fuite du président Ben Ali, dans le premier gouvernement Ghannouchi[2] post-bénalien. Comme ce gouvernement comportait encore de nombreux anciens ministres su président déchu, on lui a reproché d’être un vendu[3]. Il a été fustigé sur Internet pour ne pas avoir démissionné du gouvernement comme l’ont fait d’autres membres.
En Égypte, Ahmed Maher (cofondateur du « Mouvement du 6 avril ») et Mohamed Adel ont été emprisonnés en décembre 2013 pour avoir violé une loi anti-manifestation promulguée le mois précédent[4]. En mars 2014, ils comparurent devant la cour pour faire appel de la sentence de trois ans de prison tout en accusant leurs geôliers de les avoir battus et maltraités[5]. Mais en vain : la peine infligée aux deux leaders du « Mouvement du 6 avril » a été confirmée le mois suivant[6]. Toujours sur les rives du Nil, le cyberdissident Alaa Abdelfattah vient d’être libéré après 5 ans de prison[7].
La figure de proue de la contestation yéménite, Tawakkol Karman[8], coule des jours paisibles en Turquie alors que son pays est à feu et à sang. Il faut juste préciser que son Prix Nobel n’était certainement pas étranger à son obtention de la nationalité turque.
[1] Hernando Calvo Ospina, « Quand une respectable fondation prend le relai de la CIA », Le Monde diplomatique, juillet 2007
[2]Mohamed Ghannouchi était premier ministre du gouvernement tunisien sous la présidence de Ben Ali.
[3]Lea-Lisa Westerhoff, « Slim Amamou : Ministre gazouilleur », Écrans, 10 février 2011, http://www.ecrans.fr/Ministre-gazouilleur,11973.html
[4]Laura King et Amro Hassan, « 3 prominent Egyptian activists say they have been abused in prison », Los Angeles Times, 10 mars 2014, http://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-egypt-activists-abuse-20140310-story.html#axzz2vne85KIB
[5]Ibid.
[6]AFP, « En Égypte, peines de prison confirmées pour plusieurs figures de la révolte de 2011 », Libération, 7 avril 2014, http://www.liberation.fr/monde/2014/04/07/en-egypte-peines-de-prison-confirmees-pour-plusieurs-figures-de-la-revolte-de-2011_993736
[7]Egypt Today, « Activist Alaa Abdel Fattah released after 5 years in prison », 29 mars 2019, https://www.egypttoday.com/Article/2/67644/Activist-Alaa-Abdel-Fattah-released-after-5-years-in-prison
[8]Pour plus de détails, lire Ahmed Bensaada, « Arabesque$ – Enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes », Ed. Investig’Action, Bruxelles (Belgique), 2015 – Ed. ANEP, Alger (Algérie), 2016, pp. 132-14
En Syrie, un des activistes les plus visibles dans les médias occidentaux était RadwanZiadeh[1]. Membre du Conseil National Syrien (CNS) et financé par la NED, ce dissident syrien a failli être expulsé des États-Unis (où il vit) car sa demande d’asile avait été refusée en 2017[2].
[1]Ibid, pp. 148-158
[2]The Washington Post, « Syrian activist was State Dept. ally; now US won’t grant him asylum », 2 juillet 2017, https://www.recordonline.com/opinion/20170702/syrian-activist-was-state-dept-ally-now-us-wont-grant-him-asylum

L’analyse des événements qui ont suivi aussi bien les révolutions colorées que le « printemps » arabe montrent de manière très claire que l’idéologie de résistance individuelle non-violente développée par Gene Sharp n’est efficace — lorsqu’elle fonctionne — que dans le renversement des autocrates. Par contre, cette idéologie montre une grande faiblesse dans la mesure où elle ne répond en aucun cas à la situation de chaos qui suit ce type de bouleversement politique. Dès que le rôle attribué aux activistes s’achève, ce sont les forces politiques en place, à l’affût de tout changement majeur, qui occupent le vide créé par la disparition de l’ancien pouvoir.
Alors que la révolte tunisienne était qualifiée de jeune, dynamique et « facebookienne », le président actuel de la Tunisie est, à plus de 92 ans, le plus vieux président du monde.
En Égypte, le gouvernement de type militaire a restreint les libertés individuelles beaucoup plus que du temps du président Moubarak.
Le Yémen, la Libye et la Syrie sont des pays détruits et leurs citoyens vivent qui l’insécurité, qui la famine qui l’exil.
Faut-il pour autant dire que les manifestations algériennes vont nous mener aux chaos ? Qu’elles n’étaient pas justifiées ? Que la jeunesse n’a pas raison de déboulonner les autocrates qui ont figé le pays dans une léthargie morbide ?
Bien sûr que non. Sauf que l’histoire montre que les révoltes non-violentes ne donnent pas les résultats escomptés car elles servent des agendas (intérieurs ou extérieurs) autre que celui du pays. Il est donc très important de faire en sorte que cette contestation populaire soit fondamentalement intrinsèque et ne servent que l’Algérie et uniquement l’Algérie.
- De l’élection à la mode du « like »
Dès le début des manifestations, les noms de personnes susceptibles de « guider le destin du pays » ont inondé le cyberespace. Les uns avançaient un pion, les autres un autre comme s’il s’agissait de voter pour un candidat de téléréalité. Aucun programme présenté, aucune vision expliquée ni aucun embryon d’agenda politique. Les messages, les photos et les vidéos partagés à satiété (probablement par des trolls cyberactivistes), propulsent certaines personnes au statut suprême de sauveur de la nation.
Et pourquoi ne pas proposerun gouvernement clés en main pendant qu’on y est ? C’est ce qui a été avancé par le Comité d’initiatives et de vigilance citoyennes(CIVIC) dans le journal El Watan tout en parachutant le directeur dudit journal au poste de Ministre de la liberté d’expression [1]! Un nouveau ministère taillé sur mesure, n’est-ce pas ? Quand on connaît l’engagement de ce journal pour la « printanisation » des pays arabes, il y a de quoi se demander ce que deviendra l’expression même de la liberté.
Sur cette même liste apparaît un nom porté aux nues par tous les bons génies du cyberespace : M. Mustapha Bouchachi. Inconnu du grand public il y a quelques semaines à peine, le voilà catapulté aux plus hautes fonctions d’un état en devenir.
Il faut savoir que M. Bouchachi a été président de la LADDH de 2007 à 2012 et que les rapports de NED montrent que cette ligue a été financée pendant sa présidence.
D’autre part, son prédécesseur à la tête de la LADDH, M. Hocine Zahouane, l’a accusé d’être en relation avec le Département d’État américain : [2]
« M.Bouchachi a été convoqué par le département américain des affairesétrangères pour faire un voyage en Turquie et à Oman afin d’assister auxexplications fournies par Condoleezza Rice et Saoud Al Fayçal sur lapolitique américaine sur le Grand Moyen-Orient. »[3]
Dans ce gouvernement fictif, le portefeuille de la Culture et des Arts revient à nul autre que l’écrivain Kamel Daoud. Celui-là même qui avait traité ses compatriotes de « violeurs en puissance » dans l’affaire de Cologne et qui s’était posé la question « En quoi les musulmans sont-ils utiles à l’humanité ?»[4] ne cesse d’encenser les manifestants en mettant en exergue leur politesse, leur ordre, leur sens écologique, le respect des autres et, surtout, l’inexistence de harcèlement sexuel lors des manifestations[5]. N’avait-il pas affirmé que « le monde dit « arabe » est le poids mort du reste de l’humanité » ? Et de quelle culture va-t-il être le défenseur et le promoteur ? Celle qu’il dénigrait naguère ?
Ces trois personnes mentionnées précédemment ne sont évidemment pas les seules dont les noms et les vidéos sillonnent le cyberespace, bien au contraire. D’anciens membres du CNCDainsi quede notoires islamistes sont sortis de leur hibernation politique, surfant sur la vague de la contestation et se trémoussant sur les flonflons des « Irhal » et « Dégage ».
Les médias sociaux nous ont aussi inondé de « candidatures »étonnantes comme celles d’animateurs de talk-shows ou des commentateurs sportifs comme si la capacité à gérer un pays se mesurait avec la vigueur des onomatopées émises lorsqu’un but est marqué.
Alors que l’Algérie vit des moments critiques, cette course aux fauteuils et ce retournement de veste conjoncturel est bassement indécent.On ne peut pas critiquer un système électoral basé sur la « chkara »[6] et le remplacer par un autre basé sur le « like ».
Conclusion
Les manifestations pacifiques qui ont secoué notre pays et qui ont ébranlé le « système » délétère qui le gouvernait ont montré un visage très positif de notre jeunesse. Réussir à « dégager » un pouvoir politique moribond dans la joie et la bonne humeur, sans aucun incident notable,est non seulement exemplaire, mais aussi salutaire pour l’avenir de l’Algérie.
Cependant, le modus operandi de ces manifestations conforme aux principes fondamentaux de la lutte non-violente de CANVAS montre que 19 ans après la Serbie et 8 ans après le début du « printemps » arabe, l’Algérie connait à son tour une révolution colorée. Ce mode opératoire témoigne ainside l’existence d’un groupe de cyberactivistes formé par des officines d’« exportation de la démocratie » et actif aussi bien dans l’espace que dans le cyberespace.
Et la seule réponse à cette affiche :
[1]Nazef Ali , « Amendement et mise en œuvre de l’appel du CIVIC », El Watan, 27 mars 2019, https://www.elwatan.com/edition/contributions/amendement-et-mise-en-oeuvre-de-lappel-du-civic-27-03-2019
[3] Tahar Fattani, « Zehouane s’en prend au FFS l’accusant d’instrumaliser les droits de l’homme », L’expression, le 21 mars 2010, https://www.djazairess.com/fr/lexpression/74347
[4] Pour plus de détails, lire Ahmed Bensaada, « Kamel Daoud, Cologne contre-enquête », Ed. Frantz Fanon, Alger, 2016
[5] France Inter, « Kamel Daoud livre son analyse des manifestations en Algérie et sur le régime Bouteflika », 8 mars 2019, https://www.youtube.com/watch?v=KDBaCmlwxk4
[6]Étymologiquement « le sac ». Ce terme réfère à la corruption.

est le célèbre tableau de Magritte:

Ce groupe, ainsi que certaines ONG algériennes, doivent comprendre que le fait d’œuvrer pour des intérêts autres que ceux de son pays ne peut mener qu’au chaos et les exemples sont nombreux.
Lorsqu’en 2000, on demanda à un jeune militant serbe d’Otpor son avis sur les États-Unis — qui avaient aidé et formé le mouvement —, il répondit qu’il était contre ce pays, mais que ça ne le gênait pas trop d’être partiellement contrôlé par la CIA[1].Ce point de vue diffère légèrement de celui de Slim Amamou qui, lui aussi, avait reconnu avoir été aidé par les Américains mais qu’il « se foutait complètement » de la CIA[2].
Quelle naïveté !Les financements octroyés par ces organismes « démocratisants » n’ont rien de philanthropiques, mais profitent aux pays donateurs.Une fois que les gens acceptent l’argent, ils acceptent aussi les conditions qui l’accompagnent.
Selon plusieurs observateurs, ces intérêts pour lesquels travaillent les cyberactivistes peuvent être aussi bien intérieurs qu’extérieurs (ou une combinaison des deux). Dans tous les cas, l’intérêt de notre pays doit être placé au-dessus de toute autre considération.
L’analyse des « révolutions » non-violentes dans les autres pays indique que la phase qui suit celle de la chute du pouvoir est beaucoup plus cruciale que la précédente. C’est d’elle que dépend la réussite ou l’échec d’une révolte. L’arrogance, l’entêtement et l’obstination sont de très mauvais conseillers dans cette période.
Faisons en sorte que ce soulèvement populaire soit un vif succès, pour qu’une Algérie nouvelle apparaisse. Une Algérie pleine de promesses pour un peuple qui a tant espéré.
Montréal, le 4 avril 2019
Source : https://bouhamidimohamed.over-blog.com/2019/04/huit-ans-apres-la-printanisation-de-l-algerie.html
-
Amel Boulahia-Les graines du figuier sauvage, 2024 (Sur un film iranien)

Une Critique sagace du point de vue dérobé du réalisateur et de ses producteurs. Donc un film iranien par la nationalité de l'auteur et mainstream par ses financiers ?
Les graines du figuier sauvage, 2024, par Amel Boulahia
Dans le contexte des manifestations consécutives à la mort de Mahsa Amini, arrêtée en septembre 2022 à Téhéran pour port de vêtements inappropriés, le conflit idéologique entre les autorités et les rebelles est illustré au sein d’une petite famille, le père vient d’être promu à un poste important au tribunal, il se trouve donc contraint à participer aux arrestations, ses filles sont du côté des manifestants tandis que la mère essaye de joindre les deux camps.
Tel un Ficus Religiosa, le conflit se résout par le développement de la graine en figuier, avec des racines aériennes qui s’épaississent jusqu’à étrangler l’arbre hôte et s’ériger en nouvel arbre libre de son socle. Seule la vieille main de la répression reste suspendue, inerte à côté de son arme.
Sous d’autres circonstances, ce film m’aurait peut-être plu, étant moi-même fortement opposée à l’uniformisation vestimentaire, toutefois son caractère unidimensionnel en fait une vulgaire propagande. Exagérer la répression de l’Iran vis-à-vis du peuple et occulter sa politique étrangère et régionale, c’est clairement faire pencher la balance contre l’une des Résistances les plus performantes encore debout au Moyen-Orient.
Enfin, il n’y a rien à espérer d’un film Iranien co-produit avec des sociétés occidentales dont Arte, le réalisateur ainsi que les actrices sont applaudis, présentés comme des héros pour avoir osé dénoncer les « injustices du régime »…dommage que des films pareils soient autorisés dans nos salles de cinéma dans le cadre du festival du film européen…vraiment dommage !
Amel Boulahia
-
الطاهر المعز-نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني


نماذج من التواطؤ مع الكيان الصهيوني : الطاهر المعز
تواطؤ الأمم المتحدة في الإبادة الجماعية الفلسطينية في غزة
لا يمكن أن تحدث فظائع مثل المجزرة المستمرة في فلسطين، وخصوصًا في غزة، منذ تشرين الأول/اكتوبر 2023 والضّفّة الغربية، بدون دعم القوى الإمبريالية العظمى، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي كان مُبرّر إنشائها: الوقاية من مثل هذه الجرائم.
نَشَرَ معهد جينوسبكترا (Genospectra Institute ) لائحة اتهام تاريخية مكونة من 60 صفحة ضد مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية (OSAPG) ، متهماً هذا المكتب بالتواطؤ في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وصَدَرت الوثيقة بعنوان « إثبات الإبادة الجماعية وإنكار العدالة: التواطؤ المؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة في محو فلسطين »، تكشف عن صمت المؤسسة لمدة 17 شهرًا، ورفضها تنفيذ 14 علامة حمراء أصدرتها، وفشلها في تسمية الجريمة، حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير 2024 » إن تصرفات إسرائيل في غزة تشكل جريمة إبادة جماعية ».
يتعرض أكثر من سبعمائة ألف فلسطيني إلى خطر الموت المباشر وأكثر من 140 ألفاً للعنف المباشر وأكثر من 561 ألفاً من الجوع والحرمان وانهيار المنظومة الصّحّيّة وفقاً لتقديرات تستند إلى نسب الوفيات الزائدة بنحو 4 إلى 1 ونماذج العد والمقارنة المنشورة في المجلة الطبية » لانسيت »، وقد تم استيفاء جميع معايير الأمم المتحدة الأربعة عشر لخطر الإبادة الجماعية في غزة وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وظل مكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية صامتًا لمدة 13 شهراً بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية، ولم يُصْدِرْ سوى بيان غامض ومخفف لم يتضمن أي ذكر لمصطلحات « الإبادة الجماعية » أو « إسرائيل » أو « فلسطين »، وتجاهل المكتب خطاب الكراهية، ورفض تسمية الفصل العنصري أو الاستعمار في قطاع غزة، وطبق آلياته الوقائية بشكل انتقائي، اعتمادًا على الملاءمة السياسية والضغوط الدولية…
إن الإعلانات الدولية، عندما تصدر، تكون مليئة بالنوايا الحسنة لأنها تعلم أنها لن تخدم أي غرض على الإطلاق، ويؤكد معهد جينوسبكتر « هذا ليس خطأً إجرائيًا، بل هو خيانة… تم تحذير أعضاء المكتب فظلّوا صامتين وقلّلوا من شأن الإبادة الجماعية »
تواطؤ السلطات « الغربية »
لمّا أمرت محكمة العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية في غزة، قطعت القوى الغربية التمويل عن منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا ) حتى يمكن تنفيذ الإبادة الجماعية في أسرع وقت ممكن، وبدون شهود، واعتمدت هذه الدّول الإمبريالية على زعم صهيوني – بدون إثبات – إن 12 مسؤولا من أونروا شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، كما سارعت بعض الدول الأخرى إلى قطع تمويل المساعدات للفلسطينيين، مما يُمثّل شكلًا من العقاب الجماعي الذي يجعل الفلسطينيين في وضع أكثر فظاعة في سياق الإبادة الجماعية، كما تقول فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنتقد ألبانيزي الدول التي اتخذت إجراءات انتقامية ضد الأونروا وتتهمها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية: « في اليوم التالي لقرار محكمة العدل الدولية باحتمال ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يشكل معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في اللحظة الأكثر حرجا، ومن المرجح جدا أن يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأصدر المفوض العام للأمم المتحدة فيليب لازاريني بيانا بشأن تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). « أنا مصدوم من أن مثل هذه القرارات تُتخذ بناءً على سلوك مزعوم لعدد قليل من الأفراد، بينما تستمر الحرب، وتزداد الاحتياجات سوءًا، ويواجه الناس خطر الموت جوعًا. »
نفذت عدة دول غربية الأوامر الأمريكية، وانضمّت إلى القوى المناهضة للشعب الفلسطيني ولمنظمة إغاثة وتشغيل اللجئين ( أونروا ) وقطعت التمويل عن المنظمة التي نفى مديرها، كما نفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الاتهامات الصّهيونية. « إن هذه الادعاءات الكاذبة ضارة وقد تعرض موظفينا للخطر، حيث يخاطرون بحياتهم لمساعدة الأشخاص الضعفاء في ظل ازدياد حاجة الفلسطينيين إلى الإمدادات الحيوية »، وقطعت عدة دول غربية التمويل وخفضت عدة دول أخرى حصتها في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، بعد اتخاذ الولايات المتحدة وكندا زمام المبادرة، وتلتها على الفور فنلندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا، وذلك في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، ونسّقت هذه الدّول دعايتها ضد أنروا ( وضدّ الشعب الفلسطيني) مع الآلة الدّعائية الصهيونية والأمريكية التي أدْرجت المنظمات الإنسانية على القائمة السوداء بهدف فرض المزيد من المعاناة على الفلسطينيين، وفي مقدّمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي كانت منذ سنوات هدفًا للتشهير ثم للقصف الصهيوني منذ بداية الإبادة الجماعية…
أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: « إن إسرائيل فرضت قيودا على برامج الوكالة في غزة وشددت القيود، وخاصة على دخول المساعدات إلى شمال القطاع… أصبح من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة، ولم تصل سوى كميات صغيرة للغاية من الغذاء والمساعدات إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة » ولم تتمكن المنظمات الإنسانية و برنامج الغذاء العالمي من تقدجيم المساعدة إلى سكان شمال غزة منذ يوم الثالث عشر من كانون الثاني/يناير 2024 بسبب » القيود المنهجية على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الغذاء العالمي، حيث لا يقوم الجيش الإسرائيلي بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة فحسب، بل يقوم أيضًا بقتل العشرات من الأشخاص الذين يحاولون الحصول على القليل من المساعدات التي تصل، وبالتالي يكمل عملية الإبادة الجماعية… »
تواطؤ مصر في حصار غزة
كانت هناك ثمانية معابر – ستة منها تحت السيطرة الكاملة للكيان الصّهيوني وتربط غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، فيما ظلت أربعة من هذه المعابر مغلقة تمامًا، وكان اثنان مفتوحين بشكل متقطع: « بيت حانون » و »كرم أبو سالم »، ومنذ الانسحاب العسكري من غزة، سنة 2005، وقّع الإحتلال ثلاث اتفاقيات لتنظيم الحركة على المعابر، ومن ضمنها اتفاقية مع السلطة الفلسطينية (2005)، و « بروتوكول فيلادلفيا » مع مصر الذي نَصَّ على إنشاء شريط أمني بطول 14 كيلومترا بين مصر وغزة، ويتطلب التنسيق الأمني مع مصر، ووجود حرس حدود مصري على طول الممر، ودوريات أمنية من الجانبين، وبقي معبر رفح يُجسّد شريان الحياة الوحيد للفلسطينيين في غزة، وبذلك استبدل الكيان الصهيوني الإحتلال العسكري بفرض الهيمنة الكاملة على غزة براً وجواً وبحراً، وكان معبر رفح مقصورا على حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، مع استثناءات تتطلب إخطارا مسبقا للحكومة الصّهيونية وموافقة من الهيئة العامة للمعابر بغزة، التابعة للسلطة الفلسطينية، التي تقوم بمعالجة الموافقات والاعتراضات ضمن الإطار الزمني الصارم الذي حددته اتفاقية المعابر، لكن ارتفعت حدّة التَّوَتُّرات عندما فازت حماس في انتخابات 2006، وسيطرت على المعبر من الجانب الفلسطيني سنة 2007 فأصبح الكيان الصهيوني يأمر بإغلاق المعبر باستمرار، دون أي اعتراض للسلطات المصرية التي كانت بمثابة الوكيل للكيان الصّهيوني، وظل المعبر مغلقًا بشكل شبه كامل منذ سنة 2017، لكن عَبَرت منه قبل العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 بعض السلع الأساسية مثل الوقود وبعض الأدوية ومواد البناء- بكميات محدودة – ونحو 140 ألف شخص ( حوالي 20% من طلبات الخروج والدّخول ) خلال 245 يومًا، سنة 2022، وشن الكيان الصهيوني عدوانًا عسكريًّا يوم الثامن تشرين الأول/اكتوبر 2023، وفَرَضَ حصاراً قاسياً على الفلسطينيين في القطاع، فقضى على إمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء والاتصالات، فضلاً عن نقاط العبور الأساسية، لأن الحصار أصبح شاملاً فمات الناس من الجوع والمَرض والبرد، فضلا عن القنابل والأسلحة المُحرّمة…
قبل العدوان الأخير والمُستمر، كانت هناك ثلاثة طرق للخروج من غزة. وكان المسار الرسمي يتضمن تقديم قوائم الأسماء لموافقة الإحتلال، وتستغرق هذه العملية عدة أشهر، وواجه المقبولون عقبات إضافية على الجانب المصري، بما في ذلك عمليات التفتيش والنقل إلى مطار القاهرة في « قافلة الترحيل »، ويتمثل الطريق الثاني – غير الرسمي – الذي تديره مكاتب وسيطة، في توفير مرور أسرع مقابل رسوم تتراوح بين 300 و 500 دولار، أو حتى 10 آلاف دولار، أما الطريق الثالث، المرتبط بالاستخبارات المصرية، فيتم التعامل معه حصرياً من خلال « وكالة هلا للسفر »، المرتبطة برجل الأعمال وزعيم المليشيا إبراهيم العرجاني، من شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة، ويسمح هذا المسار، منذ سنة 2021، بالعبور السريع والإعفاء من التفتيش وإمكانية بقاء المسافرين في مصر قبل الذهاب إلى المطار، بتكلفة تتراوح بين 500 إلى 700 دولار للشخص الواحد، مما يجعل مصر تستفيد من الحصار، وزادت الفوائد منذ الحصار الشامل والإبادة، حيث منعت دولة الاحتلال بشكل نهائي مغادرة الأشخاص غير المدرجين في القوائم المعتمدة، باستثناء حاملي الجنسية المزدوجة، وذلك بعد تدخلات السفارات الأجنبية، لكن بعض ضباط الحدود المصريين استغلوا ثغرة أمنية معروفة باسم « الاستبعاد الأمني »، ويتضمن ذلك منع المسافر من المغادرة بحجة ارتباطه بالمنظمات الفلسطينية ( بذريعة العلاقة بحماس)، ولكن بعض الأشخاص يتمكّنون من الخروج مقابل مبالغ كبيرة.
تواطؤ شبكات الإعلام
تتحمل شبكات الإعلام الكبرى أيضًا المسؤولية عن الإبادة الجماعية الصّهيونية في غزة، ودافع صحافيو قناتي CNN وBBC، على سبيل المثال، وهما من أكبر القنوات الإخبارية في العالم، عن العدوان، متجاهلين الحقائق والوقائع المُوثَّقَة، وأوضحت التغطية الإعلامية للأحداث مرة أخرى دعم وسائل الإعلام الغربية السائدة للجرائم الصهيونية، وكشف عشرة صحافيين قاموا بتغطية العدوان لصالح شبكتي CNN وBBC عن أمثلة محددة للتحيز ولتطبيق المعايير المزدوجة والتلاعب بالمعلومات لتقليل الفظائع الصّهيونية، وأظْهر شريط بعنوان « الفشل في غزّة من خلال عدسة الإعلام الغربي » (The Failure of Gaza: Through the Lens of the Western Media ) كيف يأمر رؤساء التحرير الصحافيين ببث أخبار زائفة تتماشى مع الرواية الصهيونية والإمبريالية، رغم تحذيرات المراسلين على عين المكان، وعلى سبيل المثال، بثّت شبكة سي إن إن الأمريكية اتهامًا صهيونيا كاذبا لحماس ويدّعي الخبر الكاذب « إخفاء الأسرى الصهاينة في المستشفيات »، وأصرّت إدارة الشبكة على نَشْرِ هذه التهمة الكاذبة، متجاهلة تحذيرات الصحافيين، كما تُمارس معظم – إن لم تكن كافة – الشبكات الإعلامية « الغربية » الرقابة وتجاهل الضحايا الفلسطينيين، من خلال الطريقة التي يتم بها الإبلاغ عن العدوان الصهيوني، إذْ يُمْنَعُ وصف الغارات الجوية بـ »الهجمات » أو « العدوان »، فضلا عن إخفاء حجم الدمار والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين، وكثيرًا ما أثارت شبكة سي إن إن وشبكة بي بي سي – كنموذج للإعلام « الغربي » السّائد – الشكوك بشأن عدد الضحايا الفلسطينيين، ولا تعتمد سوى الرواية الصهيونية بشكل حصري، وهدفها « تحميل حماس المسؤولية »، وهي عملية تحَيُّز منهجي في التعامل مع المعلومات الواردة من غزة، وتطبيق معايير مزدوجة بشأن الأحداث وبشأن المُعلّقين و »الضيوف » المدعُوِّين للتعليق على الأحداث، مما أدّى إلى استقالة بعض الصحافيين لعدم قدرتهم على مواصلة العمل في ظل ظروف تتعارض مع المبادئ الصحفية…
عمومًا، شاركت وسائل الإعلام « الغربية » ( فضلا عن وسائل الإعلام التي يُمَوِّلُهَا حكّام الخليج) في نشر معلومات مضللة حول عام ونصف من المجازر في غزة ولها مسؤولية واضحة في تضليل الجمهور، ولذلك تلقّت قناة BFM TV الفرنسية تهنئة شخصية من المتحدث باسم الجيش الصهيوني على نشر الرواية الصهيونية خلال تغطيتها الإعلامية « الناجحة » للعدوان، وصرّح الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الذي استقال من منصبه بسبب » تواطؤ الولايات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول أوروبا في العدوان المروع » الذي نفذه الكيان الصهيوني: « إن تواطؤ وسائل الإعلام قد يكون له عواقب قضائية، تماماً كما حدث مع القادة الإسرائيليين… إن وسائل الإعلام الغربية لا تستطيع التهرب من مسؤوليتها القانونية عن الدور الذي تلعبه في نشر الدعاية الإسرائيلية، تمامًا مثلما أقرّت محاكمات نورمبرغ، حيث أدين يوليوس شترايشر، محرر الأسبوعية النازية « دير شتورمر »، بتهمة التحريض على الكراهية… إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا اعترفت بإدانة ثلاث مسؤولين إعلاميين بالتحريض على الإبادة الجماعية في تسعينيات القرن العشرين، وأدين الثلاثة بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية، من بين جرائم أخرى…إن المُعتدي يعلم ما يفعله، وتعرف سي إن إن وفوكس وبي بي سي ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال ما تفعله »، وسبق أن وبّخت القاضية نافي بيلاي، وهي الآن مفوضة في لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجرائم الصهيونية، الصحفيين بشدة، أثناء النطق بالحكم: « لقد كنتم على دراية كاملة بقوة الكلمات واستخدمتم وسائل الإعلام ذات التأثير الواسع بين الجمهور لنشر الكراهية والعنف […] لقد تسببتم في مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء، بدون بندقية أو ساطور أو أي سلاح مادي آخر « .
تتمتع وسائل الإعلام تتمتع بقوة هائلة، ومن خلال تسميمها، يمكن أن تسبب أضرارا كارثية لملايين الأرواح، وعلاوة على ذلك، فإن التضليل الإعلامي لا يؤثر على الجماهير فحسب، بل يؤثر أيضا على القرارات السياسية للحكومات الغربية، المتواطئة في دعم الجرائم الصهيونية في فلسطين والبلدان المُحيطة بها… إن التسميم الإعلامي يدعم إفلات المُجرمين من العقاب، مما يسمح باستمرار عمليات القتل، معتقدين أن مرتكبيها لن يحاسبوا أبداً…
اكتفيْتُ في هذا العرض بدور مصر – نيابة عن الأنظمة العربية – لكن دور النظام المصري لا يقل خطورة عن دور النظام الأردني وأنظمة الخليج – خصوصًا السعودية والإمارات وقَطَر – التي أنفقت مليارات الدّولار لتخريب المقاومة الفلسطينية والبلدان غير الملكية مثل ليبيا وسوريا والعراق ولبنان ودعمت الثورة المضادّة في مصر وتونس والجزائر، وأدّت الأُسَر الحاكمة بالخليج نفس الدّور التّخريبي في فلسطين المُكمِّل للدّور الإمبريالي والصّهيوني…
الطاهر المعز
-
الطاهر المعز-الأضْرار الجانبية » للحرب الإقتصادية الأمريكية

« الأضْرار الجانبية » للحرب الإقتصادية الأمريكية – الجزء الأول : الطاهر المعزتُشكّل الحرب الإقتصادية والتّجارية الأمريكية إعادة نظر أو مُراجعة للمنظومة الدّولية التي تم إرساؤها سنة 1944 (بريتون وودز) لتقاسم العالم بنهاية الحرب العالمية الثانية التي أدّت إلى انحسار الإمبرياليتَيْن البريطانية والفرنسية وإلى توسّع الإمبريالية الأمريكية والإتحاد السوفييتي، وتندرج هذه الحرب الإقتصادية ضمن تعاظم القوة العسكرية للولايات المتحدة، وأهمية الدّولار ( القُوّة المالية)، وكذلك ضمن انعطافة هامة للدّول الإمبريالية نحو اليمين المتطرف والفاشية المُغَلَّفَة بقِناع « الدّيمقراطية »، وتجسيد التحالف بين قوى القوى العنصرية والفاشية ( أحزاب اليمين المتطرف ) وأثرى الأثرياء في أوروبا وأمريكا الشمالية ضدّ الأُجَراء والكادحين والمضطَهَدِين والفقراء داخل الدّول الرأسمالية المتقدّمة وفي العالم، فهي حرب الأغنياء ضدّ الفقراء…
بدأت هذه الحرب منذ سنوات، ولكنها تكثفت خلال العقد الثّاني من القرن الواحد والعشرين، وما يفعله دونالد ترامب حاليا هو استمرار لسياسة إدارة جوزيف بايدن ضد الصين ( المنافس الأكبر) التي استفادت من التجارة الحرة، وضدّ مجموعة بريكس التي هدّدتها الولايات المتحدة بالوَيْل إذا تَخلّت عن الدّولار، واستمرارٌ لتدمير المؤسسات التي فرضتها الإمبريالية بعد الحرب العالمية الثانية كالأمم المتحدة ومنظماتها واتفاقياتها المُتعَدِّدَة التي يتجاهلها الكيان الصهيوني بتشجيع من مجمل الدّول الرأسمالية المتقدّمة وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، وتمثّل الدّور الأمريكي في تخفيض أو إلغاء تمويل هذه المنظمات الدّولية ومُغادرة بعضها ( منظمة الصحة العالمية) وعدم تطبيق قرارات المحاكم الدّولية…
وقَّعَ دونالد ترامب، يوم الثامن من نيسان/أبريل 2025 أمرًا تنفيذيًّا لدعم قطاع التعدين، حيث تراجع عدد العاملين بالمناجم خلال عقد واحد من سبعين ألف إلى أربعين ألف عامل ( وكالة رويترز 08 نيسان/ابريل 2025)، وعلّق توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز على ذلك: « يسعى دونالد ترامب – من خلال الميزانية الإتحادية – إلى تقليص تمويل التكنولوجيا النظيفة، وطاقة الرياح والشّمس وإلغاء الحَدّ من التلوث، كمما إنه بصدد عَزْل الولايات المتحدة من خلال مهاجمة أقرب حلفائها، مثل كندا واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، واستفزاز الصين – خصمنا الأكبر – ويدعم صناعات الطاقة المدمُرة للمناخ على حساب الصناعات المستقبلية… »، مع العلم إن توماس فريدمان من كبار الكُتّاب والصّحافيين الدّاعمين للقوة الأمريكية…
من جهتها درست صحيفة « وول ستريت جورنال » احتمالات تراجع المُضاربين عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يضطر الإحتياطي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة لاجتذاب المشترين، ويؤدّي رَفْعُ أسعار الفائدة إلى انخفاض الإستهلاك داخل الولايات المتحدة، بفعل ارتفاع أقساط ديون العقارات والسيارات وغيرها…
تُؤكّد صحيفة فايننشال تايمز إن قرارات دونالد ترامي تُؤدّي إلى انخفاض عدد الزّائرين للولايات المتحدة ( تحتل الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات المرتبة الأولى بإيرادات السياحة الخارجية قبل إسبانيا وفرنسا) وعدد الطّلبة النابغين الذين كانوا يُخطّطون للدراسة في الولايات المتحدة، ثم حوّلوا وجهتهم إلى كندا أو أوروبا، هربًا من انعدام سيادة القانون ومن قَمع حرية التعبير والإعتقال التّعسّفي والتّرحيل، وبذلك تفقد الولايات المتحدة موقعها كقوة جذب المهاجرين والباحثين والمُبْتَكِرِين وتفقد موقعها كمركز علمي ومالي عالمي، وقد تظهر أصوات تُطالب بنقل الأمم المتحدة خارج هذه الدّولة المارقة، فيما أصبحت الصين « الدولة الرائدة عالميًا من حيث ناتج البحث العلمي في مجالات الكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض والبيئة، وتحتل المرتبة الثانية في علوم الأحياء والعلوم الصحية » وفق مجلة ( Nature )…
تؤدّي زيادة الرسوم الجمركية إلى تقليص الواردات لكنها تضر بنمو الإقتصاد الأمريكي الذي يتم تعزيزه منذ عقود من خلال زيادة الديون الحكومية وارتفاع نسبة الفائدة، وإضعاف قيمة الدّولار ( الهدف الذي يسعى إليه دونالد ترامب لتعزيز صادرات الولايات المتحدة ) الذي قد يضر بمكانة الدّولار كمُستقطب للإستثمارات الدّولية في الولايات المتحدة، لأن الأجانب يحتفظون بقيمة حوالي عشرين تريليون دولارا من الأسهم الأمريكية، وبقيمة تفوق سبع تريليونات دولارا من سندات الخزانة الأمريكية، وبأكثر من خمس تريليونات دولارا من سندات الشركات الأمريكية، مما يرفع الدّيْن الخارجي الأمريكي إلى ما لا يقل عن 24 تريليون دولارا، وقد تؤدّي السياسات المُتهوّرة لإدارة دونالد ترامب إلى اهتزاز ثقة المُستثمرين وإلى انهيار الطلب على الأصول الأمريكية، والتهديد بانهيار منظومة الإقتصاد العالمي الذي تُشكّل الولايات المتحدة قاطِرَتَهُ، وفق المعهد الدولي للتمويل (IIF) تعليقًا على تراجع أسواق المال العالمية…
نشر موقع صحيفة فايننشال تايمز بتاريخ الرّابع من أيار/مايو 2025، تعليقًا على قرارات الرّسوم الجمركية التي اتخذها دونالد ترامب الذي يتبنّى رؤية اقتصادية قومية شوفينية لتحقيق أهداف جيوسياسية، وشبّه هذه القرارات ب » الإعصار المالي » الذي أدّى إلى « اضطراب الأسواق العالمية ولدى المُستثمرين بفعل حجم الاقتصاد الأميركي ومركزه في المنظومة المالية العالمية »، وقد تكون النتائج السلبية عديدة ومن بينها انخفاض الناتج العالمي وعدم استقرار الأسواق وانعدام الثقة، لأن رأس المال يحتاج إلى الإستقرار، ولا يعترف بالحدود القومية، لأن دينه ومذهبه الوحيد هو الرّبح، وأدّى الإضطراب الناتج عن قراراتدونالد ترامب هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الدّولار الذي لم يعُد ملاذًا آمنا وتراجعت أسعار الأسهم وإلى ارتفاع عدد عمليات بيع سندات الخزانة، خصوصًا بعد إجراءات انتقامية قام بها دونالد ترامب ضد بعض مكاتب المحاماة، وبعض الشركات، وبعد قطع التمويل عن جامعات عريقة مثل « هارفارد »، ويرى بعض خبراء صندوق النقد الدولي « إن الحرب التجارية أضافت ضغوطًا جديدة إلى تلك التي كانت قائمة بفعل الحروب ( أوكرانيا والمشرق العربي) مما قد يؤدّي خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي من 3,3% إلى 2,8% «
توتّر العلاقات الدّولية
تندرج السياسات العدوانية للولايات المتحدة، من خلال قرارات رئيسها دونالد ترامب، ضمن محاولات بسط النّفوذ وتأكيد الهيمنة الأمريكية على العالم، ورفض أي شكل من أشكال المنافسة أو تقاسم النّفوذ في إطار التقسيم الدّولي للعمل والتبادل التجاري، وأدّى إعلان الحرب الإقتصادية والتّجارية إلى مجموعة من العواقب، خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتحاول الفقرات الموالية تقديم أمثلة لما يحصل عَمَلِيًّا جراء هذه القرارات، وقد تكون بعض التفاصيل مُملّة لكنها أداة فَعّالة لمن يريد سَبْرَ أغوار تأثيرات هذه القرارات الأمريكية، وهذه بعضها:
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لصحيفة « تسايت » الألمانية (16 أبريل/نيسان 2025) ردا على سؤال حول الدور القيادي المحتمل للاتحاد الأوروبي في ما سَمّته الصحيفة العالم الغربي: « الغرب كما عرفناه جميعا لم يعد موجودا بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض »، وتجدر الإشارة إلى أن أورسولا فون دير لاين هي وزيرة ألمانية سابقة، ثَرِيّة (وكذلك زوجها) ومؤيدة لأميركا وأطلسية وصهيونية.
تخطط الإدارة الأميركية للتفاوض مع أكثر من سبعين دولة للحصول على التزامات من شركائها التجاريين بعزل الصين اقتصاديا مقابل خفض الرسوم الجمركية التي فرضها البيت الأبيض، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال (16 نيسان/ابريل 2025)، بهدف هو مَنْعِ الصين من نقل البضائع إلى أراضي هذه البلدان أو عِبْرَها، ومنع الشركات الصينية من ترسيخ وجودها في هذه البلدان بهدف التحايل على الرسوم الجمركية الأميركية، ومنع دخول المنتجات الصناعية الصينية الرخيصة إلى أسواقها.
من ناحية أخرى، تهدد الإدارة الأميركية بفرض رسوم جمركية بنسبة 245% على الواردات من الصين في سياق تصعيد درجة التوترات التجارية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام الصّحفي للبيت الأبيض، والذي يذكر بأنه في أوائل نيسان/ أبريل 2025، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 10% على جميع الدول ورسوماً جمركية إضافية على المنتجات من الدول « التي تعاني الولايات المتحدة من أكبر عجز تجاري معها، من أجل تحقيق التوازن التجاري وضمان الأمن القومي الأميركي »، وفي وقت لاحق، أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 75 دولة حول العالم « بدأت بالفعل مفاوضات » مع واشنطن من أجل « إبرام اتفاقيات تجارية جديدة »، وفي ضوء هذه المناقشات، تم تعليق الرسوم الجمركية على جميع الدول باستثناء الصين، التي ردّت بالمثل، ونتيجةً لهذه الإجراءات، قد تواجه الصين الآن رسومًا جمركية تصل إلى 245% على الواردات الأمريكية، وفقًا للبيان، ولم يقدم البيت الأبيض تفاصيل بشأن توقيت أو شكل الإجراءات المشددة.
من جهتها، علّقت الصين صادراتها من مجموعة واسعة من المعادن والمغناطيسات الأساسية، مُهدّدة بخنق إمدادات المكونات الأساسية لشركات صناعة السيارات ومصنعي الطائرات وشركات أشباه الموصلات والمقاولين العسكريين حول العالم، وتوقفت شحنات المغناطيسات، الضرورية لتجميع كل شيء من السيارات والطائرات من دون طيار إلى الروبوتات والصواريخ، في العديد من الموانئ الصينية، ريثما تُصوغ الحكومة الصينية قرارات تنظيمية جديدة، وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، وبمجرد تطبيقه، يُمكن للنظام الجديد أن يمنع وصول الإمدادات إلى شركات مُعيّنة، بما في ذلك المقاولون العسكريون الأميركيون، بشكل دائم، كما أعلنت الصين تعليق مشترياتها من شركة بوينغ بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وأعلنت الحكومة الصينية وقف تسليم طائرات بوينغ لشركات الطيران الصينية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ (16 نيسان/أبريل 2025)، ردًّا على فَرْض الولايات المتحدة زيادة حادّة في الرّسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية تصل إلى 145% منذ الثاني من نيسان/ابريل 2025، وفرضت الحكومة الصينية منذ يوم الرابع من نيسان/ابريل 2025، قيوداً على تصدير ستة معادن أرضية نادرة ثقيلة، تُكرّر بالكامل في الصين، بالإضافة إلى مغناطيسات أرضية نادرة، تحتكر الصين إنتاج نسبة 90% منها، ولا يُمكن الآن شحن هذه المعادن، والمغناطيسات الخاصة المصنوعة منها، خارج الصين إلا بتراخيص تصدير خاصة، لكن الصين لم تبدأ بعدُ – حتى منتصف نيسان/ابريل 2025 – في إنشاء نظام لإصدار التراخيص، مما أثار قلق مسؤولي الصناعة من احتمال إطالة أمد العملية، ومن احتمال انخفاض الإمدادات الحالية من المعادن والمنتجات خارج الصين، وإذا نفدت مغناطيسات الأرضية النادرة القوية من المصانع في مصانع السيارات بمدينة ديترويت الأمريكية وأماكن أخرى، فقد يمنعها ذلك من تجميع السيارات وغيرها من المنتجات المزوّدة بمحركات كهربائية تتطلب هذه المغناطيسات، وتتفاوت الشركات بشكل كبير في حجم مخزوناتها الاحتياطية لمثل هذه الحالات الطارئة، لذا يصعب التنبؤ بتوقيت انقطاع الإنتاج، وبحسب موقع «ستاتيكا» للإحصاءات، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات المعادن الأرضية النادرة من الصين، التي شكلت 70% من وارداتها بين سَنَتَيْ 2020 و2023، بينما تُعدّ ماليزيا واليابان وإستونيا المُوَرِّدِين الرئيسيِّين الثلاثة الآخرين للولايات المتحدة، ويُستورد الإيتريوم، أحد العناصر المشمولة بالقواعد الجديدة، بشكل شبه حصري من الصين، حيث تأتي 93% من مركبات الإيتريوم المستوردة إلى الولايات المتحدة بين سَنَتَيْ 2020 و2023 من الصين، ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، تعتمد الولايات المتحدة على استيراد الإيتريوم بنسبة 100%، وهو يُستخدم بشكل أساسي في المحفزات والسيراميك والإلكترونيات والليزر والمعادن والفوسفور.
تُستخدم « المعادن الأرضية النادرة الثقيلة » التي يشملها قرار الصين بتعليق التصدير في المغناطيسات الأساسية للعديد من أنواع المحركات الكهربائية، وتُعدّ هذه المحركات مكونات أساسية للسيارات الكهربائية والطائرات الآلية ( من دون طيار)، والروبوتات والصواريخ والمركبات الفضائية، كما تستخدم السيارات التي تعمل بالبنزين أيضاً محركات كهربائية مزودة بمغناطيسات أرضية نادرة لأداء مهام حيوية مثل التوجيه.
كما تُستخدم المعادن النادرة أيضاً في المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع محركات الطائرات وأجهزة الليزر ومصابيح السيارات وبعض شمعات الاحتراق، وتُعدّ هذه المعادن النادرة مكونات أساسية في المكثفات، وهي مكونات كهربائية لرقائق الحاسوب التي تُشغّل خوادم « الذكاء » الاصطناعي والهواتف « الذكية ».
صرّح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «أميركان إليمنتس»، وهي شركة توريد مواد كيميائية مقرها لوس أنجليس، بأن شركته أُبلغت بأن الأمر سيستغرق 45 يوماً قَبْلَ إصدار تراخيص التصدير واستئناف صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، وأضاف أن شركته زادت مخزونها الشتاء الماضي تحسباً لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويمكنها الوفاء بعقودها الحالية أثناء انتظار التراخيص، وأعرب رئيس اللجنة الاستشارية للمعادن الحرجة في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة التجارة، عن قلقه بشأن شُح توافر المعادن النادرة، وقال: «هل من المحتمل أن يكون لضوابط أو حظر التصدير آثار وخيمة على الولايات المتحدة؟ نعم». وأكد رئيس قسم التجارة الدولية والأمن القومي في شركة «بوكانان إنغرسول وروني» للمحاماة، ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة المعادن النادرة لأن استمرار انقطاع الصادرات قد يضر بسمعة الصين باعتبارها مورداً موثوقاً، غير إن وزارة التجارة الصينية، التي أصدرت قيود التصدير الجديدة بالاشتراك مع الإدارة العامة للجمارك، مَنَعَت الشركات الصينية من التعامل مع قائمة متزايدة من الشركات الأميركية، وخصوصاً المقاولين العسكريين، وأعلن أحد رواد التعدين الأميركيين والرئيس التنفيذي لشركة «إم بي ماتيريالز»، إن إمدادات المعادن الأرضية النادرة للمقاولين العسكريين كانت مصدر قلق خاص، وأضاف: « إن الطائرات المسيرة والروبوتات هي الأسلحة التي سيتزايد استخدامها على نطاق واسع في الحروب المُستقبلية، وبناءً على كل ما نراه، فقد توقفت المدخلات الأساسية لسلسلة التوريد مما يثير تساؤلات حول مستقبل الصناعات الحربية المستقبلية « ، وتجدر الإشارة إن الشركة التي يُديرها – «إم بي ماتيريالز» – تمتلك منجم المعادن الأرضية النادرة الوحيد في الولايات المتحدة، وهو منجم ماونتن باس في صحراء كاليفورنيا بالقرب من حدود نيفادا، وتأمل الشركة في بدء الإنتاج التجاري للمغناطيس في تكساس بنهاية العام 2025 لحساب شركة «جنرال موتورز» وغيرها من الشركات المصنعة.
أما في اليابان، فإن بعض الشركات تحتفظ بمخزونات من المعادن الأرضية النادرة تزيد على إمدادات عام كامل، لأنها استخلصت الدّروس بعد أن تضررت سنة 2010، عندما فرضت الصين حظراً لمدة سبعة أسابيع على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى اليابان خلال نزاع إقليمي.
بدأت قيود التصدير الصينية حيز التنفيذ قبل أن تعلن إدارة ترمب مساء الجمعة 11 نيسان/ابريل 2025 أنها ستعفي العديد من أنواع الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية من أحدث تعريفاتها الجمركية، لكن صادرات المغناطيسات لا تزال محظورة هذا الأسبوع، وفق تصريحات خمسة مسؤولين تنفيذيين في صناعة العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات التي تخضع – مثل معظم السلع الصينية – لأحدث الرسوم الجمركية عند وصولها إلى الموانئ الأميركية، ولكن مَضت الصين قُدُمًا في التعامل بالمثل والرّد، خصوصًا وإنها تحتكر المعادن النادرة وأنتجت – حتى سنة 2023 – نحو 99% من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، مع إنتاج ضئيل من مصفاة في فيتنام، لكن هذه المصفاة أُغلقت خلال العام 2024 بسبب نزاع ضريبي، مما ترك الصين في حالة احتكار، كما تنتج الصين 90% من إجمالي إنتاج العالم من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، الذي يبلغ نحو 200 ألف طن سنوياً، وهي أقوى بكثير من مغناطيسات الحديد التقليدية، وتنتج اليابان معظم الكمية المتبقية، وتنتج ألمانيا كمية ضئيلة أيضاً، لكن اليابان وألمانيا تعتمدان على الصين في الحصول على المواد الخام، لأن أغنى رواسب المعادن الأرضية النادرة الثقيلة في العالم تقع في وادٍ صغير مُغطى بالأشجار على مشارف مدينة لونغنان في تلال الطين الأحمر بمقاطعة جيانغشي في جنوب وسط الصين، وتقع معظم مصافي التكرير ومصانع المغناطيس الصينية في لونغنان وغانتشو أو بالقرب منهما، وهي بلدة تبعد نحو 80 ميلاً، وتقوم المناجم في الوادي بنقل الخام إلى المصافي في لونغنان، وتتمثل عملية « التّصْفِيَة » في إزالة الملوثات وإرسال المعادن النادرة إلى مصانع المغناطيس في قانتشو…
تباطؤ النّمو
يُمثل تباطؤ النّمو أحد أهم نتائج الحرب التجارية، إذْ أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد)، يوم الإربعاء 16 نيسان/ابريل 2025، إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ فينخفض من 2,8% سنة 2024 إلى 2,3% سنة 2025، بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تؤدّي إلى الرّكود، ووَرَدت هذه التّوقّعات المتشائمة ضمن تقرير نشرته منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ( أونكتاد) عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام 2025: « يُمثل هذا تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل جائحة كورونا، والتي كانت في حد ذاتها فترة من النمو الضعيف عالميًا ».
أما الأسواق المالية فقد اضطربت منذ بداية شهر نيسان/ابريل 2025، بسبب حالة عدم اليقين الإقتصادي والتجاري، بعد إعلان بداية تنفيذ الرّسوم الجمركية الإضافية بداية من الثاني من نيسان/ابريل 2025، قبل تعليق تطبيقها على 12 اقتصاد، لكنها لا تزال سارية المفعول بنسبة 145% بخصوص واردات الولايات المتحدة من المنتجات الصينية، وفي فقرة أخرى من تقرير « أونكتاد » وَرَدَ « إن جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات حادة في خطوط الإنتاج العابرة للحدود وتدفقات التجارة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي وزيادة تخوفات المُستثمرين… ( ولذا) تتّسِمُ التوقعات العالمية للعام 2025 بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، مما يتسبب في تكبد الشركات خسائر كبيرة وتأخير الاستثمار والتوظيف… » وحثت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إدارة ترامب على « استثناء أفقر الاقتصادات وأصغرها من التعريفات الجمركية المتبادلة، ( لأن ذلك ) سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة ».
تراجع حركة التجارة الدّولية
خفضت منظمة التجارة العالمية توقّعاتها لحركة التجارة الدّوْلية للسلع، لسنة 2025، من نمو قوي بنسبة 3% إلى نحو 0,2% بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية وامتداد تبعاتها وتأثيراتها التي يتوقّع أن تكون « أشدَّ ركودٍ منذ ذروة جائحة كوفيد-19… » استنادًا إلى الإجراءات الأمريكية التي بدأ تطبيقها يوم الثاني من نيسان/ابريل 2025 وتوقعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية انكماشًا حادًّا وانخفاضًا في حركة التجارة الدّولية بنسبة 1,5%، وهو أكبر تراجع منذ سنة 2020، مما يؤدّي إلى انخفاض نمو الناتج الإجمالي المحلي للدّول، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 7% في الأمد البعيد، إذا لم يتم حل الإشكالات المطروحة حاليا، وإلى انعكاسات سلبية على الأسواق المالية وعلى قطاعات اقتصادية أخرى على نطاق واسع، خصوصًا في البلدان الفقيرة المُسمّاة « نامية »، وقد تؤدّي هذه الحرب التجارية إلى فك الارتباط بين الاقتصادين الأميركي والصيني الذي قد يؤدِّي إلى « عواقب وخيمة إذا ساهم في تفتيت أوسع للاقتصاد العالمي على أسس جيوسياسية وتحويله إلى كتلتين معزولتين »، وتتوقع منظمة التجارة العالمية انخفاض تجارة السلع بين البلدين ( الولايات المتحدة والصّين) بنسبة 81%، وهو معدل كان من الممكن أن يصل إلى 91% في حال عدم إعلان الاستثناءات الأخيرة لمنتجات من بينها الهواتف الذكية، ونقلت وكالة رويترز عن مُدير تنفيذي سابق بصندوق النّقد الدّولي « أصبح التنبؤ بسيناريو أساسي موثوق مسألة مستحيلة تقريبا ( بسبب) تَراجُعِ ما تبقى من نظام التجارة القائم على القواعد، لصالح وضع فوضوي قائم على الصفقات، وتعتمد أي توقعات بشأنه على قدرة الحكومات على إبرام صفقات ثنائية مع الولايات المتحدة… »
انخفاض قيمة الدّولار
امتدّت وطأة التداعيات السلبية المباشرة للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تثير تقلبات حادة في الأسواق كافة لتُصيب العُملة الأمريكية ( الدّولار) الذي كان يُعَدُّ ملاذًا آمنا، يرتفع أو يستقر سعرًهص خلال فترات الإضطراب، ولكنه لم يتمكّن من البقاء بعيدًا عن « التّأثيرات الجانبية » لتلك الحرب، ولم يتمكّن من تجنّب التّقلّبات التي أثارت قلق الرأسماليين والمُضاربين بالأسهم ( المُستثمِرِين) وأَثّرت سلبًا في السوق المالية « وول ستريت » فانخفض مؤشر الدّولار الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، خلال الأسبوع الثاني من شهر نيسان/ابريل 2025، بفعل تزايد حالة عدم اليقين التي أثارتها قرارات زيادة الرسوم الجمركية، وفي مقابل انخفاض قيمة الدّولار، ارتفعت قيمة اليورو الأوروبي والين الياباني بأكثر من %4 مقابل الدّولار، خلال الأسبوعَيْن الأوّلَيْن من شهر نيسان/ابريل 2025، بعد تسريب تقارير المصارف الأمريكية الكبرى بشأن احتمال حدوث انكماش النّمو الإقتصادي وارتفاع معدّلات البطالة في الولايات المتحدة، وعادةً ما يساهم تدهور الوضع الإقتصادي في زيادة الضُّغُوط على الأسواق وفي تراجع الطلب على الدّولار، وتراجع مؤشر الدولار الذي يفقد مكانته كملاذ آمن زمن الأزَمات، كما تراجع الطلب على السندات وعلى أسهم الشركات الأمريكية، ويُهدّد هذا الوضع مكانة الدّولار في النظام المالي الدّولي، ويزيد من البحث عن سُبُل « فكّ الإرتباط » بالدّولار الذي يهيمن حاليا، وعلى مدى قصير وحتى متوسّط على التجارة العالمية وأسعار المواد الأولية ( ومن ضمنها المحروقات) وعلى التحويلات المالية الدّولية، ولكن السلطات الأمريكية تُدْرِك جيّدًا الخسائر التي تُصيبها جراء التّخَلِّي عن الدّولار ولذلك هدّد دونالد ترامب الدّول ( بما فيها أعضاء مجموعة بريكس) التي تعتزم تقويم المبادلات التجارية بعملات أخرى غير الدّولار، وفي واقع الأمر ساهمت الولايات المتحدة في محاولات بعض الدّول خفض التعامل بالدّولار، بسبب القرارات الأمريكية الجائرة: الحَظْر والعُقوبات واستغلال النفوذ الإقتصادي والسياسي والإعلامي والعَسْكَرِي لابتزاز الدّوَل…
يُؤَدِّي تراجع الدّولار إلى ارتفاع مكانة الذّهب كملاذ آمن ( بَدَل الدّولار)، فقد ارتفعت مشتريات المصارف المركزية من الذّهب مما رفع سعره بنسبة 27% منذ بداية العام 2025، وإلى مستوى قياسي ( 3359,5 دولارا للأونصة أو الأوقية) صباح الخميس، السابع عشر من نيسان/ابريل 2025، مما يزيد من تراجع الدّولار، وترافق ارتفاع سعر الذّهب مع ارتفاع سعر المعادن النفيسة الأخرى، كالفضة والبلاتين…
خسائر شركات التكنولوجيا: انفيديا وأيه إم دي
تأثّرت شركات التكنولوجيا الأمريكية باحتداد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، فقد أعلن متحدث باسم شركة « إنفيديا »، يوم الثلاثاء 15 نيسان/ابريل 2025، إن قرارات الحرب التجارية وحظر التعامل مع الصين تؤدّي إلى خسارة الشركة نحو 5,5 مليار دولارا من التّكاليف الإضافية بعد أن حَدَّت الحكومة الأميركية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي، وفرضت قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها، ويندرج هذا القرار ضمن محاولة مسؤولي الحكومة الأمريكية الحفاظ على صدارة سباق الذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى سيطرة شركة إنفيديا على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة بشكل أساسي في مراكز البيانات، وفقًا لشركة أبحاث السوق آي.دي.سي ( نهاية آذار/مارس 2025)، وانخفضت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 6% لأن رقائق « إتش 20 » مطلوبة في السوق الصينية ومن قِبَل شركات صينية عديدة مثل « علي بابا » و « تينسنت » و « بايت دانس » ( الشركة الأم لتطبيقات تيك توك ) وهي أكثر تطوّرًا من الرقائق الأخرى المعروضة في أسواق الصّين، وعلّلت الحكومة الأمريكية تقييد مبيعات (إتش20) للصين بسبب « خطر استخدامها في حواسيب عملاقة » وسبق أن أعلنت شركة إنفيديا ( يوم الاثنين 14 نيسان/ابريل 2025) أنها تخطط لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة بمساعدة شركاء مثل تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج (تي.إس.إم.سي)، تماشيا مع سعي إدارة ترامب للتصنيع المحلي.
بالإضافة إلى إنفيديا، أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات الأميركية أدفانسد ميكرو ديفايسز ( AMD – أيه.إم.دي) إنها تتوقع تكبد خسائر بقيمة 800 مليون دولار من إيراداتها نتيجة القيود التي قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وإنها ستسعى للحصول على تراخيص لتصدير منتجاتها إلى الزبائن في الصين، لكنها لا تستطيع التأكد من حصولها عليها، وفق وكالة بلومبرغ بتاريخ 15 نيسان/ابريل 2025، وتجدر الإشارة إن إدارة الرئيس « الدّيمقراطي » جوزيف بايدن أصدرت قرارات عديدة تزيد من القيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بذريعة احتمال » تهديدات للأمن القومي » من منافس جيوسياسي.
انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا وتصنيع الرقائق، يوم الإربعاء 16 نيسان/ابريل 2025، بعد إعلان شركة إنفيديا أن الضوابط الأميركية الجديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي ستُكلفها 5,5 مليار دولار إضافية، وكانت إنفيديا قد أعلنت أنها ستبدأ إنتاج حواسيبها الفائقة للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة لأول مرة، وانخفضت أسهم منافِستها «إيه إم دي» بنسبة 6,5%، كما انخفضت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية الكبرى، فتراجعت أسهم شركة أدفانتست، المُصنّعة لمعدات الاختبار، بنسبة 6,7% في طوكيو، وخسرت شركة ديسكو 7,6% ، بينما انخفضت أسهم شركة تي إس إم سي التايوانية بنسبة 2,4%…
من أسباب التراجع الأمريكي عن الرسوم الجمركية
أعلن بيان البيت الأبيض يوم الجمعة 11 نيسان/ابريل 2025، عن مجموعة من الإعفاءات الجمركية المؤقتة لبعض الواردات الإلكترونية من الصين (الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وأشباه الموصلات وخوادم الذكاء الاصطناعي)، وتُقَدَّرُ نسبتها ما بين 20% و25% من إجمالي الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، ولم يكن هذا التراجع ناتجا عن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار الإستهلاك داخل الولايات المتحدة بل بسبب ارتفاع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية التي تُعَدُّ أكبر وأكثر أسواق الدَّيْن الحكومي تطورًا، وهي شريان الحياة للميزانية العمومية الأمريكية، وجزءًا من أدوات الإستقرار الإقتصادي والمالي، وعادةً ما يلجأ المستثمرون – خصوصًا خلال الشدائد والأزمات – إلى الذهب، وصناديق الإستثمار المَوْثُوقة وإلى سندات الدّيْن الحكومية التي ترتفع أسعارها وترتفع عائداتها عند ارتفاع الطلب عليها، أي ارتفاع الدّيُون الحكومية وفوائدها، وهو ما حصل لسندات الخزانة الأمريكية مُؤَخّرًا، فالسندات الأمريكية تتميز بأنها مُقوّمة بالدّولار ( أي العملة المحلية للولايات المتحدة) وارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4,5% يوم الجمعة 11 نيسان/ابريل 2025…
أدّت المخاوف بشأن المؤسسات الأمريكية والأضرار الاقتصادية الجسيمة الناجمة عن القرارات الحمائية الأمريكية، والقلق من احتمال تصاعد التوترات العالمية بين الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم الصين، والتوقعات السلبية بشأن دخول الإقتصاد الأمريكي في حالة ركود عميق، إلى تَحَوُّلٍ في الموقف تجاه الاقتصاد الأمريكي، ولم تَعُدْ صناديق التقاعد الدنماركية والكندية (وهما من أكبر المستثمرين في العالم) تعتبر الولايات المتحدة مصدرًا موثوقًا للنمو، وتَلَقَّى الاحتياطي الفيدرالي عددًا قياسيًا من طلبات المصارف المركزية الأجنبية لسحب احتياطياتها الذهبية من فرع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وإعادتها فعليًا، ولا علاقة للصين بعمليات السّحت، فهي تمتلك حيازات ضخمة من الأصول والسندات الأمريكية، تُقدّر ب 759 مليار دولار، والصين ثاني أكبر دائن للولايات المتحدة…
وردت معظم المعلومات والبيانات بمواقع وكالتَيْ رويترز و بلومبرغ 16 و 17 نيسان/ابريل 2025
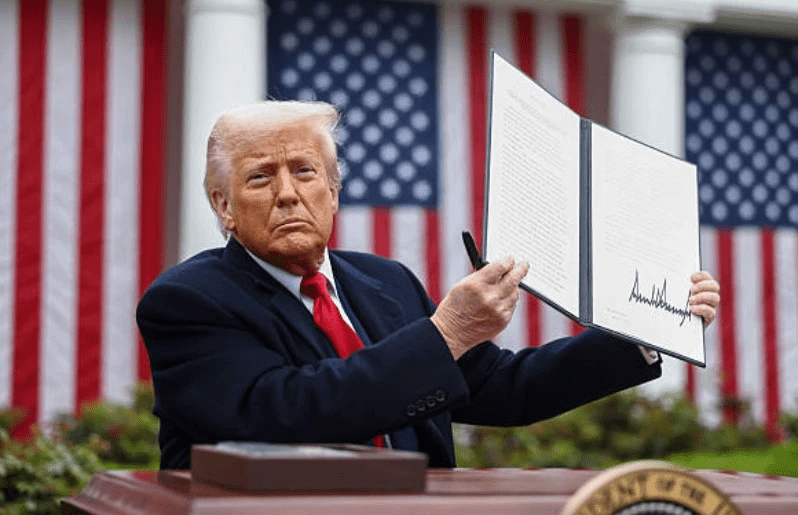
« الأضْرار الجانبية » للحرب الإقتصادية الأمريكية – الجزء الثاني-تحولات السياسة الخارجية الأمريكية
هوامش قرار إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية
خفض دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى ( 2017 – 2020 ) الوظائف الحكومية، وكانت حصة وزارة الخارجية من التخفيضات كبيرة، وكان الرئيس الأمريكي يعتزم خفض ميزانيتها بنسبة 50%، وفق المشروع الذي نَشَرَهُ منتصف نيسان/ابريل 2016، فضلا عن تخفيض المبالغ المُخصّصة للمساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة…
يتواصل هذا المُخطّط خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية، فقد وقّع – منتصف آذار/مارس 2025 – أمرًا تنفيذيا لخفض عدد الموظفين بالعديد من مؤسسات الدّولة الإتحادية والوكالات الحكومية مثل وكالة الإعلام العالمي التابعة للحكومة الأمريكية، المسؤولة عن الدعاية للسياسة الخارجية وتُشرف على برامج محطات الإذاعة الممولة من الحكومة الأمريكية مثل صوت أمريكا وراديو الحرية / أوروبا الحرة، وأقسام الإنترنت الخاصة بها، وتقليص ميزانيات بعض الوكالات الحكومية الأخرى بشكل كبير، ويقوم مكتب كفاءة الحكومة ( إيلون ماسك)، بتنفيذ عمليات تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين وتفكيك وكالات عديدة مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) التي تقلصت ميزانيتها بنحو 50% ومكتب حماية المستهلك وإلغاء أو خفض تمويل المساعدات الإنسانية والصحة العالمية والمنظمات الدولية واقترح البيت الأبيض خَفْض أنشطة وزارة الخارجية بنسبة 48% ( أو حوالي 27 مليار دولارا) عن التمويل الذي وافق عليه الكونجرس للعام 2025 ( 55,4 مليار دولارا) وتقليص نشاط والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتقليص حجم الأموال المخصصة للمنظمات الدولية بنحو 90%، ووضع حدّ لتمويل عمليات حفظ السلام والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي وعشرين مؤسسة دولية أخرى – وسوف يتم الاحتفاظ فقط بتمويل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطيران المدني الدولي، والمنح التقليدية بقيمة 5,1 مليار دولار لتطوير القوات المسلحة للدول الحليفة بشكل فردي، بما في ذلك مصر والكيان الصهيوني ، وتؤدّي قرارات خفض إلى طرد عشرات الآلاف من موظفي وزارة الخارجية البالغ عددهم 80 ألف موظف، فضلاً عن إغلاق عدد من القنصليات وبعض الإدارات والبرامج التابعة للسلك الدبلوماسي، ومرافق أخرى…
كما أشار موقع واشنطن بوست بتاريخ 02 أيار/مايو 2025 إن دونالد ترامب يعتزم خفض عدد موظفي وكالة المخابرات المركزية ( سي آي إيه ) وغيرها من وكالات الاستخبارات الأميركية، وكان صرّح بذلك منذ شهر شباط/فبراير 2025، عندما استخدم الإعلام الهابط المؤيدة له ووكالات الأمن لتهديد معارضيه، وتُشكل عملية تخفيض ميزانية وكالة الإستخبارات المركزية وإقالة الموظفين فُرصة للتطهير وللتخلص من خصومه السياسيين داخل الجهاز الحكومي، كجزء من الصراع السياسي، تحت غطاء خفض الإنفاق الحكومي، وسبق أن أَوْرَدَ موقع صحيفة وول ستريت جورنال ( 05 شباط/فبراير 2025) إن إدارة الإستخبارات المركزية عَرَضت على جميع موظفي الوكالة الإستقالة الطوعية مقابل الحصول على ثمانية أشهر من الأجر كتعويض، وتستهدف خطط الحكومة تسريح 1200 من موظفي وكالة الاستخبارات المركزية ( CIA ) من إجمالي 22 ألف موظف، وتلقى موظفو الوكالات الفيدرالية الأخرى أيضًا رسائل تتضمن نفس الاقتراح، وتتوقع إدارة ترامب أن يؤدي إلغاء « عدة آلاف » من الوظائف في وكالة الأمن القومي (المسؤولة عن استخبارات الإشارات)، ووكالة استخبارات الدفاع، ووكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية، ومكتب الاستطلاع الوطني، وخفض الأجهزة الحكومية بنسبة تتراوح بين 5% و10% إلى توفير نحو 100 مليار دولار للحكومة، فيما عبّر بعض نُوّاب الحزب الدّيمقراطي بالكونغرس « إن هذه التخفيضات متهورة، ومن شأنها تَسْيِيس العمل الإستخباراتي وإضعاف أمن البلاد… »
مكانة « يو إس آيد » في السياسة الخارجية الأمريكية
أسست سلطات الولايات المتحدة » إدارة التعاون الدّولي » خلال فترة رئاسة « دوايت إيزنهاور من الحزب الجمهوري ( 1890 – 1969 ) التي امتدّت من 1953 إلى 1961 كأداة للدّعاية الإيديولوجية ولتوسيع النفوذ الأمريكي والقضاء على « المَدّ الشيوعي » بعد تعزيز صفوف الدّول التي أعلنت تبنّي الإشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية، وبرعت في بث الدّعاية الإيديولوجية، وركّزت على بعض مناطق العالم، وفي أمريكا الجنوبية ركّزت عملها الدّعائي على تشيلي، حيث استقبلت الجامعات الأمريكية، بداية من 1953، العديد من الطلاّب التشيليين في مجال الاقتصاد النيوليبرالي بجامعة شيكاغو ( التي كانت بمثابة معقل النيوليبرالية الإقتصادية)، وبعد عشرين سنة نظّمت الولايات المتحدة انقلابا ضد الرئيس التشيلي المنتخب ديمقراطيا ( سلفادور أليندي) يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 1973، وتم فَرْض الإقتصاد النيوليبرالي الذي لا يزال طاغيا على اقتصاد تشيلي…
بعد انتخاب الرئيس جون إف. كيندي من الحزب الديمقراطي ( 1917 – 1963) ) سنة 1961، تم استبدال إدارة التعاون الدولي ب »الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية » ( USAID ) سنة 1961، كذراع لوزارة الخارجية وللإستخبارات الأمريكية، خصوصًا في بلدان « العالم الثالث » بهدف « مقاومة المَدّ الشيوعي » وامتداد نفوذ الإتحاد السوفييتي في البلدان حديثة الإستقلال أو في البلدان التي لا تزال تحت الإستعمار، خصوصًا في إفريقيا، واهتمت الوكالة بشكل خاص بالدّعاية المناهضة للشيوعية ونشر الإيديولوجيا الإمبريالية السائدة المُوجّهة للمثقفين والفئات الوسطى وموظفي الدّولة أو القطاع الخاص، من خلال « مُساعدات مجانية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية »، وتكيّفت البرامج الإعلامية والإقتصادية للوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية مع الأحداث وأنشأت برامج لمقاومة بعض الأمراض وبرامج زراعية وحماية البيئة و »الحَوْكَمة » و »الإنتقال الدّيمقراطي »، إلى جانب برامج مكافحة الجوع والفقر والأوْبِئة، وتستفيد الشركات الأمريكية حصريًّا من هذه البرامج التي تُموِّلها الحكومة الأمريكية، بهدف ظاهري مُعلن يتمثل في « مساعدة البلدان الفقيرة على تحقيق التنمية » وفي واقع الأمر فهي دعاية سياسية وإيديولوجية، ودعم اقتصادي ومالي للشركات الأمريكية، حيث تبقى الأموال في الحسابات المصرفية لهذه الشركات…
على الجبهة العقائدية والسياسية، ساهمت « الوكالة الأميركية للتنمية الدولية » في تعزيز التّدخّل الإمبريالي الأمريكي في العديد من البلدان لدعم السلطات الدّكتاتورية المحلّية أو لقلب نظام الحُكم الذي لا ترضى عنه السلطات الأمريكية، وتدخّلت في الشؤون الدّاخلية للبلدان، مثلما حدث في إندونيسيا سنة 1965، حيث أعدّت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ( CIA ) – بواسطة أعوانها الذين كانوا يتخذون من التوظيف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدّولية غطاء لهمن – قوائم بأسماء الشيوعيين وأفراد أُسَرِهم وأصدقائهم، مما أدّى إلى قتل ما لا يقل عن نصف مليون شيوعي – حقيقي أو مُفترض – خلال انقلاب الجنرال سوهارتو الذي تدعمه الإمبريالية الأمريكية، وجعلت وكالة الإستخبارات الأمريكية من أندونيسيا مُختبرًا لتدريب قوات الشرطة على جمع المعلومات حوال الإنتماء السياسي للمواطنين وإنشاء سجلاّت للمعارضين بهدف إقصائهم من الوظائف والحياة السياسية، ولا تزال الوكالة تُقدّم الدّعم العسكري للكيان الصهيوني وللعديد من الأنظمة الدّكتاتورية الموالية للإمبريالية الأمريكية، وكانت ذراعًا لوكالة الإستخبارات الأمريكية في العديد من بلدان العالم التي شهدت تنظيم « ثورات مُلَوّنة »…
قرّر دونالد ترامب أن يكون بث الدعاية الإيديولوجية الإمبريالية وتلقين مبادئ الإقتصاد الرأسمالي بواسطة الجامعات الأمريكية، ولذلك قَرّر حل « الوكالة الأميركية للتنمية الدولية » (USAID)، مما أزعج الليبراليين الذين يتخوفون من انخفاض النُّفُوذ الأمريكي في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، ويُغلّفون ذلك بالتظاهر بالحرص على دعم برامج الرعاية الصحية والتعليم والإعلام في البلدان الفقيرة، ودَعْم برامج المنظمات « غير الحكومية » أو » غير الربحية » التي تتلقى مساعدات مالية…
اقترحت إدارة دونالد ترامب إنشاء « وكالة بديلة تكتفي بتوزيع المساعدات الإنسانية » وتَتخلّى عن مؤسسات الإعلام و برامج ترويج الدعاية الإمبريالية الأميركية التي حافظت على أشكال الدّعاية التي كانت سائدة سنوات الحرب الباردة، وإغلاق السفارات الأمريكية في عشرات الدّول، لأن دونالد ترامب وأنصاره يُؤكّدون غياب أي منافسة للإيديولوجيا السّائدة سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادي، وغياب أي برنامج بديل للرأسمالية منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، ويقترح دونالد ترامب وأنصاره التّخلّي عن « القُوّة الناعمة » وعن الدّبلوماسية بشكلها التقليدي، ولذلك وجب فَرْض المصالح الأمريكية بالعقوبات والحصار الإقتصادي وبالعصا الغليظة والقُوّة العسكرية لا غير، كما وجب فَرْض الطّاعة والخضوع داخل الولايات المتحدة، وتعزيز عَسْكَرة قوات الأمن الدّاخلي والشرطة وحرمان بعض مؤسسات البحث العلمي والتعليم من التّمويل، إذا استمرت في الحديث عن « الحرية الأكاديمية وحرية التعبير »، وعن التفاوت في الثروات، وإذا لم تتحول إلى مؤسسات للدعاية الإيديولوجية « المُحافِظَة »، وبذلك تتحوّل الجامعات إلى أبواق دعاية مثل وسال الإعلام الأمريكي السّائد…
الولايات المتحدة دولة مارقة
لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز » الأمريكية بتاريخ الرابع من أيار/مايو 2025 – إمكانية استخدام القوة العسكرية لفرض السيطرة على جزيرة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذّاتي، تحت الوصاية أو الحماية الدّنماركية، وقال الرئيس الأمريكي في رد على سؤال: « أنا لا أستبعد استخدام القوة، أنا لا أقول إنني سأفعل ذلك، ولكنني لا أستبعد أي خيار ( لأن) الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى غرينلاند حيث يعيش عدد قليل جدًا من الناس الذين سوف نعتني بهم ونحميهم… ( إننا) نحتاج إلى هذه السيطرة من أجل الأمن الدولي… »، وسبق أن صرّح دونالد ترامب في مناسبات عديدة « يجب أن تنضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة » غير إن استطلاع الرأي الذي أُجْرِيَ في غرينلاند خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025 أظْهَرَ أن 6% فقط من سكان الجزيرة يؤيدون الانضمام إلى الولايات المتحدة.
غرينلاند – موقع جيواستراتيجي وثروات معدنية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتزامه امتلاك جزيرة غرينلاند –ذات الحكم الذّاتي – والتابعة للدانمارك والواقعة في المحيط المتجمد الشمالي، بالمال وبالتهديد وباستخدام القُوّة، وسبق أن طرح دونالد ترامب، سنة 2019، شراء جزيرة « غرينلاند »، وهي أكبر جزيرة في العالم، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدانماركية، ووصفها ترامب بأنها « صفقة عقارية كبيرة يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدانمارك »، ثم أعاد ترامب الكَرَّةَ سنة 2025 وأرفق « طَلَبَهُ » بتهديد الدّنمارك بفرْض رسوم تجارية مرتفعة جدًّا إذا استمرت في رفض الصّفقة، بعد إبلاغ وزير خارجية الدانمارك زميله الأمريكي معارضة بلاده بشدة لتصريحات الرئيس الأميركي بشأن الاستحواذ على جزيرة غرينلاند، واعتبرها « اعتداء على السيادة الدانماركية » وتقع الجزيرة قريبًا من القطب الشمالي ومن أمريكا الشمالية، وتتمتع بموقع استراتيجي وقد تؤدي زيادة الحرارة إلى ذوبان الجليد وفتح طريق تجارة بحرية هامة جدا، بين المحيط الأطلسي الشمالي وأميركا الشمالية، فضلا عن مواردها الطبيعية الهائلة من المحروقات والمعادن، كالليثيوم والكوبالت واليورانيوم، التي تُعدّ ضرورية للطاقة الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية والحواسيب والهواتف والصناعات العسكرية والصناعات التكنولوجية الحديثة.
سبق أن طرح دونالد ترامب، سنة 2019، شراء جزيرة « غرينلاند »، وهي أكبر جزيرة في العالم، لا يسكنها سوى أقل من ستين ألف نسمة، والتي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية، ووصفها ترامب بأنها « صفقة عقارية كبيرة يمكن أن تخفف من الأعباء المالية للدنمارك »، ثم أعاد ترامب الكَرَّةَ سنة 2025 وأرفق « طَلَبَهُ » بتهديد الدّنمارك بفرْض رسوم تجارية مرتفعة جدًّا إذا استمرت في رفض الصّفقة، ومن الجدير ذكره إن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة عسكرية جوية هامة ( قاعدة ثول) وهي أهم القواعد الأمريكية لمراقبة الفضاء والتهديدات الصاروخية، وعلّل دونالد ترامب تهديداته للدنمارك « إن غرينلاند ضرورية للأمن القومي الأميركي ».
تتمتع الجزيرة بحكم ذاتي منذ سنة 2009، وقدّر البنك العالمي ( بيانات سنة 2021) الناتج المحلي الإجمالي لغرينلاند بنحو 3,2 مليارات دولار وتبلغ المساعدة السنوية الدّنماركية حوالي ستمائة مليون دولار، لمجابهة صعوبات مناخ الجزيرة وعزلتها وصعوبة – بل استحالة – تعاطي النشاط الفلاحي بسبب الثلوج التي تُغطي ما لا يقل عن 80% من أراضيها بشكل مستمر، ويقتصر النشاط الإقتصادي على الصّيْد والصناعات الأولية، مع الإشارة إن جميع الأراضي تُعدّ ملكية عامة ولا توجد مِلْكؤية خاصة للأرض…
تمثل صادرات الإنتاج البحري أكثر من 90% من إجمالي صادرات غرينلاند ( بقيمة تُعادل 800 مليون دولارا سنويا، أو نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي) ويُشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر نحو 4300 شخص يمثلون حوالي 15% من العاملين بالجزيرة التي تستورد معظم جاجياتها من الغذاء، بفعل المناخ القاسي الذي لا يسمح بممارسة النشاط الفلاحي، وتُعد الأسعار في الجزيرة من أغلى مناطق العالم، وتُساهم الدّنمارك بمنحة سنوية تُعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، وفق وكالة « بلومبرغ » بتاريخ الثالث من أيار/مايو 2025.
الرغبة المُستمرة في توسيع الحدود الأمريكية
يمثل التهديد بالإستيلاء بأي طريقة على غرينلاند جزءًا من التّاريخ المُظْلِم للولايات المتحدة منذ البدء ( إبادة السّكّان الأصليين والعبودية)، وعند تشكيل الولايات المتحدة سنة 1776 كانت تضم ثلاثة عشر ولاية، وظهر خلال القرن التاسع عشر شعار (وممارسة) ضرورة التّوسّع نحو الغرب، حتى المحيط الهادئ ( ولاية أوريغون ) وخليج ألاسكا، ثم التّوسّع جنوبا وضم 55% من أراضي المكسيك ( تكساس وكاليفورنيا وأريزونا ويوتا ونيفادا ونيو مكسيكو وكولورادو) إثر الهزيمة العسكرية للمكسيك ومعاهدة 1848، وقبل ذلك اشترت الولايات المتحدة، سنة 1803، ولاية أريزونا، واشترت الولايات المتحدة ألاسكا سنة 1867 من روسيا، وتبلغ مساحة ألاسكا 1,5 كيلومترًا مُربّعًا، كما ضمّت الولايات المتحدة – أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين – مجموعةً من الجزر والأقاليم في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مثل ضم هاواي سنة 1898 والاستيلاء على بورتوريكو وغوام من إسبانيا بعد نهاية الحرب الإسبانية الأمريكية، واقتطعت الولايات المتحدة ما أصبح يُسمّى دولة بنما، سنة 1903، بالقوة العسكرية من كولومبيا، وجعلت منها مَحْمِيّة قبل حفر القناة ثم السيطرة عليها، وتم يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1903، توقيع معاهدة هاي-بوناو-فاريلا بين بنما والولايات المتحدة، والتي بموجبها حصلت واشنطن على الحق « إلى الأبد » في نشر قوات مسلحة لضمان السيطرة على قناة بنما (بدأ البناء في عام 1904 واستمر لمدة عشر سنوات )
قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، اشترت ( آذار/مارس 1917) جُزُرَ فيرجن الدنماركية مقابل 25 مليون دولار من الذهب، خوفًا من أن تقع الأرخبيل تحت السيطرة الألمانية، من عام 1941 إلى عام 1946، احتلت القوات الأمريكية غرينلاند ( بينس سنتَيْ 1941 و 1946) التي كانت أيضًا تابعة للدنمارك، وبعد انتهاء العمليات العسكرية، أعادت الولايات المتحدة ( برئاسة هاري ترومان ) الجزيرة على مضض إلى أصحابها الأصليين، في محاولة لضم الدول الأوروبية إلى الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي.
يخطط الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب اليوم « لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى »، باستخدام الحُروب على كافة الجبهات، من الحرب الإقتصادية والتجارية والإيديولوجية إلى التهديد بالعدوان العسكري على من يُخالف رغبة الرئيس والطبقة الرأسمالية الثرية جدًّا التي يُمثّل مصالحها، وبدأ بالمطالبة « بحقوقه في قناة بنما وغرينلاند وكندا »، وبذلك يعود دونالد ترامب إلى الأُصول أو إلى أُسُس إنشاء الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية والإبادة والإيديولوجية العنصرية ( المُغلَّفَة بالدّين ) والتّوسّع واحتقار (وإبادة) الشّعوب، فقد شكّل التوسع الجغرافي للولايات المتحدة – على مدى ما يقرب من 150 عاماً من وجودها – القاعدة في تطورها وإن اختلفت الطُّرُ والوسائل، وخصوصًا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إذْ فضّلت الولايات المتحدة الهيمنة الإيديولوجية والثقافية والإقتصادية والمالية، وخففت من رغبتها في الاستحواذ على أراضٍ جديدة، إلى أن أحْيَت إدارة جون كينيدي، أوائل ستينيات القرن العشرين مسار « الآفاق الجديدة »، فاتّخذ التوسع الجغرافي شكل « استكشاف الفضاء » و برنامج أبولو للرحلات المأهولة إلى القمر، الذي أعلن عنه خلال شهر أيار/مايو 1961، وتم تنفيذه بنجاح خلال شهر تموز/يوليو 1969، قبل حوالي عشر سنوات من « انفتاح » إدارة جيمي كارتر على الجيران في أمريكا الجنوبية، و تشغيل قناة بنما بالاشتراك مع بنما سنة 1979 (بعد أن كانت تديرها للولايات المتحدة حصْريًّا) قبل أن تنتقل القناة بالكامل إلى بنما سنة 1999 (إدارة وليام كلينتون )، وفي الأثناء نظمت الولايات المتحدة انقلابات وغزوات ومؤامرات، وسلّحت مليشيات الإرهاب اليميني المتطرف في العديد من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية ومناطق أخرى من العالم…
انهار جدار برلين ( تشرين الثاني/نوفمبر 1989) وانهار الإتحاد السوفييتي ( 1991) ولم تضع الولايات المتحدة حدًّا للحرب الباردة ولم يتم حلّ حلف شمال الأطلسي بل تم تعزيزه بالدّول التي كانت تُوصَف بالإشتراكية، وعادت الولايات المتحدة، مع حلول القرن الواحد والعشرين، إلى مبدأ مونرو (الذي أسسه الرئيس الأمريكي الخامس جيمس مونرو – كانون الأول/ديسمبر 1823) ويتلخص في اعتبار أمريكا الجنوبية ونصف الكرة الغربي هو « الحديقة الخلفية » لأميركا، ومنطقة حضور ونفوذ حصرية للولايات المتحدة، لكن توسّع « مبدأ مونرو » ليتجاوز « غرينلاند » كحدود جغرافية جديدة للتوسُّع الأمريكي، وليشمل فلسطين، إذ أعلن دونالد ترامب رغبته ضمّ غزّة « كمشروع عقاري هائل » وفق تعبيره . أما غرينلاند فقد استهدفها دونالد ترامب من آب/أغسطس 2019 (خلال فترة رئاسته الأولى) وطَرَح شراءها، « لأن الدولة التي تملكها تملك أيضاً القطب الشمالي بأكمله »، فضلا عن حقول النفط والغاز والمعادن الأرضية النادرة، وكان ردّ رئيسة وزراء الدنمارك آنذاك ( ميت فريدريكسن ) جافًّا ومُقتضبًا : « غرينلاند ليست للبيع »، وعاد دونالد ترامب إلى طرح الموضوع بعد الانتخابات الرئاسية ( تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، فكتب على وسائل التواصل الاجتماعي « إن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة، من أجل ضمان الأمن القومي (الأمريكي) والحرية في جميع أنحاء العالم »، وكان رد رئيس وزراء الجزيرة: « غرينلاند ملك لنا ولن نبيعها أبدًا »…
فتح دونالد ترامب عدّة جبهات في نفس الوقت، ( كندا وبنما وغرينلاند وغزة والصين… ) فكان ردّ الفعل مُتشابهًا في مواجهة الوقاحة والإبتزاز والتهديدات الإمبريالية الأمريكية، مما يُذكِّرُ بسيناريو غزو الجيش الأميركي لبنما ( كانون الأول/ديسمبر 1989 – كانون الثاني/يناير 1990 ) كتدريب قبل إعلان العدوان على العراق وعلى يوغسلافيا، وأطاحت الولايات المتحدة بزعيم بنما آنذاك مانويل نورييغا الذي نصّبتها بنفسها، ثم نشرت الولايات المتحدة 26 ألف جندي بدعم من 100 مركبة مدرعة و200 طائرة ومروحية…
خاتمة:
حَوّلت الإمبريالية الأمريكية شعار الإقتصاد الرأسمالي الليبرالي من « دَعْهُ يعمل، دَعْهُ يَمُرّ » إلى شعار « الولايات المتحدة ولا أحد غيرها » وتميزت هيمنة الإمبريالية الأمريكية على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بالإحتكار وحماية الحدود وعرقلة دخول الإنتاج الأجنبي – بما في ذلك إنتاج المَحْمِيّات مثل اليابان وألمانيا – إذا كان قادرًا على منافسة الإنتاج الأمريكي في السّوق الدّاخلية، واعتمدت على القوة العسكرية التي تسند الدّولار وتنتشر في كافة القارات والبحار، وعادت إلى الإحتلال المباشر – خصوصًا منذ بداية القرن الواحد والعشرين – مما يُحوّل الولايات المتحدة إلى كائن طُفَيْلي ( parasite ) وإلى خطر عالمي وإلى عدو لشعوب وبلدان العالم، بحكم دعمها الكيان الصهيوني وتهديد أي دولة تُفكّر في استبدال الدّولار بعملات أخرى، وبحكم حصار البلدان والشعوب وما إلى ذلك من ممارسات قُطّاع الطّرق ومجموعات الجريمة المُنظّمة…
هناك العديد من الأسباب التي لا تُثير الكثير من النقاش لكنها تُساهم في تدهور مكانة الولايات المتحدة، ومن بينها اختطاف الطلاب الأجانب وإلغاء تأشيرات الإقامة والاحتجازات على الحدود، وأدّت هذه الممارسات إلى انخفاض حاد في أعداد الزائرين الجدد للولايات المتحدة، والباحثين وأصحاب المواهب والخبرات والكفاءات الذين كانوا يرغبون في الانتقال الدائم إلى الولايات المتحدة، وكان هؤلاء المهاجرون يُشكّلون حجر الأساس للابتكار التكنولوجي الأمريكي، وقد يُؤدّي غيابهم إلى ترجيح كفة الصين.
خاتمة
نعيش تحوّلات تاريخية، تتمثل في نهاية حقبة « بريتن وودز » والمؤسسات المالية الدّولية والأمم المتحدة، لأن هذه المنظومة الدّولية – والتحالفات التي أدّت إلى إنشائها – بصدد الإنهيار، بعد ثمانين سنة من تأسيسها، وتُعدّ الولايات المتحدة العُدّة للإبقاء على نظام « القُطب الرأسمالي الواحد » فيما تدعو الصين وروسيا إلى عالم رأسمالي متعدّد الأقطاب، ولا مصلحة لنا كشعوب واقعة تحت الهيمنة والإضطهاد أو كطبقات كادحة تُعاني الإستغلال والإضطهاد والإستعمار الإستيطاني (فلسطين وكاناكي ) في الإصطفاف وراء أي من الطَّرَفَيْن، غير إننا نُدْرك إن الإمبريالية الأمريكية عدوّ استراتيجي للشعوب ( وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني وشعوب البلدان العربية ) وتشكل الخطر الأكْبَر على السلم، وهي أكبر منتج ومُصدّر ومُستخدم للأسلحة ولها أساطيل بجوب البحار ومئات القواعد العسكرية خارج أراضيها، فضلا عن زعامتها لحلف شمال الأطلسي العدواني وحمايتها للكيان الصهيوني والأنظمة الرجعية العربية…
الطاهر المعز
وردت العديد من البيانات بدراسة نشرها موقع معهد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (إسكران) تم الإطلاع عليها يوم الرابع من أيار/مايو 2025
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris



