-
Dennis Kucinich-La genèse de la violence sectaire en Syrie (sur le rôle des USA dans le massacre des Alaouites et des Chrétiens)

Je ne fais l’apologie d’aucun gouvernement. Je défends la transparence et le bon sens. Dans cet article, je détaille les politiques américaines, menées par de nombreuses administrations, qui ont abouti à cette catastrophe fabriquée de toutes pièces.
La genèse de la violence sectaire en Syrie par Dennis Kucinich
Dennis Kucinich-12 mars 2025
La chute d’Assad au profit des extrémistes soutenus par les États-Unis et le massacre des chrétiens et des alaouites
Alors que nombreux sont ceux à Washington qui prétendent défendre le christianisme et les valeurs occidentales, leurs politiques ont conduit à l’anéantissement systématique de certaines des plus anciennes communautés chrétiennes du monde. Ces mêmes hommes politiques qui se posent en défenseurs de la foi ont non seulement fermé les yeux sur les souffrances des chrétiens au Moyen-Orient, de la Cisjordanie et de Gaza en Palestine au Liban et en Syrie, mais ont également choisi de financer leurs meurtriers.
Les fonds publics américains, acheminés par l’intermédiaire de la CIA et de l’USAID, ont joué un rôle essentiel dans l’armement et l’activation de factions extrémistes dont l’ascension a donné lieu à des atrocités.
Le week-end dernier, les forces du nouveau président syrien par intérim autoproclamé, un musulman salafiste sunnite connu sous le nom d’Ahmed al-Shara, ont aligné des civils, alaouites et chrétiens, contre le mur et les ont exécutés. Leur crime : infidélité au salafisme, une interprétation stricte de la loi islamique.
Elizabeth et moi avons visité la Syrie à de nombreuses reprises. Nous l’avons parcourue et avons découvert un pays magnifique et laïc où l’identité syrienne était plus importante que la différence de foi, où les communautés fréquentant les églises, les synagogues et les mosquées vivaient en harmonie.
La Syrie a été déchirée au cours des dernières décennies par l’interventionnisme extérieur et l’ignorance, donnant naissance à l’extrémisme et à la pire catastrophe humanitaire du 21e siècle .
De nombreux chrétiens syriens ont historiquement soutenu le gouvernement Assad et son idéologie laïque baasiste parce qu’elle garantissait la liberté religieuse et protégeait les minorités.
Contrairement à certains mouvements islamistes, le régime d’Assad a maintenu un État laïc où les chrétiens pouvaient pratiquer leur foi sans être persécutés. Ils occupaient des postes au sein du gouvernement, de l’armée et des entreprises.
Les Alaouites constituent une minorité religieuse en Syrie, avec des communautés plus petites au Liban et en Turquie. La famille Assad, qui a régné de 1970 à début 2019, est alaouite.
La pratique alaouite de l’islam intègre des éléments du gnosticisme, du néoplatonisme et du christianisme. Elle se distingue des principales sectes islamiques. L’ancien président Assad a promu la laïcité, conformément au soutien alaouite à une gouvernance laïque.
Des vidéos bouleversantes des massacres de ces derniers jours ont fait surface : des Syriens alaouites et chrétiens implorent leur Sauveur tout en étant déshumanisés, sommés de ramper à quatre pattes et d’aboyer comme des chiens, se préparant à « mourir comme des chiens », sous un déluge de balles. On y voit les tueurs être sommés d’éteindre leurs téléphones et de ne pas partager ces vidéos afin de ne pas retourner l’opinion publique mondiale contre eux.
Les relations publiques sont toujours souhaitables pour dissimuler les meurtres de sang-froid et leurs desseins et pour protéger le fantasme de l’Occident selon lequel les nouveaux dirigeants autoproclamés de la Syrie sont plus gentils et plus doux que les descriptions propagandistes de leurs prédécesseurs.
Comment la situation en est-elle arrivée là ?
La crise humanitaire actuelle et les graves violences sectaires en Syrie sont le résultat direct de politiques remontant à la doctrine« Clean Break » de 1996, élaborée par un groupe de réflexion de Washington qui avait conseillé à Benjamin Netanyahu de faire une «Clean Break » avec le « processus de paix » du gouvernement précédent (citation), qu’il considérait comme une faiblesse grave.
La doctrine « Clean Break« a jeté les bases de politiques agressives envers la Syrie, qui ont émergé grâce à un effort coordonné par la Maison Blanche de Bush, alors que plusieurs auteurs de la stratégie de la Rupture Propre ont accédé à des postes de décision au sein du gouvernement fédéral.
L’approche de la «Clean Break» a été encore plus avancée par Hillary Clinton, qui, en tant que secrétaire d’État, a proposé, avec le directeur de la CIA, David Petraeus, d’armer les rebelles syriens.
La Maison Blanche a rejeté le plan, mais, d’une manière ou d’une autre, l’élan généré pour renverser Assad a été propulsé par la CIA, la directive présidentielle du président Obama de 2012, qui appelait explicitement au renversement du président syrien Bachar al-Assad, a simplement autorisé ce qui était en cours sans sa permission.
Ce n’était pas la dernière fois que la CIA trouvait un moyen de déstabiliser Obama en Syrie. Le 12 septembre 2016, un accord de cessez-le-feu était négocié par le secrétaire d’État américain John Kerry et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, visant à ce que les deux grandes puissances coopèrent pour limiter les groupes extrémistes.
Selon une source proche du dossier, Robert Malley, l’envoyé spécial d’Obama pour le Moyen-Orient, prévoyait de se rendre au Liban puis à Damas pour rencontrer Assad, afin de capitaliser sur le cessez-le-feu Kerry-Lavrov et d’ouvrir la possibilité d’une nouvelle direction dans les relations américano-syriennes.
Dès le lendemain, une frappe aérienne américaine tuait plus de 100 soldats syriens. Le voyage de Malley fut annulé et le cessez-le-feu prit fin quelques heures plus tard.
Le plan visant à renverser Assad a été mis en œuvre à grande vitesse. Obama a été manipulé par Hillary Clinton et la CIA en Syrie, tout comme il l’a été par elles en Libye.
Judicial Watch a obtenu des documents prouvant que l’Agence de renseignement de la défense américaine (DIA) était consciente que la stratégie de soutien aux forces d’opposition – composées en grande partie de factions salafistes et extrémistes, y compris des filiales d’Al-Qaïda – conduirait directement à l’établissement d’une « principauté salafiste » dans l’est de la Syrie, avec une interprétation stricte de l’islam sunnite.
La DIA a explicitement déclaré que ce résultat était précisément « ce que veulent les puissances qui soutiennent l’opposition, afin d’isoler le régime syrien ».
La Rupture nette, Benjamin Netanyahou, la CIA, Hillary Clinton, Barack Obama et l’Agence de renseignement de la Défense sont tous responsables de la désintégration de la Syrie, qui a donné lieu à d’extrêmes violences sectaires. La plupart des personnes tuées aujourd’hui n’étaient alors que des enfants, dans un pays où les communautés fréquentaient les mosquées, les églises et les synagogues.
L’argent des contribuables américains, acheminé par l’intermédiaire de la CIA et de l’USAID, a joué un rôle essentiel dans l’armement et l’activation des factions extrémistes dont l’ascension a conduit à ces atrocités.
En Syrie, les machinations américaines au Moyen-Orient ont atteint des sommets tragiques. Sous l’administration Obama, la CIA a lancé « Timber Sycamore » en 2012, une opération secrète qui a permis de transférer des milliards de dollars en armes et en formation à des soi-disant « modérés » liés à Al-Qaïda, Al-Nosra et Daech. Une grande quantité d’armes, payées par les contribuables américains et destinées à être utilisées contre la Syrie, a fini sur le marché noir.
On a raconté au peuple américain un conte de fées selon lequel nous soutenions les combattants de la liberté contre un dictateur. En réalité, nous avons financé les terroristes qui assassinent aujourd’hui des chrétiens, massacrent des villages alaouites et imposent un régime islamique radical dans les zones dont ils s’emparent.
Il s’agissait d’une intervention imprudente, motivée par une obsession géopolitique d’affaiblir l’Iran et la Russie. Elle a non seulement détruit la Syrie, mais a également créé un terreau fertile pour le terrorisme mondial.
L’aventure tant vantée du sycomore Timber Sycamore était censée avoir été stoppée par la première administration Trump, mais l’objectif de ce dernier, renverser Assad, s’est poursuivi sous l’administration Biden. Pour les étudiants en dendrologie, le sycomore est un arbre caractérisé par des branches fragiles et de grandes feuilles qui se décomposent lentement en tombant.
En réfléchissant aux politiques désastreuses de l’Amérique en Syrie, une question me hante : pourquoi les États-Unis poursuivraient-ils des stratégies qui ont conduit au massacre des chrétiens et des alaouites, à la destruction de communautés anciennes et au triomphe de l’extrémisme ?
Pendant des années, en tant que membre de la Chambre des représentants, j’ai pris la parole au Congrès pour tirer la sonnette d’alarme face aux politiques de changement de régime irresponsables. Je me suis opposé à la stratégie néoconservatrice de « rupture nette ».
En 2002, je me suis élevé contre la guerre en Irak, conscient qu’elle déclencherait des violences sectaires et offrirait un terreau fertile aux groupes djihadistes. En 2011, j’ai rejeté l’intervention illégale des États-Unis en Libye, avertissant que la chute de Kadhafi transformerait la Libye en un État en faillite et ouvrirait la voie aux extrémistes islamiques.
À chaque fois, j’ai été ignoré, écarté, voire vilipendé par ces initiés de Washington désireux de refaire le monde à leur image (et d’en tirer profit en le faisant), sans se soucier du coût humain.
J’ai exigé de la transparence.
J’ai exigé des comptes.
J’ai demandé une enquête du Congrès sur le rôle de la CIA dans l’armement des groupes extrémistes.
J’ai été accueilli par le silence officiel et par les moqueries publiques des médias.
En 2013, je me suis opposé au projet d’Obama de bombarder la Syrie, avertissant qu’une intervention militaire américaine ne ferait que renforcer les djihadistes. Lors de mon voyage en Syrie en 2017 avec la représentante Tulsi Gabbard, j’ai discuté directement avec des responsables chrétiens, des civils et des responsables gouvernementaux qui nous ont dit ce que les médias américains ont refusé de rapporter : les États-Unis n’aidaient pas le peuple syrien, ils le détruisaient.
Je suis revenu déterminé à révéler la vérité, à dire au peuple américain que nos impôts finançaient une guerre qui ciblait des innocents, des gens dont les familles vivaient dans la région depuis des siècles.
La plupart des médias grand public, fidèles à la thèse de la guerre, ont rejeté ces conclusions. L’establishment politique bipartisan a maintenu le cap, veillant à ce que les armes et les ressources continuent d’affluer entre les mains des extrémistes.
Aujourd’hui, après la chute d’Assad, le pire scénario s’est produit. Des villes qui abritaient autrefois certaines des plus anciennes communautés chrétiennes du monde sont en ruines, leurs habitants massacrés ou contraints à l’exil. Chrétiens et Alaouites sont qualifiés d’hérétiques par les groupes mêmes que l’Amérique a contribué à renforcer.
Et je demande encore : pourquoi ?
Pourquoi l’Amérique défendrait-elle des politiques qui conduisent au massacre de chrétiens, à la destruction d’églises, au massacre d’Alaouites et à la montée de djihadistes radicaux ? Pourquoi nos dirigeants ont-ils sciemment aidé ceux qui ont assassiné ceux-là mêmes que l’Amérique prétendait vouloir protéger ?
La réponse réside dans une politique étrangère corrompue et immorale, dictée non pas par l’éthique, les droits de l’homme ou même la sécurité nationale, mais par les intérêts du complexe militaro-industriel et des stratèges qui considèrent les vies humaines comme des pions dans un jeu d’échecs géopolitique.
Cette situation tragique en Syrie n’est qu’un exemple parmi d’autres du chaos qu’est la politique étrangère américaine ; l’Iran en 1953, le Guatemala en 1954, le Liban dans les années 1980, l’Afghanistan dans les années 1980-1990, jusqu’à l’Irak après 2003 sont des exemples notables de perfidie similaire, bien que ces débâcles ne soient en aucun cas exclusives.
La politique étrangère américaine révèle trop souvent des calculs visant à exciter et à exploiter les divisions sectaires, religieuses ou ethniques pour atteindre des objectifs géopolitiques vaniteux qui se soldent par une désintégration et une défaite.
Comme une coterie de Snidley Whiplashes « Malédictions, encore déjouées ! », nos génies politiques ignorent la dévastation qu’ils ont provoquée et se lancent tête baissée dans la préparation des prochains désastres : de futures guerres civiles prolongées, des persécutions systémiques, des souffrances humaines massives, des crises de réfugiés et une instabilité politique durable.
L’exacerbation délibérée des tensions sectaires a à maintes reprises affaibli les États, renforcé les groupes extrémistes et fait d’innombrables victimes innocentes. Elle perpétue la souffrance humaine à grande échelle. Elle a gravement terni la réputation internationale des États-Unis. Elle a favorisé l’extrémisme, l’instabilité et la persistance des conflits.
J’ai consacré ma carrière à lutter contre ces guerres d’agression. J’ai mis en garde contre le fait que les opérations de changement de régime ne mènent jamais à la paix, mais seulement à davantage de souffrances.
Aujourd’hui, avec la chute du gouvernement Assad, la Syrie aux mains des extrémistes, le cauchemar dont j’avais parlé, avec d’autres, est devenu réalité. La guerre en Syrie, alimentée par l’intervention américaine et ses opérations secrètes, a conduit au résultat même que les interventionnistes prétendaient empêcher : un bain de sang.
Les néoconservateurs, les interventionnistes et les profiteurs de guerre ont atteint leurs objectifs, leurs machinations blanchies par des médias grand public imprudents et complices, dont la naïveté ignorante ou la tromperie délibérée ont ouvert la voie à ces atrocités. Un autre gouvernement renversé, une autre nation en ruine, et une autre génération d’innocents payant le prix d’une arrogance métastatique.
Les Américains croient en la liberté religieuse. Notre gouvernement ne la pratique pas à l’étranger.
Les Américains croient en la dignité humaine. Notre gouvernement la pulvérise dans d’autres pays, avec l’argent de nos impôts.
Les Américains aspirent à la paix. Mais nous n’y parviendrons jamais tant que nous n’aurons pas reconnu que notre propre gouvernement a dépensé des milliers de milliards de dollars de nos précieux impôts pour attiser les conflits et déclencher des guerres, au profit de quelques-uns et au détriment manifeste du reste d’entre nous.
J’ai fait tout ce que j’ai pu pendant mon mandat. Aujourd’hui, je prie pour ceux qui souffrent sous le joug de l’oppression que nous avons causée, et je prie pour que l’Amérique change de cap.
Dennis Kucinich

Source : https://arretsurinfo.ch/la-genese-de-la-violence-sectaire-en-syrie/
-
Laure Lemaire: DOM-TOM-Guadeloupe et Martinique: la colonisation commence en 1636


Depuis l’île Saint-Christophe.en1635, Charles Liènard de l’Olive et Jean du Plessis d’Ossonville envoyés par d’Esnambuc débarquent en Guadeloupe à la Pointe Allègre (Sainte-Rose), et prennent possession de l’île, mandatés par le représentant de laCompagnie des îles d’Amériquede Richelieu. Ils firent planter du coton, du tabac et de l’indigo. Ils entrèrent en conflit avec les Caraïbes
En 1635, D’Esnambuc débarque dans la rade de Saint-Pierre en Martinique avec 150 colons français Il a décidé de s’y installer après la Guadeloupe avec ses 2 capitaines français, de l’Olive et du Plessis qui en sont repartis, ne trouvant pas l’île propice à l’établissement d’une colonie. D’Esnambuc au contraire, s’attelle à en prendre possession car c’est une zone stratégique pour lutter contre l’Espagne. Il y installe une 1° colonie dans la partie ouest de l’île, pour le compte de la couronne de France et de sa Compagnie. Les 1° établissements sont Le Fort Saint-Pierre fondé par d’Esnambuc, et la ville du Fort-Royal (Fort-de-France) fondée par les gouverneurs De Baas et Blenac.
Le processus de colonisation est accompagné de missionnaires, dont l’objectif est l’évangélisation des populations nouvellement colonisées, avec un Père de l’ordre des Capucins. Par la suite, d’autres ordres religieux vont venir s’installer dans la colonie martiniquaise. La « spiritualité » est un moteur de la colonisation cherchant à faire naitre chez les colonisés une conscience européenne qui passe par l’évangélisation.
1-Révoltes des Kalinagos et guerres de répression
La 1° grande révolte semble s’être déroulée à Saint-Christophe en 1626, selon Jean-Baptiste Du Tertre, religieux et botaniste. Cela concerne Pierre Belain d’Esnambuc parmi les colons français. 4 000 insurgés derrière le chef kalinago Ouboutou Tegremante aurait réuni les Amérindiens de plusieurs îles. Une 1° embuscade aurait causé la mort d’une centaine de colons anglais et français. La répression aurait provoqué le massacre de 2 000 révoltés et la fuite des autres. Ils sont pourchassés, et les survivants sont expulsés en 1640 sur l’île de la Dominique. Peu après, arrivent les 1° bateaux négriers (pour la colonie française de Saint-Christophe) : le commerce des esclaves (triangulaire) est autorisé par Louis XIII en 1642, pour les possessions françaises.mais ne se développera que plus tard en Martinique et en Guadeloupe
En 1636, le 1° massacre de Caraïbes commence. La vie des colonisateurs devient très difficile (la faim), car les Caraïbes des autres îles accourent pour venir au secours de leurs frères. Les Caraïbes de la Martinique résistent plus longtemps qu’à la Guadeloupe où un traité est signé dès 1641 par de L’Olive pour les déporter à la Dominique. L’expansion des Français créée des tensions et un conflit continu . A la mort du gouverneur du Parquet, éclate la guerre de 1658 contre les Indiens caraïbes, qui permet de resserrer les rangs des colons. + de 600 Français se regroupent avec la bénédiction des prêtres de l’île (jésuites et dominicains) pour les attaquer sur leurs territoires réservés par l’accord de paix de 1657, avec la volonté d’éliminer toutes présences indigènes dans l’île. Les Caraïbes sont massacrés et perdent leurs derniers territoires. Les survivants se réfugieront à Saint-Vincent et à la Dominique. De là, ils organiseront par la suite plusieurs expéditions punitives.
La Dominique est située entre les îles françaises des Saintes et de Marie-Galante (2 dépendances de la Guadeloupe) au nord, et de la Martinique, au sud. Britannique, l’île a connu une présence française jusqu’au .traité de Paris de 1763. Ils y implantent la culture du café. En 1625, lors de la guerre de 30 Ans, les Espagnols la cède aux Français puis les Anglais les affrontent pour sa possession; leurs canonnades détruisent totalement la ville de Roseau. En 1660, Français et Anglais abandonnent l’île aux Kalinagos (Caraibes) et la déclarent zone neutre ; pour mettre fin aux conflits, un traité de paix est signé entre les Français, les Anglais et les Kalinagos. Cependant, les Britanniques s’approprient l’île en 1759.

Des révoltes “logiques”
En situation coloniale, tout le Nouveau Monde (à partir de 1500), après les 1° contacts, et les cultures vivrières pour les entrants, a vu divers scénarios se dérouler mais le plus fréquent est l’implication, domination, soumission, relégation, déportation (pour travail forcé / servage / esclavage ( des Autochtones) de tout ou partie de la population indigène, l’accaparement de(s) terres coutumières (collectives, traditionnelles), la déforestation pour l’élevage et/ou la culture d’exportation. L’expression “choc des cultures” devrait plutôt être remplacée par “mort d’une culture”, du fait des compagnies commerciales européennes. Dans le contexte caribéen, le tabac, l’indigo, le coton et la canne à sucre vont être pour longtemps des éléments déterminants (emploi, production, export). La rapide importation d’esclaves d’origine ouest-africaine est évidemment une donnée complémentaire.
Après plaintes, protestations, promesses ou négociations (ou non), des oppositions se manifestent de la part des indigènes, suivies de révoltes logiques, souvent violentes. Peu sont documentées évidemment et les suites sont prévisibles : répression, fortifications militaires, massacres.
En 1660, Charles Houël invite dans sa luxueuse résidence de Houëlmont, en Guadeloupe, 15 chefs caraïbes pour signer un traité de paix avec les Français et les Anglais à la fois. L’idée est de pacifier la Caraïbe pour faciliter le commerce et l’expansion sucrière. Si bien qu’en 1662, le Baron de Windsor, 35 ans, arrive à la Barbade, en prévision de son mandat de gouverneur de la Jamaïque. Puis, il envoie son navire à Santo Domingo et Cuba pour demander aux gouverneurs espagnols l’autorisation d’effectuer à nouveau du commerce, en expliquant que désormais prévaut la paix, entre les puissances européennes et avec les Caraibes
2- La Compagnie des îles d’Amérique de Richelieu- 1635
Dès ses débuts en 1635, la Compagnie des îles d’Amérique, dont le Cardinal Richelieu est le 1° actionnaire, a signé avec Daniel Trézel, marchand rouennais d’origine hollandaise un contrat demandant de démarrer la production de canne à sucre, et en reverser 10 % des profits. Ses 2 fils le rejoignent en 1639: François à la Martinique, Samuel à la Guadeloupe, dont le moulin sera opérationnel en 1643. La Compagnie ordonne de détruire tous les plants de tabac des petits propriétaires et en 1639, lui accorde le monopole la canne à sucre, dans l’ îles où sa culture est moins avancée, la Martinique. À la Guadeloupe, où les terres sont faciles à cultiver, Daniel Trézel loue son moulin aux autres planteurs. Il n’obtient pas de monopole, mais 2 plantations.
La Compagnie le soutient financièrement par un prêt de la 1/2 du montant, tout en offrant de payer le transport d’Europe de « quelques machines ou engins à sucre ». Face à cette insistance de la Compagnie, Daniel Trézel obtient en 1640 de nouvelles exemptions fiscales et des engagements fermes pour ses fils
Reste le problème de la main-d’oeuvre. La flibuste est le principal moyen d’appropriation des esclaves, loin devant les achats aux Portugais. Le contexte géopolitique lui facilite la tâche :L’Angleterre est en conflit dès 1627 avec la France s’en prenant à ses colonies, tandis que se déroule la guerre hispano-française (1635-1659). Des esclaves sont capturés à l’ennemi. Les Espagnols sous-traitaient aux Portugais l’asiento, monopole d’importations des esclaves, sous l’autorité du Pape. Les esclaves resteront très minoritaires pendant 12 ans
Dès 1628, la compagnie de Rouen du navigateur Jean Rozée, associé à Daniel Trezel en 1638 de la Compagnie des îles d’Amérique, avait été fondée pour le monopole du commerce au Sénégal où un comptoir fut installé, suivi du fort Saint-Louis, donnant en 1659, naissance à la ville de Saint-Louis, où il fonde la Compagnie du Sénégal, chargée d’y vendre des armes.
Daniel Trézel signe un contrat avec Jean Rozée pour se faire livrer 100 esclaves noirs pour 200 livres par esclave. Le commerce des esclaves est autorisé par Louis XIII en 1642. A la Guadeloupe, la demande en « Noirs » de De l’Olive se fait pressante . La date de l’arrivée de navires négriers est 1643, 5 ans après la 1° commande d’esclaves d’où le recours aux engagés blancs. En 1639, David Le Baillif, d’une autre grande dynastie rouennaise de marchands, fonde une société pour importer des esclaves à la Martinique sur des plantations de tabac et deviendra propriétaire de 4 plantations.
3-Les engagés – 1635
À l’origine, l’engagisme est un système juridique de recrutement, sur la base du volontariat (dû à une grande misère), de travailleurs pour les plantations coloniales . Cette forme atténuée de servage commence sous Richelieu et concerne des travailleurs français. On les appelait alors les «36 mois », car ils étaient obligés de servir durant 3 ans, pendant lesquels leurs maîtres pouvaient disposer d’eux à leur gré et les employer à ce qu’ils voulaient. En d’autres lieux et plustard, les bagnards feront l’affaire. Une fois la période de 36 mois écoulée, ils étaient libres, pouvaient acheter des terres s’ils disposaient d’argent, ou bien de retourner en France. Cette méthode de recrutement fut très utilisée au XVIIe siècle. Puis, en raison de la dureté des conditions de travail et du besoin croissant de main-d’œuvre, l’ engagisme disparaît au profit de l’esclavage, de la traite négrière africaine. La Révolution française abolit l’esclavage donc l’engagisme est redevenu une forme de salariat d’abord réservée aux travailleurs créoles natifs des colonies (anciens esclaves) puis ouverte aux “immigrés forcés” d’Afrique et d’Inde. Cet engagisme sur la base du “volontariat”, se rapproche beaucoup de la traite .
Charles Houël achète les 60 Noirs qui arrivent à la Guadeloupe sur un navire anglais. Mais la Compagnie avait besoin de 50 artisans qualifiés. En 1645, Houël revient de France avec une centaine d’engagés blancs. Les 3 îles françaises en ayant déjà importé 7000 en 7 ans et + d’une centaine de Noirs, elle recherche surtout des artisans très spécialisés.
150 Normands débarquent en 1635 à la Pointe Allègre (Sainte-Rose), avec 4 prêtres dominicains. Ils sont tous des engagés par contrat de 3 ans, auprès d’un maitre qui a le droit de les revendre, car il a payé leur traversée. (Pas longtemps et peu réussiront à faire fortune avant que terres ne deviennent hors de prix).

4- La culture du sucre
150 Normands débarquent en 1635 à la Pointe Allègre (Sainte-Rose), avec 4 prêtres dominicains. .La canne à sucre qui nécessite beaucoup de main d’oeuvre contrairement aux autres (tabac) est déjà prévue dans leur contrat avec la Compagnie des îles d’Amérique. Ils sont tous des engagés par contrat de 3 ans, auprès d’un maitre qui a le droit de les revendre, car il a payé leur traversée. (Pas longtemps et peu réussiront à faire fortune avant que terres ne deviennent hors de prix).
Depuis 1638, il avait 2 associés « pour le commerce des îles », le banquier parisien Desmartin qui a effectué les avances de fonds et le capitaine Rigaud, propriétaire d’un vaisseau qui se met en affaire pour des moulins à sucre avec le frère d’Adam Raye, de Rouen, qui a « résidé avec les Hollandais à Pernambouc », au Brésil.
Les 1° moulins à sucre de 1640 sont installés en Martinique en même temps qu’en Guadeloupe et Barbade(Brit), sur fond d’effondrement de la production sucrière neerlandaise au Brésil, Les plus riches des Hollandais avaient fui le Brésil, où les planteurs de sucre portugais menés par João Fernandes Vieira se sont insurgés, ce qui fait monter le cours du sucre, rendant lucrative sa culture dans les 3 îles. Ces moulins (invention néerlandaise) utilisent des bœufs, chevaux ou mulets pour mouvoir le système de pressage de la canne, permettant d’en extraire un jus pour faire de la mélasse, du sucre roux ou du sucre blanc, raffiné après chauffage
Les 7000 engagés (en 1642) du banquier parisien travaillaient d’abord « au milieu des esclaves », et « avec le même outillage » au bénéfice de la Compagnie, dans chacune des 3 îles, Saint-Christophe, Martinique et Guadeloupe. Elles se lancent dans les cultures coloniales : tabac et coton mais surtout le sucre, car l’offre mondiale de sucre est déficitaire à cause de la guerre entre Hollandais et Portugais qui ravage le Brésil depuis 1630 (1/3 des moulins à sucre sont détruits).
La compagnie s’engage à installer, en + des 60 esclaves, 50 « artisans de tous mestiers à la construction des bastimens, halles et magazins, culture des cannes et autres ouvrages ». Charles Houël,en 1645, revient de France avec une centaine d’engagés blancs. Les 3 îles françaises en ayant déjà importé 7000 en 7 ans et + d’une centaine de Noirs. A Saint-Christophe, une plantation de canne à sucre dispose de 100 esclaves et 200 « domestiques », soient des engagés blancs.
Mais ces engagés blancs, aussi appelés « alloués »., parfois aussi utilisés à la fortification des îles, sont célibataires et craignent de le rester une fois leur contrat de 3 ans terminé, Pour leur offrir des perspectives de mariage, la Compagnie promeut l’importation de femmes de Dieppe à la Guadeloupe. La ville de Basse-Terre est fondée dans le Sud de l’île et en 1645, + de 200 orphelines apprennent à lire, écrire, coudre, tricoter et broder, dans le Couvent la Divine Providence, dirigé par Benoit Brachet. Léonore de La Fayolle, munie de lettres de la Reine, reçoit la somme de 200 livres pour convoyer des orphelines aux îles

6- Les “seigneurs-prpriètaires privés”
La Guadeloupe fut considérée « comme celle de toutes les isles qui est la plus propre à la nourriture des cannes » même si la Grande-Terre (une des 2 ailes du papillon) au climat plus sec que la Basse-Terre et à la végétation moins dense, sur les mornes d’un atoll surélevé où se repliaient les Caraibes, fut d’abord évitée au début, tandis que la croissance du sucre en Basse-Terre a subi un coup de frein à cause de 3 cyclones en 15 mois (1655-1656), une famine, un soulèvement d’esclaves et une révolte contre les excès de Houël.
Le 1er novembre 1755, la Martinique et les Petites Antilles sont balayées par le raz-de-marée provoqué par le tremblement de terre de Lisbonne. Les communes de La Trinité, de Fort-Royal et du Lamentin sont les plus touchées.
La Barbade anglaise, en forte expansion entre 1645 et 1649, lui offre une forte concurrence. Ses engagés blancs permettent à la culture du sucre d’y décoller dés le milieu des années 1640, Lors de la décennie précédente, les cultures de tabac, de coton et d’indigo de la Barbade avaient lancé l’exploitation à grande échelle de cette main d’œuvre, d’abord composée d’adolescents pauvres obligés de se vendre en Irlande, où les conflits militaires et la spéculation foncière de 1630 leur a rendu l’agriculture aléatoire. Avec la 1° révolution anglaise, près de 4 000 personnes, émigrent à la Barbade dans les années 1640, les pauvres engagés et les aristocrates y apportent les capitaux. Résultat, à partir de 1643, le prix de la terre à la Barbade double chaque année et ne se stabilisera qu’au milieu des années 1650.
En Guadeloupe même, le Père breton souligne qu’en 1647, le sucre « vient fort bon et excellent » avec « des cannes, grosses et succulentes », grâce à 3 facteurs : tous les planteurs ont le droit d’utiliser le moulin de Daniel Trézel de la compagnie, tandis que sa propre plantation, bien distincte, l’utilise aussi. Son fils, Samuel Trézel, qui gère cette plantation, s’est engagé à rester 6 ans, en échange de 1/10 des sucres fabriqués..
L’achat de la Guadeloupe en 1649 par Charles Houël, gouverneur de l’île depuis 1643 permet de rembourser le marchand de Rouen Jean Rozée, actionnaire et créancier. Jean de Boisseret régle les dettes de la compagnie envers des « engagés » artisans qui n’avaient pas été payés, déclenchant des plaintes et poursuites de leurs femmes à La Rochelle dès 1646.
Un an après, Du Parquet, gouverneur de la Martinique en devient le propriétaire de la Martinique, ainsi que de la Grenade, des Grenadines et de Saint-Lucie pour 2/3 du prix payé pour la Guadeloupe. Il a exploité la culture du sucre pendant 10 ans et l’achète lorsque la Compagnie est ruinée..Et en 1651 c’est au tour de Saint-Christophe, d’être vendue à son gouverneur Poincy, qui est déjà propriétaire de 200 engagés blancs et 100 esclaves en 1645.
Charles Houël et Jean de Boisseret se font ériger chacun un fort sur les bonnes terres Ils en donnent une partie aux missionnaires Carmes et aux Jésuites, partisans de « l’évangélisation » des esclaves, jouant de leur rivalité avec les Dominicains, jusqu’alors les seuls missionnaires de l’île. À partir de 1649, sous ce nouveau régime de propriétaires privés qui n’ont de comptes à rendre à personne, c’est « l’obscurité quasi-complète » sur leurs revenus et patrimoines. Il apparait cependant que de Poincy a doublé le nombre de ses employés, esclaves et engagés, entre 1650 et 1654. En 1647, le missionnaire carme Maurile de Saint-Michel l’a visité et écrit que le sucre était « la 1° marchandise de nos îles », Poincy en retirant « tous les ans la valeur de 30 000 écus ».
D’abord, l’île est productrice de denrées coloniales fournissant de forts profits : tabac (petun très apprécié), roucou, indigo, cacao. La crise du tabac de la 2° ½ du XVIIe siècle ruine les 1° planteurs qui se tournent vers le sucre. La monoculture de la canne va modeler le paysage et devenir partie intégrante de la culture créole. Elle dominera l’économie du pays jusqu’à la 2° 1/2 du XXe siècle.
La culture de la canne à sucre telle qu’elle est pratiquée dans « l’habitation sucrière » demande une importante main-d’œuvre que la métropole ne peut fournir. Si la culture du tabac ou de l’indigo avait pu se faire avec les « engagés », la traite d’esclaves noirs provenant des côtes de l’Afrique est avancée comme unique solution pour fournir les effectifs nécessaires.
Les engagés, à la différence de l’esclave, s’il réussissait à survivre aux terribles conditions de vie et de travail pendant 36 mois, recouvraient leur liberté et se voyaient allouer une terre leur permettant de devenir à leur tour “petit” planteur.
La culture de la canne devient synonyme de traite négrière par le commerce triangulaire (Europe, Afrique, Amérique) entre les ports français (Bordeaux, Nantes) et la colonie. Par manque chronique d’espèces métalliques, le troc domine, tandis que la piraterie maintient le danger, même en périodes de paix.
Le sucre est une culture violente, qui nécessite de grandes propriétés et « consomme » des esclaves jeunes, rapidement épuisés par le travail intensif de la coupe et du transport des cannes, effectué sous la menace du fouet. Leur espérance de vie étant particulièrement basse, il faut souvent les remplacer.

7- L’initiateur de l’esclavagisme aux Antilles est Louis XIV
L’explosion du nombre d’esclaves correspond aux décisions prises à Versailles par Louis XIV en 1674. Entre 1674 et 1680, le nombre d’esclaves en Martinique double. Entre 1673 et 1700, il a déjà sextuplé.
Le remplacement de la Compagnie des Indes occidentales de Colbert, en 1673, par la compagnie du Sénégal entraîne une multiplication par 4,5 dans les 14 années qui suivent. De 1687 à 1700, la progression se poursuit plus lentement (+32 % en 13 ans), selon L’Administration des finances en Martinique, 1679-1790, de Gérard Marion. La traite négrière est alors ouverte à tous les ports français pour la doper par la concurrence. La Guadeloupe et la Martinique passent sous l’autorité directe du roi Louis XIV, qui pousse la culture de la canne à sucre, plus gourmande en capitaux mais beaucoup plus rentable, en donnant des terres à des officiers supérieurs en Martinique, où le sucre est moins développé qu’à la Guadeloupe.
Louis XIV avait croisé dès 1669 la marquise de Maintenon, dite « la belle indienne » car elle a passé son enfance en Martinique. Le roi prête aussi l’oreille à son ministre de la Défense, Louvois qui dirige la coûteuse guerre de Hollande (1672-1676), contre l’avis de Colbert et contre les Pays-Bas, détenteurs de l’asiento. (Un asiento est une convention de la monarchie espagnole qui conférait à des acteurs privés le monopole d’exercer une compétence de l’État : commerce des esclaves noirs, prélèvement d’un impôt, transfert de fonds, exploitation d’une route commerciale). La Compagnie du Sénégal, comme la Compagnie de Guinée qui lui succède en 1700, institue la traite négrière à grande échelle. L’investissement des Français et des Anglais dans le commerce triangulaire, massif et simultané, fait flamber le prix des esclaves. Il contribue à l’essor des ports français de Nantes et de Bordeaux, il fait en même temps baisser le coût du transport des esclaves au profit des planteurs de sucre. Les forts se multiplient sur le littoral africain. En 7 ans, le nombre d’esclaves double en Martinique. En 25 ans, il sextuple La Guadeloupe est rattrapée.
Le Tabac de Virginie La spéculation immobilière sur les terres à sucre éjecte les Blancs les moins fortunés, par ailleurs pénalisés par la ferme du tabac (taxe) de 1674 par Louis XIV d’où la ruine rapide du tabac français. Le tabac produit en Virginie profite de la contrebande qui passe de 2 000 esclaves en 1671 à 110 000 en 1750. Les exportations de tabac de la Virginie et du Maryland sextuplent entre 1663 et 1699 avec le « passage du travail des Blancs à la main-d’œuvre noire »,
Capitaine du navire la Sybille, en 1672, lors de la guerre contre les Hollandais puis revenu en France en 1673, Charles François d’Angennes vend son château et son titre à Françoise d’Aubigné, favorite de Louis XIV, qui devient marquise de Maintenon. Puis, en 1675, il repart combattre les Hollandais. Nommé gouverneur de Marie-Galante en 1678, il vit en Martinique au village du Prêcheur, où il signa un contrat avec la Compagnie du Sénégal, pour recevoir une partie des 1 600 esclaves africains qu’elle s’est engagée à livrer en 4 ans. C’est le 1° client de la Compagnie du Sénégal, le plus riche planteur de sucre de la Martinique. Il lui commande 1 600 esclaves en 1679. Il a le monopole du commerce sucrier avec le Venezuela espagnol et abrite au Prêcheur, 2 paroisses jésuites, où vivent le 1/4 des esclaves de Martinique en 1680.
Le roi lui donne en 1682 le monopole du commerce entre le Venezuela et les Antilles françaises, et le droit de raffiner du sucre sur place, alors que les autres planteurs devaient exporter la matière brute vers la France; c’est le plus riche planteur de canne à sucre de la Martinique.
Louis XIV donne terres et titres de noblesse à tout planteur qui installe sur ses terres plus de 100 esclaves. Dès 1680, on recense en Martinique, 99 plantations de plus de 20 esclaves, 5 fois plus qu’en 1669.
Entre 1674 et 1692, le nombre de sucreries double. Saint-Pierre de la Martinique devient la capitale des Antilles françaises. Les esclaves les plus jeunes et les plus résistants sont réservés à l’élite de grands planteurs nobles. Le code noir de 1685 limite le métissage et règlemente la torture des esclaves.
-
الطاهر المعز-ملامح الإقتصاد الأمريكي سنة 2025

ملامح الإقتصاد الأمريكي سنة 2025 : الطاهر المعز
فرضت الولايات المتحدة رُسُومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات الولايات المتحدة من الصين، خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، وفرَضَ رسومًا جمركية أخرى ( فضلا عن الرسوم التي فَرَضَها سَلَفُه جوزيف بايدن) على واردات الولايات المتحدة من الحُلفاء كالإتحاد الأوروبي وعلى الشركاء الذين تربطهم بالولايات المتحدة اتفاقيات دولية مثل كندا والمكسيك بنسبة 25% غير إن زيادة الرسوم سوف ترفع الأسعار في السّوق الدّاخلية للولايات المتحدة، وتزيد من نسبة التّضخم، أي سوف تكون النتيجة مُعاكسة لما وعد به ترامب من خفض التضخم، كما وَعَد بعودة الإستثمارات الصناعية إلى الولايات المتّحدة، غير إن تركيز الصناعة لا يقتصر على الإستثمار في المصانع، بل يستوجب تَوفُّر البنية التحتية وتوفير السّكن ووسائل النقل العام والتعليم والرعاية الصحية، لأن الولايات المتحدة فَقَدَت الرّيادة الصّناعية، خلال عقد الثمانينيات مكن القرن العشرين مع رئاسة رونالد ريغن، رَمْز النيوليبرالية، والأَمْوَلَة (financialization ) وهي نقيض الرأسمالية الصناعية، واتّسمت النيوليبرالية بخصخصة البنية التحتية، ليضطرّ العُمال والموظفون إلى دفع تكاليف باهظة للتعليم الذي كان مجانيًا، وللمواصلات وللرعاية الصحية التي كانت مدعومة…
إن التهديد الأمريكي بتحطيم الاقتصاد الدولي أو اقتصاد الشركاء التجاريين قد يُؤدّي إلى تحطيم اقتصاد الولايات المتحدة، لأن عولمة الإقتصاد أدّت إلى تشابك المصالح، ويُتوقّع أن يُساوم دونالد ترامب حلفاءه ومنافسيه وخصومه وابتزازهم كي يدفعوا مُقابل تأجيل أو خفض الرُّسُوم الجمركية، وبدأت الضّغوط الأمريكية على كندا لكي تبيع بعض القطاعات الصناعية للأثرياء وللشركات التي دعمت دونالد ترامب خلال حملة الإنتخابات الأخيرة، غير إن معظم الرأسماليين الأمريكيين ( ومن ضمنهم دونالد ترامب ) لا يستثمرون في الصناعة المُنتجة – باستثناء التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة الزائدة المرتفعة – بل يميلون إلى الإستثمار في التمويل والمضاربة والإقراض الافتراسي ( المُفْترس).
يبني دونالد ترامب سياساته على أساس عدم توفّر أي بديل للدّول الأخرى، ولذلك فهي مُضطرة ( نظرًا لأهمية ولاتساع السوق الأمريكية ) للقبول بالشروط الأمريكية، غير إن بوادر التّمرّد المُحتشم بدأت تظهر في أوروبا التي هدّدت بالرّد بسرعة، وأعلن وزير المالية الفرنسي إن أوروبا لن تكون كبش فداء سياسات دونالد ترامب، كما حصل سنة 2018، وتوقّعت صحيفة فاينانشال تايمز أن تردّ أوروبا عبر » إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية في توظيفاتها التجارية، مثل تنزيلات البرمجيات وأجهزة البث، وتقييد نشاط شركات وادي السيليكون، مثل فيسبوك وإكس وغوغل… وربما منع الاستثمار الأجنبي المباشر أو تقييد وصول مجموعات الخدمات المصرفية والمالية إلى الأسواق… « ، مما قد يُؤَدِّي إلى عزل الولايات المتحدة وتدمير اقتصادها، لو كانت أوروبا جادّة بالفعل، لكن دول الإتحاد الأوروبي خضعت لقرارات الولايات المتحدة بمقاطعة روسيا وخفض التعامل التجاري مع الصّين، وأدّى هذا الخضوع إلى أزمات متتالية في أهم البلدان الأوروبية ( ألمانيا وفرنسا وإيطاليا…)
تُشير البيانات التي نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز إن الولايات المتحدة تمثل 15,9% فقط من الواردات العالمية، سنة 2024، متبوعة بالاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية والصين في المرتبة الثالثة، بفوارق صغيرة، ولذلك فإن دول العالم قادرة على مقاطعة الولايات المتحدة تجاريا، لو توفّرت الإرادة السياسية، وأشار تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية تنمو بسرعة أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما يعني أن الجزء الأكبر مما تنتجه البلدان يتم استهلاكه في الداخل، وإن النمو يقود التجارة، وليس العكس.
قد يتضرّر الإقتصاد الأمريكي من زيادة الرسوم لأن حوالي 60% من صادرات الصين إلى الولايات المتحدة يتم إنتاجها في المصانع المملوكة أمريكيًا للشركات الأمريكية في الصّين، فقد جنت شركة تسلا 22 مليار دولار من مصانعها في الصين سنة 2023، أو ما يُعادل 25% من إيراداتها، كما إن نسبة كبيرة من صادرات كندا والمكسيك هي من إنتاج الشركات الأمريكية وفُرُوعها، وبالتالي فإن زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية أو الكندية أو المكسيكية إلى الولايات المتحدة تُؤدّي إلى زيادة تكاليف الإستهلاك وإلى انخفاض أسعار أسهم تلك الشركات الأمريكية مع انخفاض أرباحها. من جهة أخرى تُؤدّي زيادة الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث أزمة مالية، وإلى زيادة تكلفة معيشة الشعب الأمريكي، لأن الطبقة العاملة الأمريكية تستهلك السّلع المستوردة من الصين أو المكسيك نظرًا لانخفاض ثمنها في الأسواق الأمريكية، وهو سِرّ انخفاض التضخم في أمريكا طيلة أربعة عُقُود، فالعالم يزود الولايات المتحدة بسلع رخيصة جدًا، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وقدّرت وكالة رويترز إن ضريبة بنسبة 25% على النفط الكندي ستؤدّي إلى زيادة أسعار البنزين بأكثر من 40 سنتًا للغالون في أجزاء كبيرة من الغرب الأوسط الأمريكي، وقد يرتفع سعر الأخشاب المستورَدة من كندا بأكثر من 20% مما سَيَضُرُّ بقطاع الإسْكان.
يتوقع المُستشارون والخُبراء المُحيطون بدونالد ترامب إن زيادة الرسوم الجمركية سوف تُؤدّي إلى انخفاض أسعار السلع الأمريكية الصنع وارتفاع أسعار السلع الأجنبية، مع انخفاض العجز ( الذي يُقدّر بتريليونَيْ دولار بنهاية سنة 2024) وانخفاض أسعار الفائدة، ويشيرون إلى قرارات شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، التي أعلنت عن خطط لاستثمار مائة مليار دولار في أريزونا، غير إن إعادة بناء قطاع التّصنيع الأمريكي صعبة نظرًا لتراجع وظائف التصنيع الأمريكية منذ عُقُود بسبب الأتمتة والسياسات التجارية وصعود الصين والتحولات في سلوك الشركات، وفق موقع صحيفة « واشنطن بوست » بتاريخ التّاسع من آذار/مارس 2025، وأشارت نفس الصحيفة إلى انخفاض جاذبية الولايات المتحدة وانخفاض أعداد الأجانب القادمين إليها، بفعل سياسات دونالد ترامب، فقد أنفق السائحون الأجانب نحو 170 مليار دولار في الولايات المتحدة سنة 2024، وتتصدّر الولايات المتحدة إيرادات الدّول من السياحة الخارجية، وأنفق الطّلبة الأجانب أكثر من ستين مليار دولارا على الرسوم الدراسية في الكليات والجامعات الأمريكية سنة 2024…
عرف الإقتصاد الأمريكي حالة رُكود كل سبع سنوات تقريبًا في المتوسّط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد يُؤَدِّي فَرْضُ تعريفات جمركية مُرتفعة على الشُّركاء التجاريين الرئيسيين ( الصين وكندا والمكسيك والإتحاد الأوروبي…) إلى رُكود اقتصاد الولايات المتحدة ( الرّكود = انكماش الإقتصاد المحلي لفَصْلَيْن مُتتالِيَّيْن)، حيث ظهرت بعض المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأميركي، بفعل زيادة مخاوف الأسواق من تأثير الرسوم الجمركية – رغم الأرقام الإيجابية – بحسب موقع صحيفة « وول ستريت جورنال » ( 14 آذار/مارس 2025)، وتوقعت تحليلات أخرى لوكالة رويترز ومصرف « جي بي مورغان » احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، لأن تطبيق فرض الرسوم الجمركية قد يضعف ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية. أما مخاطر فترات الرّكود ( ولو كانت قصيرة الأمد ) فتتمثل في إفلاس الشركات الصغيرة ( وأحيانًا الكبيرة ) وتسريع العُمّال، وتبديد الدّولة المال العام لمساعدة الشركات، وقد يتسبب الركود في عجز المُقترضين عن سداد الدّيُون والرُّهُون العقارية، وفي تكثيف عمليات البيع في سوق الأسهم واضطرابات في سلاسل التوريد، وارتفاع في الأسعار وانخفاض في الأرباح، ولذلك توتّرت الأسواق المالية وارتفعت خسائر الأسواق المالية الأميركية إلى أكثر من ثماني تريليونات دولار خلال الأسابيع الأولى من فترة رئاسة دونالد ترامب التي بدأت يوم العشرين من كانون الثاني/يناير 2025، وعادة ما يلجأ الإحتياطي الفيدرالي إلى معالجة مثل هذه الأزمات بخفض أسعار الفائدة…
تضرّرت شركة تِسْلا للسيارات الكهربائية ( التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، حليف ومُمَوّل الحملة الإنتخابية لدونالد ترامب) من الحرب التجارية التي أطلَقَها دونالد ترامب، وسوف ترتفع تكاليف إنتاج عَرَباتها المُصنّعة في الولايات المتحدة، مقارنة بسعر العربات التي تصنعها حاليا في الصّين، لأن الشركة مُضطرّة إلى استيراد المواد الخام والمكونات من دول أخرى، وقد تتعارض إجراءات دونالد ترامب مع دعم قطاع الطناعة الأمريكي…
من جهة أخرى، أعلنت بعض الشركات الكبرى، مثل آبل وشركة تايوان لصناعة أشباه المواصلات، استثمارات بمئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة مما يُوفِّرُ آلاف فُرص العمل في قطاعَيْ التكنولوجيا والتصنيع…
كيف يُسدّد « الآخرون » ديون الولايات المتحدة
فشل دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، بداية من سنة 2017، إنجاز مشروعه المتمثل في « جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى »، وأعاد الكَرّةَ خلال فترة رئاسته الثانية، بداية من 20 كانون الثاني/يناير 2025، وادّعى إنه سوف يُركّز اهتمامه على المشاكل الدّاخلية، لكن الولايات المتحدة دولة امبريالية يتواجد جيشها في أكثر من ثمانمائة قاعدة عسكرية في العالم، وتُشكّل عُملتها العُملة الدّولية للمبادلات التجارية وتقويم أسعار الغذاء والمواد الخام والمحروقات، فضلا عن الأصول والسّندات الأمريكية التي يمتلكها غير الأمريكيين، من دول وشركات وأفراد، وهي دُيُون بقيمة 34 تريليون دولارا، ويريد دونالد ترامب إعادة هيكلة الديون الأميركية، من خلال خفض قيمة الدّولار « لتعزيز الصادرات الأميركية وتقليص العجز التجاري »، ويُخفض هذا الإجراء (خفض قيمة الدّولار) قيمة الدّيْن الأمريكي، وحالما بدأ تطبيق خفض قيمة الدّولار ارتفعت قيمة الذّهب الذي أصبح الملاذ الآمن بدلاً من الدّولار، لكن خطة دونالد ترامب (كما كانت خطة رونالد ريغن سنة 1985) تهدف في الوقت نفسه إلى الحفاظ على هيمنة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، وتمكّنت الولايات المتحدة، منذ أكثر من ستة عُقُود من تحميل الدّول الأخرى وِزْرَ تسديد الدّيُون الأمريكية التي بلغت مستويات قياسية، وتضطر دُول العالم إلى إنقاذ الإقتصاد الأمريكي، لأن انهياره سوف يؤدّي إلى أزمة عالمية لا يعرف أحد حدودها.
تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية تمويل الدَّيْن الأميركي من خلال إصدار سندات طويلة الأجل تحمل فائدة أي استبدال ورقة بأخرى، وبدأت حكومة الولايات المتحدة تضغط على دول أوروبا والخليج، لكي يدفعوا المال للولايات المتحدة بذريعة تسديد ثمن حمايتها العسكرية…
استغلّت الولايات المتحدة المكانة المُهَيْمِنة للدّولار كعملة احتياطية تحتاجها الدّول لإتمام المبادلات التجارية والتحويلات المالية، فَرَفَعَتْ من قيمته بشكل مُبالَغ، مما أضْعَفَ قُدْرَة السّلع الأمريكية على المنافسة في الأسواق الدّولية، وإلى إغلاق المصانع وتسريح العُمّال وإلى ارتفاع العجز التّجاري الأمريكي…
تُعَدُّ خطّة دونالد ترامب لرَفْع الرّسُوم الجمركية إحْدَى أدوات إجبار الدّول المتعاملة مع الولايات المتحدة على رَفْعِ قيمة عُملاتها مُقابل الدّولار، مثلما حَصَل سنة 1987 ( Plaza Accord ) غير إن هذه الخطّة تتضمّن احتمال خفض الدّول احتياطياتها من الدّولارات واستبدالها تدريجيا بعملات أخرى كالين الياباني أو اليورو الأوروبي أو الجُنَيْه الإسترليني أو اليوان الصّيني، لتنخفض نسبة الإحتياطي من الدّولارات في المصارف المركزية لشركاء الولايات المتحدة، والدّول المُصدّرة للمواد الخام وللنفط ، كما قد تُؤدِّي خطة دونالد ترامب إلى انخفاض الإستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة…
هدّد دونالد ترامب، قبل تنصيبه، دول مجموعة بريكس بفَرْضِ رسومٍ جمركية ضخمة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إذا ما أنشأت عملة احتياطية بديلة، ويعتقد الفريق الإقتصادي لدونالد ترامب إن رَفْع الرسوم الجمركية يُمَكّن تعزيز دور الدولار كعملة احتياطية عالمية رائدة، ويُعزّز إمكانية الحصول على واردات أرخص، لكن الرّسُوم الجمركية المرتفعة ( وقرارات ترامب الأخرى ) قد تُؤَدِّي إلى انخفاض الطّلب الإستثماري على الدّولار، وإلى زيادة خطر الركود، وظَهَرت تنائج انخفاض الطّلب على الدّولار في انخفاض قيمته مقابل اليورو والعملات الرئيسية الأخرى، مُقارنة بفترة ما قَبْلَ انتخاب دونالد ترامب، وهي نتيجة عَكْسِيّة لهدف ترامب من استخدام الرسوم الجمركية لرفع قيمة الدولار، وجعل السلع المستوردة أرخص بالنسبة للولايات المتحدة…
من وجهة نَظَر العُمّال، أثبتت التجارب السابقة إن خفض العجز التجاري لا يُؤدِّي إلى زيادة رواتب العُمّال وتحسين ظروف عملهم.
الطاهر المعز
المصادر:
دين بيكر – مركز البحوث الاقتصادية والسياسية – واشنطن + وكالة رويترز + موقع صحيفة واشنطن بوست + موقع صحيفة « وول ستريت جورنال » – من 09 إلى 14 آذار/مارس 2025
-
Rene Naba-Israël et l’Arabie saoudite, deux grands colonisateurs de la planète (sur leurs extensions économiques et coloniales mondiales)

Rene Naba compagnon de longue date de la résistance libanaise et palestinienne, du mouvement mondial anti-colonial et anti-impérialiste est un ami personnel et un camarade et un ami de mon école populaire de philosophie.
Ce texte permettra à chacun de ses lecteurs de dévoiler la parenté profonde du caractère néo-impérialiste de ces deux entités, Israël et Saoudie, bien plus significative que l'identité ethnique. Tous les oligarques devenus oligarques mutent de l'identité ethnique à une identité de classe, quelles que soient leurs nationalités, accompagnée de haine et de mépris incoercibles pour leurs peuples, leurs traditions, leurs religions, leurs mœurs. Seuls les modernistes, agents idéologiques de "l'Universalité" toute et rien qu'occidentale, devenue Wokisme à l'ère de sa dégénérescence, peuvent les égaler dans cette haine et ce mépris.
Bonne lectureIsraël et l’Arabie saoudite, deux grands colonisateurs de la planète par Rene Naba
dans : Analyse Arabie saoudite Israël – le 25 juin 2015
Paris – Le fait est patent et la source béton. C’est écrit noir sur blanc dans un rapport américain intitulé « Global Land and Water Grabbing » (accaparement mondial de la terre et des eaux) et publié par la revue Golias Hebdo N° 275 (semaine du 14 au 20 Février 2013).
Israël est l’un des plus grands colonisateurs de la planète et l’un des plus importants pollueurs des terres d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie
Une colonisation de l’ordre de 20 fois la superficie de la Palestine, alors que l’Arabie saoudite, sous la bannière de la firme Ben Laden, la firme familiale du fondateur d’Al Qaida, se tournait vers l’Afrique et l’Asie pour s’assurer des terres arables pour parvenir son auto suffisance alimentaire.
L’expérience d’Israël de la colonisation de la Palestine l’a conduite à coloniser des terres à travers le Monde représentant vingt fois sa superficie au détriment des populations et de l’environnement des pays pauvres :- En Guinée, Simandou, une montagne isolée au milieu de la forêt équatoriale, dans les confins de la Guinée. Son sous-sol renferme du minerai de fer, la plus importante réserve inexploitée au monde. Sa valeur : plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Le sous-sol de la Guinée regorge de matières premières : bauxite, diamant, or, uranium, fer, etc. Les principaux groupes miniers de la planète s’y disputent les concessions. Mais les 11 millions d’habitants ne profitent guère de ces trésors. Le scandale de Simandou met en cause l’homme le plus riche d’Israël, Benny Steinmetz. Une des plus importantes opérations de pillage des richesses minières d’Afrique sur fond de corruption des élites africaines et d’évasion de capitaux, avec la complicité d’un ex-première dame guinéenne.
- Au Gabon pour la culture du Jatropa, nécessaire à la production de biocarburants.
- En Sierra Leone où la colonisation israélienne représente 6,9 pour cent du territoire de ce pays de l’Afrique de l’Ouest de surcroît diamantifère.
- Aux Philippines où la proportion des terres « confisquées » atteint 17,2 pour cent de la surface des terres agricoles.
- En République Démocratique du Congo pour la culture de la canne à sucre, en sus de l’exploitation diamantifère. Avec en prolongement dans la région des grands lacs, un prosélytisme visant la conversion des Tutsi au judaïsme, en une opération visant à forger une nouvelle identité pour une stratégie de conquête et de préservation des intérêts israéliens dans la zone, parallèlement à la stratégie avec la stérilisation des Fallachas, juifs d’Éthiopie en Israël. Nul n’est à l’abri de contradictions.
Les scandales abondent au Congo Kinshasa où Laurent Désiré Kabila a payé de sa vie ses indélicatesses en attribuant l’exploitation diamantifère à un groupe israélien.
Israël est à la tête des pays qui contrôlent les terres dans les pays pauvres, avec les États-Unis, la Grande Bretagne et la Chine. Selon cette de « The Journal of the National Academy of Sciences of the United States » et reprise par Golias, 90 pour cent de ces terres se trouvent dans 24 pays situées pour la plupart en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Depuis la crise alimentaire de 2007-2008, les sociétés étrangères s’emparent de dix millions d’hectares annuellement de terres arables. Les nouvelles cultures se font souvent au détriment des jungles et des zones d’importance environnementales, menacées ans leur biodiversité. Elles utilisent engrais et pesticides et libèrent d’importantes quantités de gaz à effet de serre. Au final, le phénomène sape les bases de la souveraineté alimentaire et détourne en particulier les ressources en eau.Dans les pays de l’Afrique anglophone…
S’appuyant sur les pays africains anglophones non musulmans, l’Éthiopie, l’Ouganda et le Kenya, Israël a opéré une percée diplomatique majeure dans l’Afrique anglophone obtenant la réduction du quota des eaux du Nil de l’Égypte, la plus grande pantalonnade diplomatique de l’ère Moubarak, qui a coûté son pouvoir à l’égyptien.
Négociant avec l’égyptien Moubarak, lui faisant miroiter la possibilité d’une succession dynastique en faveur de son fils, Israël a incité les états africains à réclamer une majoration de leur quote-part dans la répartition hydraulique du cours d’eau, alléchant les Africains par des projets économiques et les investisseurs égyptiens par des promesses d’intéressement aux projets israéliens. En Éthiopie, Israël a financé la construction de dizaines de projets pour l’exploitation des eaux du Nil Bleu.L’accès d’Israël au périmètre du bassin du Nil, via le sud Soudan avec le concours français et américain, s’est doublé du lancement d’un projet de la construction d’un Canal reliant la Mer Rouge à la Mer Méditerranée, depuis Eilat. Disposant de deux voies de navigation, l’un pour l’aller, l’autre pour le retour, le canal israélien, contrairement à l’Egyptien concurrencera fortement le Canal de Suez et entraînera une perte de 50 pour cent des recettes égyptiennes de 8 milliards de dollars par an à 4 milliards. Mais l’Égypte semble avoir pris de vitesse son rival israélien avec le lancement de la construction d’un canal complémentaire, en partenariat avec l’Arabe saoudite, dans la foulée de la nouvelle offensive israélienne sur Gaza, -Bordure protectrice-, qui a eu lieu du 8 Juillet au 7 août 2014.
Le harcèlement israélien des communautés libanaises d’Afrique, particulièrement au Nigeria et au Sierra Leone vise ainsi à éliminer des concurrents dans l’exploitation diamantifère du sous-sol africain et à assécher le flux financier provenant des émigrés chiites vers leurs coreligionnaires du sud Liban. A fragiliser le glacis constitué par l’immigration chiite libanaise en Afrique et en Amérique latine face à la colonisation rampante des terres entreprises par Israël dans ses deux zones.
Le Mossad recruterait même des journalistes arabes pour surveiller les libanais d’Afrique, selon les révélations faites au journal espagnol El Pais par un ancien agent, journaliste algérien Saïd Sahnoune.
Saïd Sahnoune avait été recruté à Tel-Aviv en 1998. En usant de sa qualité de journaliste, il espionnait pour le Mossad à Abidjan en Côte-d’Ivoire. Il était chargé de la surveillance de la colonie libanaise chiite en Afrique de l’Ouest. Sahnoune espionnait également en Tunisie, mais surtout au Liban après le retrait d’Israël du Sud du pays, qu’il occupait jusqu’en 2000. Le paiement de l’espion algérien se faisait en espèces à Chypre à raison de 1.500 dollars par mois en plus de la prise en charge de ses frais de mission qui lui permettaient de gagner jusqu’à 6.000 dollars quand les cibles étaient atteintes.Israël est le plus important soutien des dictatures du tiers monde, l’allié indéfectible du régime d’Apartheid d’Afrique du sud. La garde prétorienne de tous les dictateurs francophones qui ont pillé l’Afrique. De Joseph Désiré Mobutu (Zaïre-RDC), à Omar Bongo (Gabon), à Gnassingbé Eyadema (Togo) et même Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire) et Laurent Gbagbo, à Paul Biya, le président off-shore du Cameroun, dont le territoire sert de transit aux ravisseurs Boko Haram. Au-delà en Amérique latine au Honduras, à la Colombie et au Paraguay.
Et En Amérique latine…
L’offensive anti Hezbollah en Amérique latine viserait en outre à jeter un écran de fumée sur la face hideuse de l’humanitarisme israélien. À camoufler la colonisation rampante des terres en Colombie et cette singulière imposture que constitue la reproduction du régime d’apartheid de la Palestine au Honduras. Ah les douloureuses réminiscences.
Israël est l’un des plus gros exportateurs d’armes à destination de l’Amérique du sud.
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/les-soldats-israeliens-en-amerique-165615En Colombie, Israël passe pour avoir encadré les forces colombiennes dans l’assaut contre les FARC visant à la libération de l’otage Ingrid Bettencourt. L’état hébreu a pris le contrôle d’immenses superficies pour cultiver la canne à sucre. Et le Honduras est devenu une terre de prédilection de la transposition de l’Apartheid israélien sur le territoire latino-américain.
Le Honduras affiche en effet le plus fort taux d’homicides par habitants au monde (85,5 pour 100 000 en 2012), soit environ 20 meurtres par jour, à 95% impunis, dont la pauvreté touche plus de 70 % de la population, selon l’ONG locale Forum de la dette extérieure et qui peine, de surcroît, à se remettre des conséquences du renversement du président Manuel Zelaya en juin 2009 par des militaires soutenus par des secteurs de la droite et les milieux d’affaires.Une aubaine pour Israël : « Le Honduras est aujourd’hui, comme la Palestine, un laboratoire du génocide indigène, laboratoire des techniques de contre-insurrection, laboratoire de ghettoïsation et contention de populations mises en esclavage.
Il est aussi le laboratoire de la mise en place d’un néo libéralisme absolu, grâce à la cession de souveraineté sur des régions entières du pays par les moyens de la « Loi Hypothèque » et la création d’enclaves néo libérales soustraites au territoire national, les « Zones d’Emploi et de Développement Économique » ou « Cités Modèles » ou « Villes Charters », ainsi que « la cession des droits sur l’ensemble des ressources naturelles du pays » est-il écrit.Autre plaie de l’économie africaine : le bradage des terres arables
Depuis 2006, près de 20 millions d’hectares de terres arables ont fait l’objet de négociations dans le monde car d’ici à 2050, la production agricole devrait croître de 70 % pour répondre à l’augmentation de la population, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Mais cette offensive sur les terres ne se fait pas sans dérapages. Le recadrage des investissements s’impose, faute de quoi ils risquent de déséquilibrer le pays cible, à l’image des visées du coréen Daewoo à Madagascar. À l’affût d’une hausse durable des prix des denrées ou d’une volatilité accrue des marchés, ce néo colonialisme agricole est devenu un élément stratégique pour les pays soucieux s’assurer leur sécurité alimentaire.
Aux fonds souverains d’états soucieux d’assurer leur stratégie d’approvisionnement, parmi lesquels les pays du Golfe ou la Chine, se sont ajouté des investisseurs privés, locaux ou étrangers. Les acquisitions de terres se sont accélérées avec la crise alimentaire de 2008. L’Arabie saoudite a mis sur pied une société publique pour financer les entreprises privées du royaume qui achètent des terres à l’étranger. Au Mali, les nouvelles mises en culture bénéficient surtout aux investisseurs libyens. L’octroi de 100 000 hectares à la société Malibya, liée à l’ancien dirigeant libyen, le colonel Mouammar Kadhafi a fait grand bruit. « Les hectares des Libyens sont au début des canaux d’irrigation, ils seront servis en eau avant nous », regrettent les paysans. « Même s’ils disent opérer dans le cadre de la coopération, nous ne comprenons pas bien quels sont les intérêts derrière tout cela », résume Mamadou Goïta, de l’ONG malienne Afrique verte. Les producteurs redoutent aussi les intentions des Chinois de développer la canne à sucre, gourmande en eau. Ils en cultivent déjà 6 000 hectares et contrôlent la sucrerie Sukala.
Face à la montée des eaux, les Maldives cherchent des terres d’accueil. Soixante-dix mille personnes s’entassent à Malé, lourd plateau urbain posé à fleur d’océan Indien. Pour l’heure, cette barrière artificielle tient bon. Elle a réussi à protéger la capitale de ce singulier État des Maldives, archipel aux vingt-six atolls et aux 1 200 îles dont les écrins de corail occupent une place de choix dans les catalogues du tourisme mondial. Mais pour combien de temps encore ? Le raz-de-marée de 1987 inonda une partie de Malé et causa un choc profond dans la population.
Puis le phénomène climatique El Niño provoqua, en 1998, un blanchissement massif des coraux : 90 % de ceux situés à moins de 15 mètres de profondeur périrent. Enfin, le tsunami de décembre 2004 frappa sévèrement l’archipel, détruisant deux îles, imposant l’évacuation de six autres, et le déplacement de près de 4 000 personnes (sur 280 000 habitants).
Aux îles Kiribati… Même cause, même réaction : face à la montée des eaux qui les menacent, les îles Kiribati, un archipel du Pacifique, envisagent de se lancer dans l’achat de nouvelles terres. « L’alternative, c’est de mourir, de disparaître ». Les Kiribati doivent faire face à une montée des eaux de 5 mm par an depuis 1991, qui entraîne notamment une salinisation de l’eau douce. Dans un premier temps, le gouvernement avait opté pour une politique de formation et d’émigration maîtrisée. Mais la crise économique l’a conduit à envisager cette solution plus radicale.L’Arabie saoudite a mis sur pied une société publique pour financer les entreprises privées du royaume qui achètent des terres à l’étranger. Elle s’est tournée vers l’Afrique, en raison de sa proximité avec le Royaume. La firme saoudienne « Haïl Hadco » loue ainsi des milliers d’hectares au Soudan avec pour objectif d’en cultiver 40.000, alors que le groupe Ben Laden, spécialisé dans les travaux publics, s’est engagé en Asie à la tête d’un consortium, espérant, à terme, gérer 500 000 hectares de rizières en Indonésie, dans le cadre d’un projet agricole de 1,6 million d’hectares comprenant la production d’agro carburant.
Fonds vautours, évaporation de recettes, corruption, gabegie des transferts des fonds des migrants, bradage des terres arables. L’Afrique est elle condamnée à demeurer un tonneau des danaïdes.Références
- http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/ed_110110_bd.pdf?PHPSESSID=2…
- À propos des Fonds vautours: Rapport de la Plate forme française Dette et développement et du CNCD (Centre national de coopération au développement) intitulé « Un vautour peut en cacher un autre ou comment nos lois encouragent les prédateurs des pays pauvres endettés, juin 2009. L’Afrique : Un continent touché plus que d’autres par la crise financière» http://www.dia-afrique.org/suite.php ?newsid=12031
Ainsi que http://www.cadtm.org/spip.php ?article4654 - À propos du transfert des fonds des migrants africains vers leur pays natal, Cf. article de Grégoire Allix in LE MONDE du 22 octobre 2009
- Bertrand d’Armagnac : la course aux terres arables Le Monde du 23 avril 2010 http://www.lemonde. fr/planete/ article/2010/ 04/22/la- course-aux- terres-arables- devient-preoccup ante_1341086_ 3244.html
Source : https://www.renenaba.com/israel-et-l-arabie-saoudite-deux-grands-colonisateurs-de-la-planete/
-
الطاهر المعز-متابعات : العدد الخامس 110 بتاريخ 15 من آذار/مارس 2025

متابعات – العدد الخامس 110 بتاريخ 15 من آذار/مارس 2025 : الطاهر المعز
يتضمن العدد الخامس عشر بعد المائة من نشرة "متابعات" الأسبوعية فقرات عن المُقاطعة الرياضية للكيان الصهيوني وفقرة عن الهند في موقع الأعداء وفقرة عن بعض الوضع في سوريا في ظل حكم المجموعات الإرهابية، وفقرة عن إنتاج الغذاء في إفريقيا، وفقرة عن بزنس الرياضة كمجال استثمارات وأرباح وفقرة عن أزمة الإقتصاد الألماني
في جبهة الأعداء – مُقاطعة رياضية – 1
استجابت شركة الملابس الرياضية الإيطالية « إيريا » (Erreà ) لدعوات المُقاطعة، فانسحبت من صفقة الرعاية مع الاتحاد الصهيوني لكرة القدم، لتحل محلها شركة « ريبوك » التي دعتها حركة المُقاطعة « بي دي إس » إلى الإنسحاب أو مواجهة المقاطعة، كما حدث مع إيريا، وبوما، وأديداس من قبلها، واضطرت هذه الشركات إلى عدم تجديد العقد ( بوما وأديداس) أو الإنسحاب ( إيريا) قبل بداية تنفيذ العقد الذي تم توقيعه لمدّة عامَيْن، خلال شهر آب/أغسطس 2024، أي خلال اشتداد وتيرة العُدوان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللّبناني، وكان من المتوقّع أن يبدأ تنفيذ العقد بداية من شهر كانون الأول/يناير 2025، بعد إعلان شركة بوما ( متعددة الجنسيات ذات المنشَأ الألماني) عدم تجديد العقد الذي استمر خمس سنوات، حتى كانون الأول/ديسمبر 2023، وكانت أديداس قد انسحبت قبلها، سنة 2018، إثر حملة قامت بها النوادي الرياضية الفلسطينية جمعت 16 ألف توقيع تم تقديمها إلى مقر الشركة.
تعتمد حملة المُقاطعة الرياضية على تواطؤ الإتحادات الرياضية الصهيونية، ومن بينها اتحاد كرة القدم، ومشاركتها بشكل مباشر في الإحتلال والإبادة والمَيْز، كما تعتمد على قرار محكمة العدل الدّولية ( كانون الثاني/يناير 2024) بشأن ارتكاب الكيان الصهيوني أعمال إبادة جماعية في غزة، وعلى قرار نفس المحكمة بعدم قانونية الاحتلال العسكري لقطاع غزة والضفة الغربية ( مع إهمال الأراضي المحتلة سنة 1948 التي تعتبر احتلالها « قانونيًّا »)، وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن الاتحاد الصّهيوني لكرة القدم وقع عقدا لمدة عامين مع شركة ريبوك، ويظهر شعارها الآن على موقعه باعتبارها الراعي الجديد.
مُقاطعة رياضية – 2
امتدّت حركة مُقاطعة الكيان الصّهيوني (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – (BDS ) إلى المجال الرياضي فانسحبت شركة « ريبوك » من عقد رعاية الإتحاد الصهيوني لكرة القدم الذي كانت أبرمته لمدّة سنتَيْن، وإلى ملاعب كرة القدم – خصوصًا في ملاعب دول الإتحاد الأوروبي التي تدعم حكوماتها وإعلامُها السّائد الكيان الصهيوني – ضمن حملة بعنوان « بطاقة حَمْراء لإسرائيل » وشهدت مباريات كرة القدم خلال الأسبوعين الأخِيرَيْن من شهر شباط/فبراير 2025، لافتات وشعارات تُطالب بطَرْد الكيان الصهيوني من البطولات الرياضية الأوروبية، وذلك في ملاعب كل من إيطاليا وإسبانيا وماليزيا وتونس وبريطانيا وفرنسا واليونان وتركيا وبلجيكا، وشملت الإحتجاجات رَفْعَ البطاقات الحمراء، حيث رفعت شعارات مماثلة في 72 مُباراة عبر 25 دولة في كافة قارّات العالم، وذكرت وسائل إعلام بريطانية، يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير 2025، أن مشجعي فريق سلتيك الأسكتلندي قاموا بحمل يافطات تحمل شعار “أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل”، خلال مباراة ضد فريق بايرن ميونخ الألماني، للمطالبة بطرد الكيان الصهيوني من البطولات الدولية، بسبب « ارتكاب جرائم حرب في غزة »، واشتهر جمهور سلتيك الأسكتلندي بأنه من أكثر الداعمين للشعب الفلسطيني، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية خلال جميع المباريات الأوروبية العشْر للنادي، سواء على أرضه أو خارجها، رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على جماهير سلتيك، إلا أنهم حددوا موقفهم بمواصلة رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، وجمع قيمة الغرامات وتسديدها، كما حمل المئات من مشجعي نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم حاملين لافتات حمراء فوق رؤوسهم، مساء يوم الاثنين 24 شباط/فبراير 2025، إضافة إلى لافتة ضخمة مكتوب عليها ” أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل”.
مُقاطعة رياضية –
كانت الهند إحدى أعمدة « حركة عدم الإنحياز » منذ مؤتمر « باندونغ » (اندونيسيا) سنة 1955، وعضو حاليا في مجموعة « بريكس » (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) وكانت حكوماتها المتعاقبة منذ استقلالها عن بريطانيا (1947) داعمة لحركات التحرر الوطني، غير أن التغييرات الحاصلة في العالم أَثَّرَتْ في الهند ومن التغييرات الواضحة -والتي تَعْنِينَا بدرجة أولى كَعَرب- تكثيف الإتصالات والعلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية مع الكيان الصّهيوني، منذ 1991، وخصوصًا بعد انهيار الإتحاد السوفييتي والعدوان على العراق (1991) وتوطّدت إثر توقيع اتفاقيات أوسلو (1993)، وذلك خلال حكم « حزب المُؤْتَمَر » الذي كان قادتُهُ من مُؤَسِّسِي « حركة عدم الإنحياز »، ولكن العلاقات توثّقت كثيرًا خلال حكم الحزب اليميني العُنْصُري، « الحزب القومي الهندوسي » (باهارتيا جاناتا) الذي يُؤْمِنُ بتفوق « الحضارة الهندوسية » على بقية حضارات المنطقة (مثل الحزب النازي الذي اختلق « الجنس الآرِي »)، والذي يترأسه « ناريندرا مُودي »، رئيس الحكومة الذي توافقت عقيدته (وعقيدة حِزْبِهِ) العنصرية واليمينية مع جوهر الصهيونية، وأحْيت الحكومتان الذكرى الخامسة والعشرين لعودة العلاقات الدبلوماسية سنة 2016 بمبادرات غير مسبوقة منها زيارات زعماء صهاينة وتوثيق العلاقات الإقتصادية والعسكرية والسياحية (تُعْتَبَر بعض المُنْتجعات السياحية الهندية شبه مُخَصَّصَة للضباط الصهاينة)، وكان رئيس الوزراء الهندي « ناريندرا مودي » أول مسؤول حكومي رفيع يزور الكيان الصّهْيُوني (تموز/يوليو 2017)، ووقَّعَ اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة، منها الأمن والزراعة والمياه والطاقة، كما وَقَّعَ أكبر صفقات يعقدها المُجَمّع العسكري الصهيوني في تاريخ الصناعات العسكرية الصهيونية، بقيمة 1,6 مليار دولار (مُعْلَنَة) شَمِلَتْ منصات صواريخ منظومات دفاع جوي (من صنع أمريكي وتطوير صهيوني)، ونُجم وأجهزة اتصالات حديثة وأسلحة للجيوش الثلاثة (البر والجو والبحر) وقطع الغيار والمنظومات الخاصة بهذه الأسلحة… في المُقابل، وبمناسبة الإعلان عن زيارة رئيس حكومة العدو للهند، أعلنت منظمة الفلاحين -التي أسّسَها الحزب الشيوعي الهندي سنة 1936- والتي تضم 16 مليون فلاّحًا دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني والتحاقها بحركة المقاطعة والدعوة إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الكيان الصهيوني، ومقاومة سيطرة الشركات الصهيونية على الزراعة الهندية، وفق بيان صدر يوم الأحد 29/10/2017، وَالتزمت المنظمة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفلاحين الهنود لمنع الكيان الصهيوني وشركاته، من تمويل الاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني… عن رويترز + وكالة « سبوتنيك » 30/10/17 يشارك جيش الجو الهندي في مناورات عسكرية مع جيش الإحتلال الصهيوني في منطقة « النَّقَب » (جنوب فلسطين المحتلة) تحت إسم « بلو إكسرسايز » وتدوم المناورات أسبوعين من 2 إلى 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بمشاركة سبعين طائرة حربية وجيوش تسع دول (منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبولندا والهند واليونان وإيطاليا) وربما دول عربية، وأوردت الصحف الهندية والصهيونية بالمناسبة بيانات نستنتج منها: تُشارك الهند بطائرات العمليات الخاصة من طراز (سي – 130 جيه) وأفراد من وحدة القوات الجوية الخاصة « جارود »، وبلغت قيمة صادرات الأسلحة من الكيان الصهيوني إلى الهند نحو مليار دولارا سنويا… عن صحيفة « تايمز أُوف إندِيَا » 01/11/17
سوريا – الرّأسمالية المُلْتَحِيَة
يزاداد وَضع المواطنين سوءًا عند اقتراب المواسم مثل شهر رمضان أو عيد الإضحى لأن الفَقر( حوالي 90% من الشعب السّوري) والبطالة ( 25% من القادرين على العمل ) سائدَيْن ولأن رواتب العاملين ضعيفة وغير متناسبة مع سعر المواد الغذائية الأساسية، وقبل بداية شهر رمضان بلغ الكيلوغرام الواحد وكيلوغرام الدجاج بـ55 ألف ليرة (5,69 دولارات) والأرز ( 1,03 دولارا) والسّكّر 0,82 دولارا، يوم الإربعاء 26 شباط/فبراير 2025 يوم الإربعاء 26 شباط/فبراير، فضلا عن ارتفاع أسعار الطّاقة والنّقل ويعتمد نحو 75% من المواطنين على المُساعدات « الإنسانية »، لأن دخلهم يَقِلّ عن خط الفقر المدقع ( أقل من 2,15 دولارا للشخص الواحد في اليوم) ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وشُحّ الدّخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( تقرير نُشِرَ يوم العشرين من شباط/فبراير 2025)…
ارتفع عدد المُعطّلين عن العمل وعدد المُحتاجين إلى المُساعدة بعد استيلاء المجموعات الإرهابية بزعامة « هيئة تحرير الشام » (أي « النُّصرة » أو « القاعدة » سابقا)، بإشراف تُركي، وأعلنت السّلطات الجديدة « إعادة هيكلة المُؤسّسات العمومية » ( وهي لُغة صندوق النقد الدّولي) وتسريح ما لا يقل عن أربعمائة ألف موظف من العاملين بالقطاع العام ( من إجمالي 1,3 مليون موظف )، ولذلك نظّم العاملون المُسَرَّحُون أو المُهَدَّدُون بالتّسْرِيح وقفات احتجاجية في العديد من المناطق والمُحافظات السُّورية، للمطالبة بإلغاء قرارات الفصل وعدم تجديد العُقُود والإجازات الإجبارية الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال السورية بحق عمال وموظفين في القطاع العام، بإشراف رابطة عمال التغيير الديمقراطي والتنسيقيات العمالية الديمقراطية التي تُطالب بالتراجع عن نهج الخصخصة ( أعلنت وزارة اقتصاد السلطات الإرهابية خصخصة 107 من الشركات الصناعية التابعة للدّولة)، وبتشكيل لجان حكومية لدراسة ملفات الموظفين، والتّراجع عن القرارات الحكومية « المتسرعة والمجحفة وغير المدروسة وغير العلمية بحق الموظفين والعمال (…)، وإعادة هيكلة القطاعات على قاعدة التّأهيل والحفاظ على المؤسسات والمُنشآت والمعامل والكفاءات العلمية والفنية، وتأهيل القطاعات التي تضرّرت من الحرب، كالمرافئ والمطارات والمعادن والطّاقة، وقطاعات الزراعة والغذاء والنسيج…
الولايات المتحدة عَدُوّ مُباشر للشعوب وللعرب خصوصًا
كانت الولايات المتحدة تدّعي إن العمليات الخاصة، خارج ساحات الحرب، تستهدف « أهدافًا إرهابية »، غير إن البيت الأبيض أعلن تَخْفِيف القيود المفروضة على القادة العسكريين الأميركيين فيما يتعلق بالموافقة على الغارات الجوية والعمليات الخاصة خارج ساحات القتال التقليدية، مما يسمح بتوسيع دائرة الأشخاص الذين يمكن استهدافهم، وتوسيع هامش حرية القادة العسكريين الميدانيين في تحديد الأهداف وتنفيذ الهجمات، وَوَقَّعَ وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث (Pete Hegseth ) على قرار تخفيف القيود السياسية والإشراف التنفيذي على نَشْر القوات الخاصة وتنفيذ الغارات الجوية والمُداهمات ( كما يحصل في الصّومال أو سوريا أو اليمن وغيرها)، خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين الأميركيين من القيادة الأميركية في أفريقيا ( أفريكوم) في ألمانيا، وفق شبكة سي إن إن نيوز الأمريكية بتاريخ 28 شباط/فبراير 2025، ونَشَر معهد واتون بجامعة براون الأمريكية نتائج دراسة أجراها سنة 2023 أظْهَرت إن أكثر من 4,5 مليون شخص لقوا حتفهم في الحروب التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، باسم « مكافحة الإرهاب »، فضلا عن 3,6 ملايين شخص لقوا حتفهم بفعل التّأثيرات الجانبية للحروب العدوانية الأمريكية/الأطلسية، وتشمل الموت إثر التّهجير القَسْرِي وانعدام الغذاء والدّواء وتدمير المباني والمرافق الصحّية والبُنية التحتية ومحطات توليد الطاقة وضخ المياه الصالحة للشُّرب وما إلى ذلك، وخصوصًا من المدنيين في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا واليمن وليبيا والصومال…
في إطار تخفيف القيود على قرار العدوان والقتل والتدمير، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (يوم 28 شباط/فبراير 2025 وفق وكالة الصحافة الفرنسية) عن صفقة أسلحة أمريكية جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تشمل آلاف القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل وجرافات مدرعة بقيمة ملايين الدولارات، وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قَدّم الإتفاق إلى الكونجرس « إنه إجراء طارئ يجب أن يتم خارج عملية المراجعة المعتادة من قبل لجان العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ »، وتتطلب حالة الطّوارئ « البيع الفوري للأسلحة والمُعدّات بما يخدم المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة، وبالتالي التنازل عن متطلبات المراجعة في الكونغرس »، وفق وكالة الأمن القومي التي أوضحت إن البيت الأبيض وافق – منتصف شهر شباط/فبراير 2025 – على صفقة أسلحة للكيان الصهيوني بقيمة 7,4 مليار دولارا لشراء ذخائر ومعدات توجيه وصواريخ هيلفاير، وتجاوزت تلك الصفقة أيضًا موافقة الكونغرس، وهي الخطوة التي استخدمها الرئيس السابق جو بايدن بانتظام، وبذلك تستغل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فترة « الهُدْنة » وتبادل الأسْرى، لإعادة تسليح الجيش الصهيوني بحوالي 10,5 مليارات دولارا، خلال أُسبوعَيْن استعدادًا لمُواصلة العُدْوان والإبادة في غزة والضّفّة الغربية، ونشرت جامعة براون خلال سنة 2024، تقريرًا يُفيد إن الجيش الصهيوني حصل ما بين السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 و الثلاثين من أيلول/سبتمر 2024 على أسلحة بقيمة لا تقل عن 22,76 مليار دولار دَعْمًا من الولايات المتحدة للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة…
إفريقيا – انعدام الأمن الغذائي:
يتوقع مصرف التنمية الإفريقي ارتفاع قيمة سوق الأغذية والزراعة الإفريقية من 280 مليار دولار سنوياً إلى تريليون دولار بحلول سنة 2030، لأن قارّة إفريقيا تَضُمُّ نحو 45% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم وَتُعد الزراعة قطاعًا اقتصاديًّا رئيسيًّا في العديد من دول إفريقيا، وشكّل القطاع الزراعي سنة 2022 نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي بالدول الإفريقية جنوب الصحراء، ويستوعب قطاع الفلاحة وصناعة الأغذية في إفريقيا 43% من العاملين، ولكن الشركات العابرة للقارات اشترت أو اكتَرت، بعقود طويلة الأجل، حوالي نصف هذه الأراضي الصالحة للزراعة لإنتاج الفواكه والزهور وغيرها من الإنتاج الفلاحي المُعَدّ للتّصدير، مما يضطر دول القارّة إلى استيراد أكثر من 80% من السلع الغذائية من خارج القارة، ولذلك يعاني حوالي 60% من سكانها من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني أكثر من 20% من سُكّان القارّة، أي ما يقرب من 257 مليون فرد، من نقص التغذية، وفقاً للبنك الدولي وبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ورغم ارتفاع حجم الإستثمار في الزراعة، لم تبلغ استثمارات أغلب البلدان الإفريقية 10% من ميزانياتها الوطنية في الزراعة، بعد عشر سنوات من اتفاقية مالابو التي حدّدت هذا الهدف منذ سنة 2014 بسبب المشاكل الهيكَلِيّة التي يواجها القطاع الزراعي في إفريقيا والتي تعرقل تحقيق تنمية مستدامة قادرة على تلبية احتياجات السكان، من ذلك ضعف البنية التحتية التي تزيد من صعوبات نقل وتوزيع المنتجات الزراعية على الأسواق، فضلا عن عدم توازن الإستثمار والتغير المناخي والجفاف وتآكل التّربة والتّصحُّر، وهي عوامل تُخفّض مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتُؤثِّرُ سلباً على حجم ونوعية الإنتاج الزراعي، كما يحصل في شمال إفريقيا وفي المنطقة المُحيطة بالصّحراء الكُبرى، حيث انخفضت الاستثمارات في شبكات الطرق والسكك الحديدية، مما يُعسِّرُ ربط المناطق الزراعية بالأسواق المحلية والدولية، ولم تستثمر الحكومات أو المصارف أو شركات الأغذية في إقامة مصانع لتحويل الإنتاج الزراعي، قريبًا من مناطق إنتاج الخضار والفواكه والحمضيات ومناطق تربية الحيوانات لتعليب المنتجات الزراعية، وتصنيع الألبان والعصائر، للحفاظ على القيمة المضافة محلياً، وعدم تصدير الإنتاج في شكله الخام… عن رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية ( أ.ف.ب. ) 24 كانون الثاني/يناير و28 شباط/فبراير 2025
الرياضة قطاع اقتصادي مُربح
أنشأ مصرف غولدمان ساكس، أحد أهم المُؤسّسات المالية العالمية – منتصف أيلول/سبتمبر 2023 – وحدة « امتياز رياضي » ضمن قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع له وتعمل هذه الوِحْدَة مع إدارة الأُصُول والثروات، وتجمع وحدة الإمتيار الرياضي بين عمليات الإندماج والإستحواذ الرياضية والتمويل الرياضي ( في البلدان الغنية)، بهدف تشجيع الزبائن الأثرياء للمصرف على الاستثمار في النوادي والملاعب وغيرها من الصفقات ذات العلاقة بالرياضة، ودعا الأثرياء إلى الإستثمار في الرياضة، من خلال امتلاك حصة في نوادي رياضية – لم يذكُرها بيان المصرف آنذاك – وتبيّن فيما بعدُ إن بعض الأثرياء الأمريكيين استجابوا لدعوة المجموعة المصرفية غولدمان ساكس، وإن الرياضات المَعْنية بالإستثمارات تتراوح بين سباق السيارات وكرة القدم، مرورًا بكرة السّلّة الأمريكية، ومن بين النوادي كان نادي تشيلسي وفريق كرة القدم الأمريكي تينيسي تايتنز، ونيويورك ميتس و واشنطن كوماندرز ( اتحاد كرة القدم الأميركي) ونادي فينيكس صنز و لوس أنجلوس كليبرز، وكلاهما ينتمي إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتُبرّر المجموعة المصرفية دعوتها بمكانة وشعبية النوادي الرياضية وتملك الفرق الرياضية التي تُشكّل في حدّ ذاتها إشهارًا للأثرياء والشركات المُستثمِرة التي وجب عليها في المُقابل ترميم أو بناء الملاعب، وتعهّدت مؤسسة غولدمان ساكس بتقديم القُروض للزبائن المهتمين بشراء حصة من أسْهُم النوادي الرياضية، مما يُمكّن المصرف من الحصول على المزيد من الإيرادات من الزبائن الحاليين والحصول على حصة أكبر من أعمالهم…
في ألمانيا، قاطرة الإقتصاد الأوروبي، يُشغّل قطاع رياضة كرة القدم المُحترفة ما لا يقلُّ عن 147 ألف شخص بدوام كامل، وتشكل عاملا اقتصاديا هامًّا من خلال ما تُنتجه من القيمة المضافة والضرائب والرسوم، وأنتجت خلال موسم 2023/2024 قيمة مضافة قدرها 14,2 مليار يورو، وساهمت كرة القدم الألمانية المحترفة بـ4,6 مليار يورو (4,8 مليار دولار) في الإيرادات الضريبية للدّولة بارتفاع قدره 25% خلال سِتِّ مواسم، وتتضمن هذه الأرقام إيرادات الضرائب من حقوق البث التليفزيوني والرُّعَاة وَالخَدَمَات التي ترتبط بشكل مباشر بكرة القدم المحترفة، فضلا عن المبيعات والخدمات في قطاعات أخرى لها ارتباط غير مباشر بكرة القدم المحترفة، وكذلك المدن والبلديات التي تستفيد اقتصاديًّا من « البوندسليغا » ( بطولة كرة القدم المحترفة الألمانية) وفق دراسة نشرتها شركة الإستشارات الدّولية « ماكنزي وشركاؤها » ( McKinsey & Company ) يوم السابع عشر من شباط/فبراير 2025.
ألمانيا تجُرُّ أوروبا اقتصاديًّا إلى الخَلْف:
تُشكّل الصناعة أهم نقاط قُوة الإقتصاد الألماني، ولما تَعَثَّر هذا القطاع – فضلا عن التغيرات الجيوسياسية – أصبح اقتصاد ألمانيا يعاني من أزمة عميقة، في سياق تنامي قوة اليمين المُتطرّف الذي عزّز مواقعه خلال انتخابات 23 شباط/فبراير 2025 التي تَصَدَّرَ نتائجها حزب المحافظين ( الإتحاد الدّيمقراطي المسيحي )، ويُشكل ارتفاع عدد الفُقراء أحد مظاهر هذه الأزمة الإقتصادية العميقة، إذ يُقدّر عدد الفُقراء ( بنهاية سنة 2024 ) بأكثر من 13,1 مليون بالإضافة إلى أربعة ملايين آخرين يتهدّدهم الفقر، في أكبر اقتصاد أوروبي، ما يعني إن قُرابة 20 % من المواطنين فُقراء أو على حافة الفقر، معظمهم من النساء والمُعطّلين عن العمل والمُتقاعدين، بحسب الإحصاءات الرسمية، لكن تجاهلت الأحزاب التي شاركت في الإنتخابات موضوع اتساع مُستوى التّفاوت في الثروة، وارتفاع مستوى الفَقْر والعمل الهش وانخفاض معاشات التّقاعد، فيما تسيطر مسألتا الأمن والهجرة ( مع ربط الهجرة بانعدام الأمن المزعوم) على مسار الحملة الإنتخابية في ألمانيا وفي جل بلدان الإتحاد الأوروبي، بل قادت بعض الأحزاب اليمينية ( « المُعْتَدِلَة » والمُتطرّفة) حملة ضد الفقراء، باعتبار الفقر « قدرا شخصيا لا يجب الأخذ به في أي قوانين »، واتّجهت السياسات الرّسمية نحو مُحاربة الفُقراء من خلال إلغاء المُساعدات الإجتماعية وإلغاء إعادة دَمْج العاطلين في الحياة الإقتصادية، باسم « مُحارَبَة الفَقْر »…
ساهم تراجع قطاع الصناعة والصادرات والتغيرات الجيوسياسية في انكماش اقتصاد ألمانيا وتراجُعِهِ بنسبة 0,2% وسَجّلَ قطاع التصنيع عجزًا بنسبة 0,6% سنة 2024 وفق بيانات وكالة الإحصاءات الاتحادية، وكتبت صحيفة « تاغس شبيغل » الصادرة في برلين (27 شباط/فبراير 2025) إن القثطاع الصناعي يُعاني تعثُّرًا غير مسبوق اعتمادًا على إعلان بعض الشركات الألمانية عن خطط لتسريح الموظفين، مثل شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات التي أعلنت (كانون الأول/ديسمبر 2024) إلغاء 25 ألف وظيفة بين 2025 و 2030، وسبق أن أعلنت مجموعة بوش، أكبر مورّد لمعدات السيارات في العالم، عن حذف عشرة آلاف وظيفة في ألمانيا، وأعلنت شركة تيسنكروب إلغاء إحدى عَشَر ألف وظيفة وشركة كونتيننتال عن إلغاء خمسة آلاف وظيفة و « زد إف » إلغاء 14 ألف وظيفة وشركة فورد لصناعة السيارات إلغاء قرابة ثلاثة آلاف وظيفة في فرعها الألْماني، وتتوقع الشركات الألمانية الاستمرار في تقليص عدد الوظائف، وفق مؤشر التوظيف الذي نشره معهد « إيفو » (ميونيخ) يوم الأربعاء 26 شباط/فبراير 2025، وأدّت هذه الإعلانات إلى انخفاض قيمة أسهم جميع شركات السيارات الألمانية، فيما ارتفعت أَسْهُم شركة صناعة الأسلحة راينميتال بنسبة 116% ومصنّع محركات الطائرات « إم.تي أو آيرو » بزيادة قدرها 66%، بسبب ارتفاع الانفاق الحَرْبِي المرتبط بالحرب في أوكرانيا (أرقام يوم الجمعة 28 شباط/فبراير 2025)…
تعود أسباب هذه الأزمة إلى التّحدّيات التي اعترضت اقتصاد ألمانيا، خلال السنوات الأخيرة، وأهمّها، زيادة تكاليف الطاقة بعد انقطاع الطاقة الرخيصة القادمة من روسيا ( بقرار أمريكي)، واهتراء البُنية التّحتية، من جسور وطرقات وسكك حديدية وما إلى ذلك، وعدم مواكبة الصناعة الألمانية للتقنيات الجديدة، وفق موقع « في.دي.إير » الألماني بتاريخ 14 شباط/فبراير 2025 ، وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا سنة 2024، لكن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تُثير مخاوف الشركات الألمانية وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ 27شباط/فبراير 2025)، وقبل الإنتخابات علقت صحيفة « فايننشال تايمز » (21 شباط/فبراير 2025) « تجري الانتخابات الألمانية في جو من القلق الشديد بشأن المخاطر التي تلوح في الأفق على الأمن والديمقراطية الليبرالية والرفاهية الاقتصادية في ألمانيا، خصوصًا في ظل تَحَوُّل الولايات المتحدة من حليف لفترة ثمانية عُقُود إلى خصم يُعَرْقل نُمُوّ وتعافي اقتصاد ألمانيا »، وفي سياق هذه الأزمة، أعلن المصرف المركزي الألماني « بوندسبنك » ( 26 شباط/فبراير 2025) خسارة تاريخية بقيمة 19,2 مليار يورو سنة 2024 وهي خسارة غير مسبوقة منذ سنة 1979، بسبب سياسة سعر الفائدة التي اتبعها المصرف المركزي الأوروبي، ويُتَوَقَّعُ أن تشكل السياسة المالية واحدة من التحديات الرئيسية للتحالف الحكومي الجديد.
الطاهر المعز
-
Algérie solidaire-La mutation sociale et politique du Hirak : le point de vue de Mohamed Bouhamid

Le 22 février 2022 le site Algérie Solidaire publie ce résumé de mon intervention télévisée de Mars 2020. Bien que très résumé, et ne reprenant que trois thèses, cet article est pédagogique et ne déforme rien de ce que j'ai dit. Je pense sa lecture utile en ce mois de mars, anniversaire de cette émission.
La mutation sociale et politique du Hirak : le point de vue de Mohamed Bouhamidi par Algérie solidaire
Algérie solidaire le 22.02.2023.
Le Hirak qui a permis le renversement du régime oligarchique de Bouteflika n’est plus ce qu’il fut à ses débuts quand il était pris en charge par des millions d’Algériens qui n’avaient qu’un seul objectif commun : barrer la route à un cinquième mandat humiliant d’autant plus que le défunt président Bouteflika n’était plus qu’un faire-valoir entre les mains d’un clan politico-financier mafieux qui a tenté de sauver son ^pouvoir et ses privilèges par une alliance avec les chefs de l’ex-DRS et la France néocoloniale. Les forces contre-révolutionnaires qui ont échoué à imposer leur « période transitoire » ont tenté depuis de provoquer le chaos. La pandémie du Covid-19 les a neutralisés pour une période mais ils cherchent par tous les moyens de revenir sur la scène politique. Dès 2020, des intellectuels et des militants algériens avaient lancé une alarme contre le dévoiement du Hirak. Nous reproduisons ici de larges extraits de l’entretien accordé au printemps 2020 à l’APS par l’intellectuel algérien Mohamed Bouhamidi.
Mohamed Bouhamidi commence par soutenir que «le Hirak a muté» du fait que ce mouvement «était fini dès le mois de mai», mais en donnant naissance à «un nouveau fruit, qui est autre chose que lui : l’émergence des couches moyennes dans la vie politique directe». Évoquant le rôle des ONG internationales dans cette seconde vague du Hirak, il a indiqué : «Ces Organisations dont parlent certains médias étrangers et autres ONG internationales, veulent par contre opposer cette légitimité présumée du Hirak afin de perpétuer une non solution politique, maintenir le plus haut niveau possible de tension pour aboutir à une situation de chaos». Il a ainsi insisté sur la nécessité de «dissocier les besoins politiques et culturels de ces manifestants des buts de ceux qui parlent en leur nom». Il a noté toutefois que «ces manifestants ne se laissent pas forcément manipuler», tout en déplorant le fait que «cette situation a mis en crise cet arc de la révolution démocratique».
Des «personnalités», qualifiées de «leaders élus ou spontanés» et qui parlent au nom des manifestants d’aujourd’hui, «ont évalué les manifestants qui occupaient les rues pendant cette période à plusieurs millions de personnes» «Puis pour se dégager de cette impasse du vendredi ces organisations renforcées par des combinaisons avec le youtubeur Zitout ont projeté la solution du samedi, avec l’obstination à jeter l’Algérie dans le cycle de la stratégie USA-OTAN-Israël de créer le chaos sans fin sur toutes les lignes de fractures possibles ethniques, linguistiques, culturelles, religieuses, …etc», a-t-il encore souligné. Il a affirmé, dans ce contexte, que les manifestations hebdomadaires (suspendues par précaution contre la propagation du nouveau coronavirus, Ndlr) «étaient très, très loin de regrouper autant de monde» par rapport à la période allant du mois de février au mois de mai 2019. Des «personnalités», qualifiées de «leaders élus ou spontanés» et qui parlent au nom des manifestants d’aujourd’hui, «ont évalué les manifestants qui occupaient les rues durant cette période à plusieurs millions de personnes», a indiqué Mohamed Bouhamidi, ajoutant que ces «leaders» qui sont «confrontés à leurs propres estimations des mois de février/mars 2019, ne peuvent légitimement parler au nom des foules qui les ont laissés dans leur solitude». Après l’élection présidentielle du 12 décembre 2019, «ces mêmes leaders ont appelé à un style d’autocritique, de réévaluation de leurs actions, pour expliquer pourquoi leur mouvement a échoué», a-t-il relevé, soulignant qu’ils (leaders) «désignaient leur échec à réussir un boycott massivement indiscutable» de la Présidentielle.
«Il y a crise quand les gouvernants ne peuvent plus gouverner comme avant et les gouvernés ne veulent plus être gouvernés comme avant» Affirmant que l’orientation de la mobilisation populaire «a été l’objet d’âpres luttes entre différentes tendances et organisations», Mohamed Bouhamidi date ce qu’il appelle «mutation du Hirak» dès la «confirmation des arrestations de plusieurs dirigeants de l’Etat (Premiers ministres, ministres, généraux, oligarques, hier, seulemen, hyper puissants)» où, selon lui, «la mobilisation populaire a connu une très, très forte décrue». Pour lui «les couches populaires venaient de percevoir clairement ou confusément que venait de se résoudre la moitié de l’équation connue de toute crise politique : + Il y a crise quand les gouvernants ne peuvent plus gouverner comme avant et les gouvernés ne veulent plus être gouvernés comme avant.» «Le mois de mai sera celui de la décantation. Les attaques contre l’Armée nationale populaire ANP sous couvert d’attaque contre le vice- ministre de la Défense, chef d’état-major de l’ANP, le défunt Ahmed Gaïd Salah prouvaient à notre peuple que des divergences profondes existaient en son sein +peuple+ sur le modèle souhaitable de la nouvelle gouvernance», a-t-il souligné. Après les présidentielles, a noté Mohamed Bouhamidi, «la crise politique venait de se résoudre» et «émergeaient alors toutes les autres crises : culturelles, économiques, sociales, linguistiques, voire ethniques, …etc.». «On n’administre pas une société comprenant d’importantes couches moyennes instruites comme une société rurale indiquant et que des organisations» dont il ne cite pas directement le nom, «vont tout mettre à leur crédit ces couches qui continuent à manifester en leur empruntant beaucoup de leurs slogans, mais sans jamais leur servir de troupes ni leur transférer leur énergie».
À cet égard, il a tiré cette conclusion : «le Hirak comme forme concrète de cette mobilisation populaire venait de terminer sa tâche historique», estimant, toutefois, que ce Hirak «portait en lui beaucoup plus que la crise politique» et «venait de mettre sur la scène politique des masses considérables». Il a tenu à rappeler que le développement du système éducatif algérien a, «en quelques décennies, produit des millions de diplômés» et que «le nombre des étudiants a atteint aujourd’hui 1 500 000 étudiants, inclus, selon lui, dans «les couches moyennes de par leur vocation (…)». À ce propos, Mohamed Bouhamidi a indiqué que «ces diplômés trouvaient des formes d’expression et d’affirmation politiques et sociales infiniment plus grandes avant la gouvernance du Président Bouteflika», et que «la fermeture des possibilités de réalisation sociale par la création libre d’associations et d’espaces de discussions et débats a été aggravée par la suprématie dans la vie politique des figures repoussantes et humiliantes pour ces couches moyennes instruites et cultivées d’oligarques frustres et incultes détenant un véritable pouvoir d’État». «Le développement de ces couches moyennes au sein de notre société devait poser problème à un moment ou un autre. On n’administre pas une société comprenant d’importantes couches moyennes instruites comme une société rurale».
Mohamed Bouhamidi, indique que des «organisations» dont il ne cite pas directement le nom, «vont tout mettre à leur crédit ces couches qui continuent à manifester en leur empruntant beaucoup de leurs slogans, mais sans jamais leur servir de troupes ni leur transférer leur énergie. En réalité, elles ne leur empruntent pas leurs slogans, mais les empruntent à l’air du temps, aux représentations et au langage des médias mondialement dominants.» «La voix la plus forte était celle de la libération du pays, du peuple et de la société de la mainmise de la caste oligarchique (3issaba), de ses groupes constitutifs qui défilent aujourd’hui devant les tribunaux et de leurs sponsors étrangers, l’État néocolonial français» «C’est parce qu’elles empruntent ces formulations et ces idées qu’elles n’arrivent pas à élaborer leurs propres programmes politiques»
Pour Bouhamidi : «Parler encore de Hirak, aujourd’hui, est bien un abus de langage envers ces couches moyennes et ces organisations colorées …». Pour lui, «les deux ont besoin de se dire Hirak pour se réclamer en fait du Hirak, c’est-à-dire d’une légitimité populaire qu’ils peuvent opposer à la légalité de l’élection présidentielle. Mais, selon lui, les couches moyennes veulent d’abord garantir leurs droits à une vie politique libre. Elles veulent une démocratie qui est synonyme de vertu dans laquelle le savant est supérieur au marchand». Dans le même ordre d’idées, il a ajouté : que «les couches moyennes, savent d’instinct qu’elles ne sont pas des classes fondamentales. Se présenter comme Hirak, leur permet de parler au nom du peuple de février/mars/avril, c’est-à-dire de défendre les intérêts de la société entière et non ses intérêts égoïstes. Il a estime, ainsi, que «sans cette espèce de ruse ces couches moyennes ne seraient apparues que comme des couches égoïstes, juste avides pour plus d’ascenseur social».
Source :
-
الطاهر المعز-الإشتراكية والمُساواة الفِعْلِيّة وتحرّر النساء

الإشتراكية والمُساواة الفِعْلِيّة وتحرّر النساء : الطاهر المعز
مقدّمة
تدهور وضع الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء عمومًا خلال فترة الرأسمالية النيوليبرالية، وكلما تدهور الوضع ازداد وضع النّساء سُوءًا وارتفع نصيبهن من الإستغلال والإضطهاد والفقر، لأنّهن ضحايا العنف في الفضاء الأُسَرِي وفي الفضاء العام ومواقع العمل، ولأن النساء العاملات في أسفل السّلم، أو في مهن مُرهقة مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال والمُسنّين والتنظيف والفنادق والمطاعم، كما تواجه النساء العاملات صعوبات في الترقية المهنية والوصول إلى المناصب القيادية، فضلا عن تَعرُّضِهِنّ للتّحرّش، خصوصًا في القطاع الخاص، وتُشير البيانات في جميع البلدان إلى ارتفاع نسبة النساء العاملات بدوام جزئي وبعقود هشّة وبرواتب منخفضة، وإلى ارتفاع معدّلات البطالة بين النّساء ومعدلات عملهن في الإقتصاد الموازي، بدون حقوق أو حماية قانونية، فضلا عن العمل المنزلي غير مدفوع الأجر وغير المُعترف به، رغم ضرورته وجَدْواه الإجتماعية، وقدّر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تَعَرُّضَ ما لا يقل عن 30% من نساء العالم إلى العُنف الأُسَرِي الذي يعْسُرُ إثباته مما يرفع نسبة إفلات مُرتكبيه من العقاب…
وَعَتْ فئات قليلة من المجتمع خطورة ما تتعرض له النّساء من ظُلْم وقَهْر، ومن ضمنهم رُوّاد الفكر الإشتراكي الذين أسّسُوا، منذ البداية – قبل كارل ماركس وفريدريك إنغلس – أي الإشتراكيون الطّوباوِيُّون، مثل شارل فورييه وهنري دي سان سيمون وروبرت أوين، تصورهم للمجتمع على المُساواة التّامة بين البشر، على أنقاض المجتمع الطبقي القائم، وتعود فكرة تخصيص يومٍ ( تقرّر أن يكون الثامن من آذار/مارس) للإحتفاء بالنّساء وللدّفاع عن حُقُوقِهِنّ إلى نضالات النّساء العاملات، منذ منتصف القرن التّاسع عشر، وخصوصًا منذ سنة 1908، ونضال العاملات الأمريكيات يوم 29 شباط/فبراير 1909، من أجل تحسين ظروف العمل والرواتب، بدعم من النّساء الإشتراكيات اللاتي نَظّمْن مظاهرات ضخمة واجتماعات في أنحاء الولايات المتحدة، مطالبات بالحقوق السياسية للعاملات، وواجهت السّلطة المتظاهرات بالقمع والطّرد من العمل والإغتيال، فكان ذلك اليوم بمثابة « يوم المرأة » الأول، واقترحت المناضلة والقائدة الشيوعية الألمانية كلارا زيتكين ( 1857 – 1933) على الأُمَمِيّة الشيوعية، سنة 1910 إحياء هذا اليوم من خلال الإضرابات والمظاهرات والإعتصامات ومجموعة من الفعاليات النّضالية، لذا لم يكن الثامن من آذار/مارس يوم بروتوكولات ومهرجانات واحتفالات وإنما يوم نضال من أجل نَيْل أو تعزيز حُقُوق النّساء، نصف المُجتمع، وبعد أثر من قَرْن من إقرار هذا اليوم، حصلت النساء على بعض المكاسب لكن لا تزال النساء تُعانين من المَيْز ومن الإستغلال والإضطهاد الإضافِيّيْن فضلا عن الإستغلال والقمع والإضطهاد الذي تتقاسمه مع الرّجال، ومن مصلحة الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء توحيد النّضالات من أجل تحرّر المجتمع كَكُلّ…
بين المُساواة القانونية والمُساواة الفِعْلِية
ناضلت نساء أوروبا، وبريطانيا بشكل خاص، منذ 1840 من أجل المُساواة، وشاركت نساء أوروبا في موجة ثورات 1848 وشاركت نساء الأحياء الشّعبية في باريس « كومونة باريس » ( آذار/مارس – أيار/مايو 1871) دفاعًا عن أول حكومة للعمال وشاركت نساء إيرلندا، منذ 1860، في نشاط الجمهوريين – السياسي والعسكري – ضد الإستعمار البريطاني، ويبدو إن ماركس وإنغلس كانا يُتابعان هذه النضالات ويتفاعلان معها، وكانا على اتصال مستمر مع النسويات الجذريات في إنغلترا، مما ساعدهما في تطوير أفكارهما وتحليلاتهما، وكتب إنغلس العديد من المقالات – بداية من 1840 – في الصحيفة الإنغليزية « ذا نيو مورال وورلد »، الناطقة باسم النسويات المناهضات للرأسمالية، وأصَر الثُّنائي ماركس وإنغلس على المُشاركة الفعلية للنساء في المنظمات التي ساهما في إنشائها بين سنتَيْ 1840 و 1850،فيما عارض العديد منالإشتراكيين الفرنسيين والنقابيين البريطانيين مُشاركة وعُضْوِيّةَ النساء الإشتراكيات في مؤتمر المنظمة الأممية الأولى ( قاعة سانت مارتن بلندن – 1864)، وكتب كارل ماركس – سنة 1866 -: « إن التغييرات الاجتماعية العظيمة مستحيلة من دون ثورة النساء، ويمكن قياس التقدم أو التّخلّف الاجتماعي من خلال مكانة النساء في المجتمع… » وعبّر عن سروره ب »التقدم الكبير الذي ظهر أثناء انعقاد المؤتمر الأخير لنقابة العمال الأميركية حيث تتم معاملة العاملات بمساواة كاملة مع رفاقهن الرجال… »
تمكّنت الأُممية الإشتراكية الأولى من اجتذاب النساء المناضلات في ذلك الوقت، مثل عاملة الخياطة، الإشتراكية الفرنسية جان ديروان (jeanne deroin 1805 – 1894) التي كان لها دور بارز في ثورة 1848 بباريس، وساهمت في تنظيم صفوف نساء الطبقة العاملة للمطالبة بالحقوق السياسية والاجتماعية وساهمت في إصدار وبيع مجلة صوت النساء في شوارع باريس، وكانت جان ديروان أول امرأة تترشح إلى البرلمان الفرنسي ( نيسان/أبريل 1849 ) وعارضها وسخر منها الاشتراكي الفرنسي بيير جوزيف برودون ( 1809 – 1865 ) وبعد هزيمة ثورة 1848، اعتقلت ديروان ورفيقتها بولين رولان اللّتَيْن كتبتا من السجن، سنة 1851، رسالة إلى مؤتنمر اتفاقية حقوق المرأة الأميركية: « أخواتنا في أميركا! إن أخواتكن الاشتراكيات في فرنسا متحدات معكن في الدفاع عن حق المرأة بالمساواة المدنية والسياسية، ونحن مقتنعات بأنه لا يمكن تحقيق المساواة في الحقوق المدنية والإجتماعية والسياسية سوى من خلال المنظمات القائمة على التضامن، وعلى اتحاد جميع اتجاهات الطبقات العاملة من كل جنس… » ولجأت جان ديروان إلى لندن بعد إطلاق سراحها (آب/أغسطس 1852 ) حيث انضمت إلى المنظمة الأممية الأولى، خلال انعقاد اجتماع المجلس العام ( 3 تشرين الأول/أكتوبر 1865 ) وأسّست، سنة 1866 منظمة نسوية اشتراكية في باريس، ضمت لويز ميشال وبول مينك والكاتبة أندريه ليو، ثم انتخبت لعضوية العصبة الاشتراكية يوم 2 آب/أغسطس 1886، ولعبت إلى جانب نساء الأممية الأولى دوراً أساسياً في التأكيد على المساواة لإنجاح نضالات الطبقة العاملة…
اقترح كارل ماركس، خلال مؤتمر 1871 للأممية الإشتراكية استخلاص الدّروس من تجربة كوميونة باريس، ودعا إلى تشكيل فروع للعاملات لتيسير انضمام ومشاركة النساء في النشاط الإشتراكي، وكتب سنة 1880 مقدمة لبرنامج الحزب الاشتراكي الفرنسي الجديد: « … أن تحرر الطبقة المنتجة هو تحرر كل البشر دون تمييز على أساس جندري أو عرقي »، ثم أكّد مع رفيقه إنغلس » يجب أن تَجِدَ النساء الأكثر نضالية مكاناً سياسياً لهن في الأممية الأولى والأحزاب الاشتراكية الأخرى، خصوصًا بعد مُعاينة قيمة النضال النسائي داخل الانتفاضة العظيمة لكوميونة باريس »…
بعد انهيار الأممية الأولى، حلت مكانها الأممية الثانية سنة 1889، وتمكّن الماركسيون من فَرْض تحقيق المساواة للنساء، وأقر المؤتمر التأسيسي للأممية الثانية، المنعقد في باريس: “… من واجب العمال قبول ومعاملة العاملات على قدم المساواة في صفوفهم وعلى أساس العمل المتساوي والأجر المتساوي للعمال والعاملات بدون تمييز »، ونظّم القسم النسائي في الأممية الثانية، ومقره بألمانيا، بداية من 1891، مؤتمراته الخاصة، ونظم حملات التصويت وأقام الاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكانت كلارا زيتكين ( 1857- 1933)، زعيمة القسم النسائي في الأممية، وحررت جريدة المساواة، التي استهدفت العاملات ووصل عدد النسخ الموزعة منها إلى 70 ألف نسخة بحلول العام 1906، ونشطت النساء الإشتراكيات بكثافة ضد الحرب العالمية الأولى، ضمن الحملات الثورية التي أفضت إلى الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917 وإلى الثورة الألمانية ( 1910 ) التي تم إغراق مناضليها في دمائهم…
نشر فريدريك إنغلس كتاب أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة سنة 1884، بعد وفاة كارل ماركس ( 1883) وطَوّر مفهوم العائلة وبيّن إن اضطهاد النساء ناتج عن تنظيم المجتمعات لإنتاج الحياة وإعادة إنتاجها، وإن أن اضطهاد النساء هو نتاج المجتمع، وليس نتاج الطبيعة، وصدر الكتاب في ثلاث طبعات ألمانية وتُرْجِمَ إلى 6 لغات أوروبية، ودافعت عنه إليانور ابنة ماركس وإدوارد أفيلينغ كتيباً، مما زاد من شعبية الكتاب رغم ضخامته، واستمر اهتمام إنغلس بموضوع المساواة بين النساء والرجال كشرط أساسي لإنجاز الإشتراكية وناقش هذه المواضيع في مراسلاته مع نساء اشتراكيات من ألمانيا ( مينا كاوتسكي، والدة كارل كاوتسكي) وروسيا وبريطانيا ( مارغريت هاركينس ) والولايات المتحدة (فلورانس كيلي ) وغيرهن…
مكانة المرأة في الإشتراكية – بين النّظرية والتّطبيق
لم يُفرد كارل ماركس في كتاب « رأس المال » حيّزًا خاصًّا للعمل المجاني للنساء كشكل من استغلال واضطهاد النّساء، لكن كانت قضية تحرّر النساء حاضرة ، قبل كتابة « رأس المال »، في النّقاشات التّمهيدية لمؤتمر الإشتراكية الدّولية سنة 1863 التي كان كُتَيّب البيان الشّيوعي من أهم أدوات هذا النقاش التمهيدي، واعتبر ماركس وإنغلز آنذاك إن اضطهاد النّساء من قبل الطبقة الحاكمة، يجعلهن مواطنات من درجة ثانية حتى داخل الأُسْرة: “لا يرى البورجوازي زوجته إلا مجرد أداة إنتاج … ولا يساوره أي ظن أن الهدف الحقيقي المقصود (من قِبَل الشيوعيين) هو إلغاء وضع النساء كمجرد أدوات إنتاج“، وأبْدَى فريدريك إنغلس اهتمامًا كبيرًا لاضطهاد المرأة واستغلالها وعدم المُساواة بين المرأة والرّجل، في كتاب « أصل العائلة والمِلْكِيّة الخاصّة والدّولة » ( 1884) بعد وفاة كارل ماركس، وتمثّلت جرأة إنغلس في نقده اللاذع لتصرفات أقرانه من الرّجال: » أخذ الزوج دفة القيادة في البيت أيضاً وحرمت الزوجة من مركزها المشرف، وتحوّلت إلى عبدة للرغبات الجنسية لزوجها ومجرد أداة لإنتاج الأطفال … وبينما تتم إدانة خيانة المرأة، يتم تخفيف حدّتها أو تمجيدها عند الرجل… »، واعتَبَرَ رُوّاد الفكر الإشتراكي إن قضية تحرير المرأة ليست شأنًا خاصًّا بالنساء بل شأن كافة أفراد المجتمع، وتجدر الإشارة إلى نَشْر كتاب فريدريك إنغلس ( أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة )، في إنغلترا في حقبة العَهْد الفِكْتُوري.
بعد انتصار الثورة البلشفية في روسيا، تغيّرت التشريعات لِتُقِرَّ بين سنتَيْ 1917 و 1920، حق التصويت والترشح، وإنهاء سلطة رب الأسرة، وإقرار الزواج المدني، وتبسيط الطلاق، والمساواة في الحقوق بين الأطفال المولودين في إطار الزواج أو خارجه، وحظر عمل المرأة ليلا، والأجر المتساوي، وإجازة الأمومة لمدة 16 أسبوعا للعاملات و 12 أسبوعا للموظفات، والإجهاض المجاني، وتجازوز ما كانت تُطالب به النسويات اللاّتي يناضلن في الدّول الرأسمالية التي تدّعي الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة…
بدأت التّغييرات التي حقّقتها ثورة 1917 بإجراءات تشريعية، بإشراف مجلس مفوضي الشعب وأول حكومة في العالم تَضُمُّ امرأة ( ألكسندرا كولونتاي)، فتم إقرار الإجراءات التي ذُكِرت في فقرة سابقة، غير إن لينين أعلن أواخر سنة 1918 « إن القوانين ليست كافية، وهناك مسافة بين المساواة القانونية والمساواة الحقيقية في الحياة اليومية… » ، وأضاف سنة 1919 : » إن القوانين لم تُحَرّر المرأة من عُبُودية العمل المنزلي والمطبخ ورعاية الأطفال… »، وبدأ النّظام البلشفي الفقير والمُحاصَر من قِبَل جُيُوش الدّول الرأسمالية، في تغيير نمط الحياة – وبالأخص حياة النّساء العاملات – عبر إنشاء مجمعات مساكن تضُمُّ هياكل جماعية من مطابخ ومقاصف ومغاسل ودور حضانة ورياض أطفال ودور لاستقبال الأمهات قبل الولادة وبعدها، وتوفير الظُّرُوف التي تُمكّن من تَوْسيع مُشاركة النّساء في العمل السياسي والثقافي والتّرفيهي…
دُروس الثورة البلشفية
خصّصت الحكومة الثورية الروسية موارد هامّة لإنشاء مطاعم جماعية ودور حضانة ومغاسل لتحرير النساء من العائلة وتمكينها من لعب دور كامل في الحياة العامة، وفق الثورية الروسية إينيسا أرماند التي كتبت سنة 1919: « كل مصالح العاملات، وكل شروط تحررهن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانتصار البروليتاريا، لا يمكن تصورها من دونها، ولكن هذا النصر لا يمكن تخيله من دون مشاركتهن ومن دون نضالهن »، كما خصصت الثورة موارد كبيرة للتوعية وتثقيف النساء من العمال والفلاحين، من خلال القسم النسائي.
أدْرَك قادة الثورة الروسية سنة 1917 الدور المركزي للأسرة بوصفها جذر اضطهاد المرأة، والصعوبات التي ينطوي عليها تحقيق المساواة بين الجنسين داخل الأسرة كشرط مسبق لتحرير المرأة في المجتمع ككل، وتم إدماج النضال ضد الاضطهاد كجزء لا يتجزأ من النضال من أجل الاشتراكية، وفق لينين الذي أعلن: يتطلب الوعي الثوري أن يكون العمال على استعداد للدفاع عن مصالح كل المضطهدين في المجتمع، كجزء من النضال من أجل الاشتراكية (…) فلا يمكن أن يكون وعي الطبقة العاملة وعيًا سياسيًّا حقيقيًّا دون تأهيل العمال لإدراك جميع قضايا الاستبداد والقهر والعنف والاعتداء، ومعالجة هذه القضايا من وجهة نظر الإشتراكية الديمقراطية حَصْريًّا »
استنتج لينين، من خلال المناقشات العديدة ومن خلال المشاكل التي اعترضت الثورة سنة 1917، إن الدفاع عن حقوق جميع المضطهدين وضد كافة أشكال القمع والإضطهاد، ضروري لمقاومة الظُّلْم المبني على أساس الجنس أو اللّون أو غير ذلك، وهو ضروري كذلك لإعداد الطبقة العاملة لإدارة المجتمع لمصلحة المُجتمع ككل ولمصلحة الإنسانية، كبديل للنظام الرّأسمالي المبني على استغلال واضطهاد الأكثرية لصالح الأقَلِّيّة، كما استنتجت قيادة الحزب البلشفي إن الثورةً الإشتراكية لا تحرر المرأة تلقائياً، بل يتم تحرير المرأة كما الرّجل، ضمن مسار ثوري يتضمن مكافحة الإستغلال والإضطهاد، ومُقاوَمةَ رواسب الثقافة الرّجعية داخل الطبقة العاملة وداخل الحزب والمُجتمع والأُسْرة…
تمكّنت الثورة البلشفية من إنجاز خطوات على طريق تحرر النساء العاملات والقرويات، رغم الصعوبات المرتبطة بالتخلف والأُمِّيّة والتّقاليد، والحصار الذي فرضته القوى الرأسمالية والتخريب الدّاخلي، وكانت تلك الخطوات إحدى مظاهر عُمْق الثورة الإجتماعية التي تجذّرت اثناء الحرب العالمية الثانية لما ذهب الرجال إلى الجبهة لمقاومة الإحتلال الألماني، وتولّت النساء عملية الإنتاج في المصانع وفي المزارع فضلا عن رعاية الأطفال والمُسنّين…
أنشأت اللجنة المركزية للحزب البلشفي، سنة 1918، قسمًا نسائيا للعاملات والفلاحات بإشراف بعض النّساء القياديات البلشفيات، مثل أنيسا أرماند (Inessa Fyodorovna Armand 1874 – 1920 أول رئيسة لإدارة شؤون المرأة ورئيسة أول مؤتمر عالمي للنساء الشيوعيات) وألكسندرا كولونتاي ( 1872 – 1952 ) وشاركت نحو 1100 امرأة منتخبة من قِبَل النّساء في « مؤتمر عموم روسيا للعاملات والفلاحات » وأشْرَفت مندوبات المؤتمر على حملات الدعاية لمكافحة إدمان الكحول والعنف المنزلي، ومن أجل الوقاية من الأمراض والأوبِئة وأشرف القسم النّسائي بالحزب البلشفي على إصدار صحيفة « العاملة الشيوعية » التي قامت بدور التثقيف السياسي، وعلى دورات مَحْو الأُمِّيّة وتدريب النّساء على إدارة المؤسسات الجماعية (رياض الأطفال، ودور الحضانة والمقاصف)، وتم تدريب وتأهيل حوالي عشرة ملايين امرأة بين سنتَيْ 1919 و 1930، وفق تقديرات ناديجدا كروبسكايا ( 1869 – 1939) زوجة لينين…
تنوعت المشاكل والعراقيل، بفعل اتساع روسيا ثم الإتحاد السوفييتي، مما يستدعي تنوُّع الحُلُول، حيث بقي تأثير الدّين ( أو تأويل الدّين) وتأثير الفكر الإقطاعي والرّجعي مُهيمنًا، خصوصًا في جمهوريات الشرق السوفيتية، وحاربت القوى الرّجعية المحلية القوانين التي منعت تعدد الزوجات والمهر، وفي أوزبكستان قتلت الأُسَر أكثر من 200 امرأة سنة 1928، بسبب محاولتهن التّحرّر وممارسة حقوقهن وحضور اجتماع اللجنة الحزبية للنساء العاملات أو موتمر المرأة الشيوعية الشّرقية، واضطرت الدّولة إلى اتخاذ إجراءات زَجْرِية ضدّ « حُرّاس التّقاليد » الذين يمنعون النساء الريفيات من الدّراسة ومن اقتناء وسائل منع الحمل، ومن العمل خارج البيت والمزرعة العائلية، ناهيك عن المشاركة في النشاط النقابي والإجتماعي والسياسي والثقافي…السّياق التّاريخي:
تندرج أَهَمِّيّة الإجراءات التي أَقَرّتها السّلطات السوفييتية منذ السّنوات الأولى التي تَلَت الثورة ضمن مناخ سياسي واجتماعي مَحلِّي ودولي جعل نجاح الثورة الإشتراكية في في بلد غير مُتطور صناعيا أمْرًا مُفاجئًا للرأسمالية وللثّوريين في العالم، إذ كانت الأمية سائدة وخصوصًا في الأرياف وبين النّساء، ولم تتطور مشاركة المرأة في العمل المأجور سوى أثناء الحرب العالمية الأولى حيث ذهب الرجال القادرون على العمل إلى الحرب، واقتحمت النّساء المتعلّمات مجال العمل الاجتماعي والنقل وخدمات الدولة، ولاقت السّلطات الثورية صعوبات واجهت بناء الإشتراكية في الإمبراطورية القَيْصَرِيّة التي تفتقر مناطق واسعة منها إلى التّيّار الكهربائي ( من ذلك إطلاق لينين برنامج تعميم الكهرباء كأوْلَوِيّة وكضرورة لبناء الإشتراكية) وكانت نسبة العمل المأجور منخفضة جدًّا سنة 1917، مُقارنة بألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، فقد كانت نسبة العمل المأجور بين السكان العاملين لا تتجاوز حوالي 20% من الرجال والنساء، ولا تتجاوز مشاركة المرأة في القوى العاملة 31%، ومع ذلك حققت السّلطات المنبثقة عن الثورة نتائج مُذهلة خلال سنوات قليلة، بخصوص تشريعات العمل والحقوق الاجتماعية والسياسية ومكانة النّساء وارتفاع مشاركتهن في القوى العاملة من 31% في نهاية سنة 1917 إلى 50% سنة 1925، وعلى سبيل المقارنة فإن هذه النّسبة لمشاركة نساء بلدان الإتحاد الأوروبي في القوى العاملة تبلغ 63,5% سنة 2022، وفق بيانات الإتحاد الأوروبي، ورغم ارتفاع مؤهّلات النساء، لا يزال مُتوسط رواتب النساء يقل عن نظرائهن من الرجال بنسبة تتراوح بين 16% و 25% في مختلف البلدان الأعضاء بالإتحاد الأوروبي ( مُؤشّر المرأة في العمل 2017 )
خاتمة:
إن دراسة التجارب التاريخية ( السّلبية والإيجابية) ضرورية لاستخلاص الدّروس، ولا يمكن نقل تجربة بلد أو منطقة إلى بلد آخر، دون دراسة خصوصيات كل مجتمع ودرجة تطور قُوى الإنتاج وما إلى ذلك، ولئن كانت مسألة عدم المُساواة بين المرأة والرجل، وبين سكان الأرياف وسكان المدن، وبين مختلف المناطق والأقاليم لا تزال قائمة فإن خُصُوصية نضال النّساء تظَلّ مرتبطة بضرورة اكتساب الوعي بين الرجال والنساء لمكافحة عدم المُساواة والنضال من أجل حُقوق النساء الفقيرات والنساء العاملات في المصنع أو في المزرعة وحق المرأة في اختيار شريك حياتها وحقها في التعليم والعمل والترفيه وتقاسم مهام الأُسرة بين الرّجل والمرأة، ويندرج هذا النضال ضمن مكافحة عدم المساواة بشكل عام، وضمن النضال من أجل تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وللشعوب في ظل هيمنة الإمبريالية والمؤسسات المالية الدّولية على مقدرات بلدان « الأطراف » وفَرْض خفض الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والنقل العمومي والسّكن والمرافق والخدمات الضّرُورية لرفاهة الإنسان.
إن النضال من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية السائدة، ومن ضمنها العلاقات بين الجنسين، ومن أجل تعزيز مُشاركة المرأة في اتخاذ القرار والتخطيط والتنفيذ والتّقْيِيم، هو نضال حضاري، مَشْرُوع وضروري من أجل العدالة ومن أجل مجتمع بديل يتميز بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج المادّي والثقافي وتعميم الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعُلوم والمعرفة والثقافة…
الطاهر المعز
-
Vijay Prashad -La mainmise de Washington sur le FMI


Antonio Souza, Brésil, Cadê minha praia ? O mar levou ou Où est ma plage ? La mer l’a emportée, 2019. Le texte dans le tableau se lit, de haut en bas et de gauche à droite, «amour», «paix», «nous» et «la mer», «sauver» et «planète».
Les États-Unis, au sein de cette institution profondément antidémocratique, disposent d’un droit de veto sur tout changement majeur et façonnent les politiques selon leur bon vouloir.
Aux yeux du Fonds monétaire international (FMI), une personne vivant dans les pays du Nord vaut 9 personnes vivant dans les pays du Sud.
Ce calcul est tiré des données du FMI sur le pouvoir électoral au sein de l’organisation par rapport à la population des pays du Nord et du Sud.
Chaque pays, en fonction de sa «position économique respective», comme le suggère le FMI, se voit attribuer des droits de vote pour élire des délégués au conseil d’administration du FMI, qui prendra toutes les décisions essentielles de l’organisation.
Un rapide coup d’œil au conseil d’administration montre que le Nord est largement surreprésenté dans cette institution multilatérale cruciale pour les pays endettés.
Les États-Unis, par exemple, détiennent 16,49% des voix au conseil d’administration du FMI alors qu’ils ne représentent que 4,22% de la population mondiale. Puisque les statuts du FMI exigent 85% des voix pour apporter la moindre modification, les États-Unis ont un droit de veto sur les décisions du FMI.
Par conséquent, la direction du FMI s’en remet à la politique décidée par le gouvernement américain et, l’organisation étant basée à Washington, D.C., consulte fréquemment le ministère américain des Finances sur son programme politique et ses décisions individuelles.
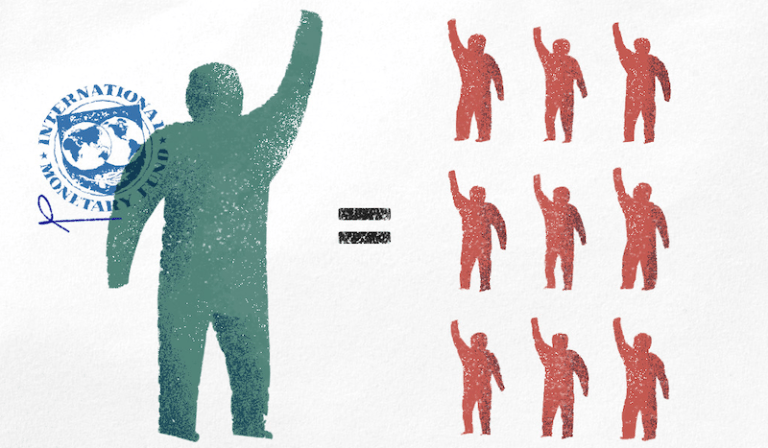
Par exemple, en 2019, lorsque le gouvernement des États-Unis a décidé de cesser unilatéralement de reconnaître le gouvernement du Venezuela, il a fait pression sur le FMI pour qu’il fasse de même.
Le Venezuela, l’un des membres fondateurs du FMI, s’était tourné vers le FMI à plusieurs reprises pour obtenir de l’aide, avait remboursé les prêts en cours au FMI en 2007, puis décidé de ne plus faire appel au FMI pour obtenir une aide à court terme (en effet, le gouvernement vénézuélien s’est plutôt engagé à créer la Banque du Sud afin d’accorder des prêts-relais aux pays endettés en cas de déficit de la balance des paiements).
Pendant la pandémie, cependant, le Venezuela, comme la plupart des pays, a cherché à puiser dans ses réserves de 5 milliards de dollars en «droits spéciaux» (la «monnaie» du FMI) auxquels il était autorisé à accéder dans le cadre de l’initiative mondiale de relance des liquidités du Fonds.
Mais le FMI, sous la pression américaine, a décidé de ne pas transférer l’argent. Ce refus a fait suite à un rejet antérieur de la demande du Venezuela d’accéder à 400 millions de dollars de ses crédits spéciaux.
Bien que les États-Unis aient déclaré que le véritable président du Venezuela était Juan Guaidó, le FMI a continué de reconnaître sur son site web que le représentant du Venezuela auprès du FMI était Simón Alejandro Zerpa Delgado, alors ministre des Finances du gouvernement du président Nicolás Maduro.
Le porte-parole du FMI, Raphael Anspach, n’a pas répondu à un courriel envoyé par Tricontinental en mars 2020 au sujet du rejet d’attribution des fonds, bien qu’il ait publié une déclaration officielle selon laquelle «l’engagement du FMI avec les pays membres est fondé sur la reconnaissance officielle du gouvernement par la communauté internationale».
Selon Anspach, comme on ne peut pas être certain de cette reconnaissance, le FMI n’a pas autorisé le Venezuela à accéder à son propre quota de créances spéciales pendant la pandémie. Puis, brusquement, le FMI a supprimé le nom de Zerpa de son site web. Et ce, uniquement sous la pression des Etats-Unis.

En 2023, lors du lancement de la Nouvelle Banque de Développement (Banque des BRICS) à Shanghai, en Chine, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a souligné la politique d’«asphyxie» du FMI à l’égard des pays les plus pauvres. Évoquant le cas de l’Argentine, Lula a déclaré :
«Aucun gouvernement ne peut travailler avec un couteau sur la gorge sous prétexte qu’il est endetté. Les banques doivent être patientes et, si nécessaire, renouveler les accords. Lorsque le FMI ou toute autre banque prête à un pays du tiers monde, on a le sentiment que ces institutions s’octroient le droit de donner des ordres et de gérer les finances du pays, comme si ces derniers étaient les otages de ceux qui prêtent de l’argent».
Tous les discours sur la démocratie s’évanouissent face à la véritable réalité du pouvoir dans le monde : le contrôle du capital.
L’année dernière, Oxfam a montré que «1% des plus riches possèdent plus de richesses que 95% de l’humanité», et que «plus d’un tiers des 50 plus grandes entreprises du monde, d’une valeur de 13 300 milliards de dollars, sont désormais dirigées par un milliardaire ou ont un milliardaire comme actionnaire principal». Plus d’une douzaine de ces milliardaires font désormais partie du cabinet du président américain Donald Trump. Ils ne représentent plus le 1%, mais en fait le 0,0001%, soit 10 000e de 1%. À ce rythme, le monde verra l’émergence de cinq milliardaires d’ici la fin de cette décennie. Ce sont eux qui dominent les gouvernements et qui, par conséquent, ont un énorme impact sur les organisations multilatérales.
En 1963, le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Jaja Anucha Ndubuisi Wachuku, a exprimé sa frustration à l’égard des Nations unies et d’autres organisations multilatérales. Les États africains, a-t-il déclaré, «ne sont pas en droit d’exprimer leur point de vue sur une question particulière au sein des organes importants des Nations unies». Aucun pays africain, ni aucun pays d’Amérique latine, ne dispose d’un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Au FMI et à la Banque mondiale, aucun pays africain ne peut imposer son programme. Wachuku a demandé aux Nations unies : «Allons-nous continuer à être des sous-fifres ?» Bien que le FMI ait prévu un siège supplémentaire pour l’Afrique en 2024, c’est loin d’être suffisant pour le continent, qui compte plus de membres du FMI (54 pays sur 190) et plus de programmes de prêt actifs que tout autre continent (46,8% de 2000 à 2023), mais le deuxième plus faible ratio de vote (6,5%) après l’Océanie. L’Amérique du Nord, avec deux membres, dispose de 943 085 voix, tandis que l’Afrique, avec 54 membres, en compte 326 033.

Alioune Diagne, Sénégal, Rescapé ou Survivor, 2023.
Au lendemain de la crise financière de 2007 et au début de la troisième grande dépression, le FMI a décidé d’entamer un processus de réforme.
Cette réforme a été motivée par un constat : lorsqu’un pays fait appel au FMI pour obtenir un prêt-relais, ce qui ne devrait pas avoir d’incidence, il finit par être pénalisé sur les marchés des capitaux, car solliciter un prêt est considéré comme un signe de mauvaise performance. L’argent est alors prêté au pays à des taux plus élevés, aggravant ainsi la crise à l’origine de la demande du prêt. Au-delà de cette question se cache un problème plus profond : l’ensemble des directeurs généraux du FMI sont européens, ce qui signifie que les pays du Sud n’ont aucune représentation aux plus hauts échelons de la direction du FMI.
L’ensemble de la structure de vote du FMI s’est altérée avec l’augmentation des votes par quota (basés sur la taille de l’économie et la contribution financière au FMI) tandis que les «votes de base» plus démocratiques (un pays, une voix) ont perdu de leur impact.
Ces différents votes sont évalués de 2 manières : les parts de quotas calculées (CQS), qui sont fixées par une formule, et les parts de quotas réelles (AQS), fixées par des négociations politiques. Selon un calcul effectué en 2024, par exemple, la Chine a un AQS de 6,39%, tandis que son CQS est de 13,72%. Pour augmenter l’AQS de la Chine afin qu’il corresponde à son CQS, il faudrait réduire celui d’autres pays, comme les États-Unis. Les États-Unis ont un quota de voix AQS de 17,40%, qui devrait être réduit à 14,94% pour tenir compte de cette augmentation en faveur de la Chine. Cette diminution de la part des États-Unis éroderait donc leur pouvoir de veto.C’est pour cette raison que les États-Unis ont saboté le programme de réforme du FMI en 2014. En 2023, le programme de réforme du FMI a de nouveau échoué. Foto
Paulo Nogueira Batista Jr. a été directeur exécutif pour le Brésil et plusieurs autres pays au FMI de 2007 à 2015, vice-président de la Nouvelle Banque de développement de 2015 à 2017, et collabore à l’édition internationale de la principale revue chinoise Wenhua Zongheng.
Dans un grand article intitulé «Une solution pour réformer le FMI» (juin 2024), Batista propose un programme de réforme en 7 points pour le FMI :
- Rendre les conditions d’octroi des prêts moins strictes.
- Réduire les taxes sur les prêts à long terme.
- Renforcer les prêts concessionnels pour éradiquer la pauvreté.
- Augmenter les ressources globales du FMI.
- Augmenter le pouvoir des votes de base pour donner plus de représentation aux nations les plus pauvres.
- Donner au continent africain un 3° siège au conseil d’administration.
- Créer un 5° poste de directeur général adjoint, qui sera occupé par un pays plus pauvre.

Ben Enwonwu, Nigeria, The Dancer, 1962.
Si le Nord ignore ces réformes fondamentales et pertinentes, Batista affirme que «les pays développés seront alors à eux seuls les maîtres d’une institution fantôme». Il prédit que le Sud quittera le FMI et créera de nouvelles institutions sous l’égide de nouvelles plateformes telles que les BRICS.
En fait, de telles institutions sont déjà en cours d’élaboration, comme l’Accord de réserve de crédit (ARC) des BRICS, mis en place en 2014 après la tentative infructueuse de réforme du FMI. Mais l’ARC «est toujours quasiment au point mort», écrit Batista.
Jusqu’à ce qu’il se débloque, le FMI est la seule institution fournissant le type de financement nécessaire aux nations les plus pauvres. Voilà pourquoi même les gouvernements progressistes, comme celui du Sri Lanka, où les paiements d’intérêts représenteront 41% des dépenses totales en 2025, sont obligés de s’adresser à Washington. Et, la main tendue, ils adresseront un sourire à la Maison Blanche en se rendant au siège du FMI.
source : Tricontinental
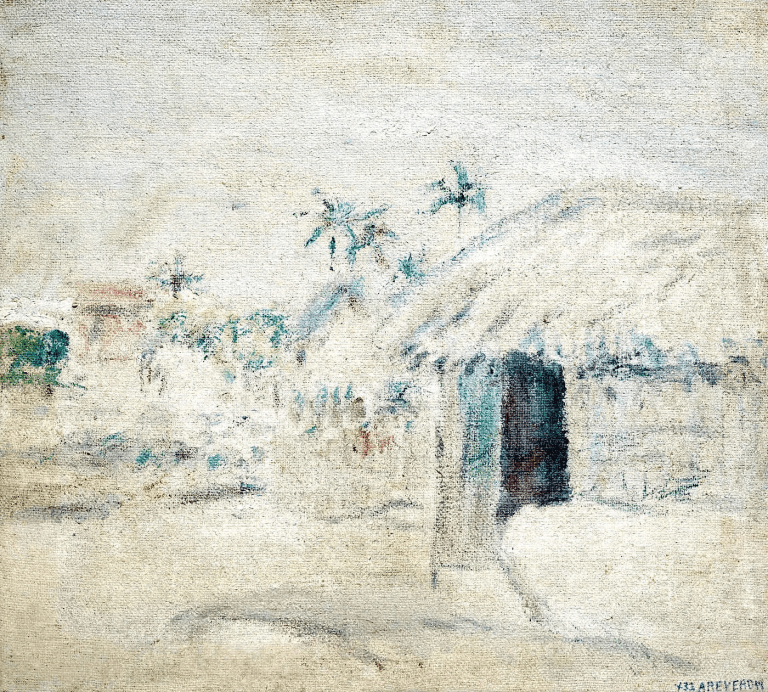
Armando Reverón, Venezuela, Ranchos, 1933.
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Keiko, Londres
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Sarah, New York
« Commencer mon rôle en tant qu’administrateur WordPress a été un plaisir, grâce à son interface intuitive, sa gestion des médias, sa sécurité et son intégration des extensions, rendant la création de sites Web un jeu d’enfant. »
– Olivia, Paris